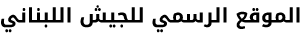- En
- Fr
- عربي
وجهة نظر
الخطر التغييري المتسرّب من الاصطفافات
دهريّة هي. صلبة. هزئت من الأعاصير العاتية. عانقت أغصانها السماء، وفلشت سلامها على الأرض. شمخت نحو العلاء حتى غوت كواسر النسور، وقبل أن يدركها التعب اتكأت على وسادة الدهر تسرد حكايا المجد والعنفوان.
سنديانة البيادر
إنها «سنديانة البيادر»، عمرها من عمر «دولة لبنان الكبير». كانت ملتقى الفلاحين، وملفى الحصّادين الذين حوّلوا المكان إلى بيادر تحتضن أكوام السنابل في حزيران، قبل أن يأتي «النورج» ليلامس وجناتها بحدب ورفق، فتنساب عذارى الحنطة من مخابئها عاريات خجولات، لتتحوّل في ما بعد لقمة شهيّة فوق المآدب العامرة.
تبعد البيادر عن تلك البلدة الشمالية الجبليّة الصغيرة مسافة قصيرة، وكانت السنديانة على موعد دائم مع الصبية، يقصدونها ليمارسوا «شيطناتهم» في تلك المحلّة، بعيدًا من عيون الأهل، وقضبان الرمان. دار الزمن دورته، وشاخت القرية، وكبر الصغار، وتحوّلت حقول القمح إلى أديم قاحل، لا سنابل تتغاوى، ولا ثمار أو خضار، بل جدب مقحط، ووعر سائب.
قبل سنوات، فوجىء من بقي من أهالي القرية بـ«أم مهى» تفترش الأرض مع أولادها الخمسة، وتلتحف السماء، وتستظلّ أغصان السنديانة، وتتخذ من قرب جذعها الضخم مأوى، وحضنًا آمنًا!.
هربت «أم مهى» مع عائلتها من الجحيم السوري، ولجأت إلى منطقة البيادر، لتنعم تحت السنديانة بطيب إقامة، وهنأة سلامة. انصرف الرجل إلى القيام بما يطلب منه من أعمال داخل القرية، مقابل أجر مناسب، فيما انصرفت «أم مهى» إلى الخدمة في المنازل.
مرّت السنوات بسرعة، وكبرت مهى، وتفتحت براعم الحب، ورمى الغرام شباكه، وتمّ النصيب، وتزوجت الصبيّة الحلوة السمراء من فارس أحلامها، وكان عرس قروي تميّز بالنخوة، والعفوية، والأصالة، وكانت فاتحة المصاهرة خيرًا على العائلة التي انتقلت من تحت السنديانة إلى القرية لتصبح جزءًا من نسيجها الإجتماعي.
ليست الرواية مقتبسة، إنها مسلوخة من الواقع المعيوش، الضاغط بشؤونه وشجونه، المكبّل بهواجس مصيريّة تأخذ الوطن وأهله في أرجوحة القلق المتمايلة مع تمايل التطورات العاصفة في المنطقة، والتي لا تنبىء بانفراج وشيك.
نورج البيادر استقر في الكهف العتيق، وخاط العنكبوت حوله قميصًا حريريًّا، فيما هجر الشباب والصبايا منازل القرميد الضجرانة، إلى المدينة، أو المنفى البعيد، واستوطنت «أم مهى»، القرية، ولسان حالها يقول: «يا دار لغيري ما حدا... ومهري سرجتو بوجه العدا؟!»، وقد أصبحت خبيرة محلّفة بتنظيم المآتم، وحصر الإرث!.
التحديات الخمس
«أم مهى» عنوان لقضيّة وجوديّة تشغل لبنان الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. ست سنوات مرّت، والنزوح يتفاقم، يتعاظم، يبني مجتمعه، ويؤسس لحياة مختلفة، في مجتمع متنوّع، واقتصاد حر، معتمدًا على مناخ من الحريّة، تحاكي الفوضى، وهذا ما دفع بأهل الاختصاص في علم الاجتماع إلى دراسة هذه الظاهرة، بكثير من الدقّة، والتأني، بعد أن اجتاز مجتمع النزوح، عتبة الوضع الإنساني الخاص، نحو ديمومة طويلة الأمد تبني مداميكها على أسس اقتصاديّة – اجتماعيّة توفّرها الإمكانات اللبنانيّة المتواضعة.
ويدور الحديث هنا حول تحديات عربشت على جدار الوطن كالعلّيق البرّي، لتمعن في تغيير معالمه، وطمس خصوصياته، وتشويه حقائقه، وتبديل منظره، ولم تعد المسألة مجرد نزهة لعابر سبيل، بقدر ما هي إقامة من دون أفق!
بيت بمنازل كثيرة
يبرز التحدّي الأول في انقسام أهل البيت حول المجتمع الوافد، وسبل المعالجة، وطريقة التعاطي، أو ما بات يعرف بالأسلوب المستند إلى معايير سياسيّة، وطائفيّة، وفئويّة تفسد الرؤية الصحيحة نحو مصلحة الوطن، وخيرالمواطن.
كان الانقسام في الرأي فاقعًا حول الواقع الذي استجدّ منذ سنوات في الجوار السوري، فريق يؤيد خيارات هذا الطرف ويدعمها، وآخر يدعم خيارات الطرف الآخر، وهذا ما أسهم في فتح الأبواب وسيعة أمام المناوشات الطائفيّة، والاشتباكات الحدوديّة، والاغتيالات، وعمليات الخطف، وتدفق النازحين بأعداد كبيرة. صحيح أن الدولة صمدت، لكنها عند حافة الانهيار، وهي تواجه مخاطر لا حصر لها، وتحاول معالجتها، أو التقليل من تداعياتها عن طريق سياسات ترقيعيّة، توازن بين الحرص على المصالح الخاصة، ومنع الانزلاق نحو مهاوٍ سحيقة. والتجربة المريرة التي تخاض، ليست وليدة الأمس القريب، وربما تعود جذورها إلى مسار التاريخ والجغرافيا، وخرائط سايكس – بيكو، وتقسيماته التي استندت يومها إلى غاية وحيدة عنوانها: «حفظ مصالح الدول المنتدبة، وكيفيّة الحرص عليها مستقبلًا».
حاولت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التخفيف من التداعيات، فتبنّت موقفًا رسميًّا يقوم على سياسة النأي بالنفس عن الجوار الساخن، الأمر الذي مكّن الدولة من الوقوف في موقف وسطي، لكن المستجدات سرعان ما أثبتت بأن الموقف الرسمي في وادٍ، ومواقف الفعاليات في واد آخر.
وكما الحدود متداخلة بين لبنان وسوريا، كذلك العلاقات، ويبقى لبنان، من بين جميع الدول المجاورة للكيان السوري، الأكثر عرضة إلى للتداعيات الناجمة عن الصراع الطويل. فالدولة تقوم بما لها وعليها من ضمن الإمكانات المتوافرة، وهي محدودة، والعلاقات بين المكونات السياسيّة مشحونة، تتوافق أو تتنافر في حدود ما تسمح به لعبة المصالح الخاصة. والاصطفافات قائمة، ومعروفة بعناوينهــا، وتفاصيلهــا، وغاياتهــا، وأبعادها إن في الداخل، أو حيال الجوار المضطرب، وقد صاحبت الاصطفافات المحليّة فترات من التوتر، أو الشلل السياسي، واندلعت مواجهات محدودة، ولفترات قصيرة، ووقعت عمليات اغتيال.
وإذا كانت تقسيمات سايكس – بيكو قد أسست لتداخلات في العلاقات، فإنّ العام 1976 وما تلاه من تطورات، وأحداث جسام، قد فتح الباب وسيعًا أمام رسم تحالفات مؤيدة وأخرى معارضة تخطت الحدود السياسيّة والجغرافيّة اللبنانية، لتصل إلى صحن الدار السوري. يكفي التذكير بما جرى في 14 شباط من العام 2005، وما تلاه من انتفاضات متقابلة، ومن غليان في الشارع، وكانت النتيجة انسحاب القوات السوريّة في 26 نيسان من ذلك العام (2005)، مع الإبقاء على الاصطفافات العميقة، والمقوّضة للعافية اللبنانية.
تقرير.. وتحديات
يطول السرد، ويتعمّق حول الانقسامات، إلاّ أن التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الدوليّة لحقوق الإنسان يلحظ حجم المتغيرات التي طرأت على مجتمعات الدول المضيفة للنزوح، وخصوصًا لبنان. واللافت أن التقرير من حيث مضمونه متضامن إلى أقصى الحدود مع النازحين، لكنه يطرح أكثر من علامة استفهام حول التداعيات المستقبلية، وأبرزها:
- التغيير الديموغرافي في لبنان، ومستقبل المجتمع المدني خلال السنوات العشر المقبلة.
- التغيير السياسي. أي لبنان سيكون، وهو وطن التنوّع والتعدديّة الثقافيّة، نظامه برلماني ديموقراطي توافقي. وأي نظام سيكون، وانطلاقًا من أي مجتمع؟!
- التغيير الاقتصادي، ودائمًا تحت شعار: هل يصمد الاقتصاد اللبناني الحر، والقائم على فلسفة المبادرة الفرديّة؟
- التغيير الثقافي، والمطروح هنا هل يتدرّج لبنان من الانفتاح، نحو التقوقع، وهل تنتصر الثقافة المحافظة المتشددة على الثقافة المنفتحة المتنوعة؟
- التغيير الاجتماعي، وعنوانه: هل يبقى لبنان للبنانيين؟!
يتحدث التقرير عن السنوات العشر المقبلة، والسؤال برسم اللبنانيين، ماذا بعد هذه السنوات العشر؟ وماذا نفعل وتفعلون كي يبقى لنا وطن؟!
الاندماج
انتقلت «أم مهى» من تحت السنديانة إلى وسط القرية، وأصبحت جزءًا من نسيجها الاجتماعي. وحالتها هذه تشبه حالات الكثيرين داخل المجتمع الوافد. لم يعد النزوح حالة إنسانية غايتها المأوى، والحماية لمدّة وجيزة، بل تحوّل الى غاية أخرى هي البحث عن الاستقرار الدائم أمنيًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، ومعيشيًّا، والى أمد غير منظور، وقد يكون إلى الأبد. ونجم عن هذا «الطموح» غير المشروع، هجرة من المخيم إلى الداخل اللبناني بحثًا عن فرص عمل في المدن، والبلدات الكبرى، وفي المجالات شتى. وأخرى من المخيم باتجاه الغرب الأوروبي والأميركي، والغربي بوجه عام.
تتمتع الهجرة الداخلية بكثير من الفرص المؤاتية، أولها سهولة التسلل من المخيمات المنتشرة على مساحة الرقعة اللبنانية الجغرافيّة، وهناك ما يزيد عن 1400 مخيم فوضوي فوق الأراضي اللبنانية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، والبقاع. إنه انفلاش فوضوي غير مسبوق، مدعوم بانقسام داخلي حول سبل المعالجة، وتهافت على فرص العمل في ميادين التجارة، والصناعة، وقطاعات البناء، والعقار، والسياحة، والزراعة، وسائر المهن اليدويّة.
وتكفي الإشارة فقط إلى هبوط النمو الاقتصادي بقوّة خلال سنوات 2010 – 2016 من 8 بالمئة، إلى ما دون الـ1 بالمئة. ولا يمكن هنا إغفال التداعيات المباشرة على القطاعات الأساسيّة المحرّكة للاقتصاد، القطاع السياحي الذي تراجع حوالى 30 في المئة، وشمل السيّاح الخليجييّن الذين انخفض عددهم ما بين 60 و70 في المئة، والقطاع العقاري، والبناء الذي تراجعت مبيعاته ما يزيد عن 35 في المئة، وكذلك الأمر مساحات البناء المرخّصة.
وتقدّر الخسائر التراكمية خلال السنوات 2010 – 2015، بنحو 15 مليار دولار، وتصل إلى ما يزيد عن الـ20 مليار دولار في نهاية العام 2016. كذلك، انخفضت الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة بشكل كبير خلال هذه السنوات، (حوالى 45 في المئة) بسبب تراجع منسوب الضمانات، وقلق المستثمرين خصوصًا الخليجييّن الذين كانوا يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار. واتسع العجز في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها (2010 – 2015) نتيجة ازدياد حركة الاستيراد حوالى 22 في المئة، وتقلّص الصادرات (نحو 33 في المئة)، بعد إقفال الطرق البريّة مع دول المنطقة.
ميزان المدفوعات تدهور بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة في الجوار، إذ تحوّل من فائض بقيمة 3.3 مليارات دولار (2010)، الى عجز يقارب 3.2 مليارات دولار (2015)، نتيجة تراجع التدفقات المالية من المغتربين، واتساع العجز في الميزان التجاري. وارتفع عجز المالية العامة من 5.7 في المئة إلى أكثر من 9 في المئة، من الناتج المحلّي، نتيجة تراجع الإيرادات، وتزايد النفقات العامة. وتقدّر التكلفة المالية لتداعيات الأزمة السوريّة على الخدمات العامة بما يراوح بين 530 و575 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015، وذلك وفق الآتي:
- الإنفاق الصحي: يتعرّض لضغوط، وزيادة الطلب على الخدمات الصحيّة، باعتبار أن نحو 75 في المئة من النازحين هم من النساء والأطفال. وقد بلغت النفقات الصحيّة للنازحين السورييّن ما بين 2011 و2014 حوالى 0.5 من الناتج، أي ما يفوق 310 مليون دولار.
- قطاع التعليم: يواجه تحديات خطيرة،، فقد وصلت أعداد التلامذة النازحين إلى 178 الف تلميذ ما بين 2015 و2016، وهم يشكلون نحو 60 في المئة من طلاب المدارس العامة في لبنان. وتظهر الإحصاءات أن العدد الإجمالي للتلامذة النازحين السورييّن الذين تراوح أعمارهم ما بين 5 و17 سنة يبلغ حوالى 450 ألفًا، لكن نسبة الالتحاق الدراسي تقدّر بحوالى 35 في المئة. وبين 2011 و2014 استطاع قطاع التعليم الرسمي احتواء التكلفة المالية لأطفال النازحين السورييّن، وقد بلغت نحو 190 مليون دولار، عبر المساعدات الدوليّة.
- الخدمات الاجتماعيّة: ترك النازحون السوريّون أثارًا واضحة على النفقات الاجتماعية، ربما كانت محدودة في البدايات، إذ بلغت في فترة 2012 – 2014 حوالى 30 مليون دولار، لكن فاتورة الخدمات تبدو باهظة، لا بل مكلفة حيث تسبب النزوح بضغوط كبيرة على استهلاك الطاقة الكهربائيّة، وبطلب إضافي للطاقة الإنتاجيّة (20 في المئة)، أي نحو 300 ميغاوات. وبلغت المساعدات الدولية للنازحين خلال السنوات 2011 – 2015 حوالى 3.2 مليار دولار، بما يمثّل أقل من 50 في المئة من احتياجاتهم.
المزاحمة
أحدث المجتمع الوافد من النازحين خللًا كبيرًا في سوق العمل، إذ يزيد العرض بنسبة 55 في المئة عن الطلب، فضلًا عن أن عدد العاملين السوريين الذين تفوق اعمارهم 15 سنة، أي سن العمل، يبلغ حوالى 950 ألف نسمة، أي 63 في المئة. وتظهر تأثيرات النازحين على سوق العمل اللبناني على الشكل الآتي: إرتفاع معدّل البطالة من 11 إلى 28 في المئة من القوى العاملة، ولدى الشباب تصل النسبة إلى 36 في المئة، وخفض مستويات الأجور، والمنافسة غير المشروعة.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت عدّة تعاميم تطالب فيها «بوجوب استخدام اليد العاملة اللبنانية، وعدم استبدالها بالعمّال الأجانب»، وأوعزت إلى «أجهزة التفتيش في كل دائرة، بإجراء جولات تفتيش يوميّة لمتابعة المؤسسات والشركات المخالفة على جميع الأراضي اللبنانية وملاحقتها»، ولكن النتائج لم تكن رادعة، خصوصًا بعد أن تأكد بأن العديد من المؤسسات اللبنانية تفضّل اليد العاملة الأجنبيّة لتدنّي رواتبها، فضلًا عن التهرب من الالتزمات القانونية والمالية التي يمليها الضمان الإجتماعي.
والخطير هنا، أن النازحين السوريين ليسوا فقط عمّال ورش بناء، إنما يجتاحون كل القطاعات، وكل التخصصات، من الهندسة، إلى الطب، إلى القطاع الفندقي، والمطاعم، إلى السياحة، وقطاع البناء، والزراعة، والفن، والأشغال اليدويّة، بالإضافة إلى فتح المؤسسات التجارية على أنواعها. وتبدو في الأفق ملامح انفجار اجتماعي كبير، لأن فرص عمل اللبنانييّن تتقلّص نتيجة المزاحمة من العمالة السوريّة الأقل كلفة. ويزيد النزوح السوري من أعداد الفقراء نتيجة انتشارهم في المناطق الأكثر فقرًا في لبنان، ويوجد حوالى 64 في المئة من النازحين السوريين بين البقاع (35.9 في المئة)، والشمال (28.2 في المئة) حيث تلامس نسبة الفقر في هذه المناطق حوالى 51 في المئة من إجمالي فقراء لبنان.
وتشير دراسة البنك الدولي إلى زيادة نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 28 إلى 32 في المئة، ما مثّل حوالى 210 آلاف فقير إضافي حتى نهاية 2016.
اقتراحات
أمام هول هذه المتغييرات، وما تتركه من انعكاسات على الكيان اللبناني، طرق المسؤولون الأبواب الخارجيّة بحثًا عن حلول ومخارج:
اقترحوا أولًا إقامة مخيم كبير على الحدود اللبنانية – السوريّة المشتركة، وفي الداخل السوري، وعلى امتداد مساحة كافية، تتولّى أمنه قوات دوليّة تابعة للأمم المتحدة. إلاّ أن الاقتراح سقط بفعل الضربة القاضية التي تلقاها من عدة فعاليات نتيجة اصطفافاتها السياسية – الطائفيّة المحليّة والإقليميّة. واستفاد المجتمع الدولي من هذا الإنقسام، ووظفه إعلاميّا وسياسيًّا على نحو غير مسبوق، للتنصل من التنفيذ.
اقترح الجانب اللبناني ثانيًا توزيع النازحين على الدول المقتدرة اقتصاديًا، ولديها مساحات شاسعة من الأراضي، إلاّ أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الدول النافذة والمقتدرة تنفيذًا لاستراتيجيّة اعتمدتها، وتقضي بإقفال أبوابها ومعابرها أمام النازحين، مقابل سلال مالية تدفع للدول المضيفة مثل لبنان، والأردن، وتركيا للإبقاء عليهم، والمساعدة على دمجهم.
توجّه لبنان ناحية الأمم المتحدة، وأمانتها العامة زمن ولاية بان كي مون، بحثًا عن خطة، عن وسيلة تساعد على إعادة النازحين إلى بلدهم، لكن الرياح الدوليّة لم تهبّ كما تشتهي السفن اللبنانية، وصدر تقرير بان كي مون الشهير في آذار 2016، الذي يدعو فيه إلى دمج النازحين في مجتمعات الدول المضيفة، مع الحرص على حق العودة الطوعيّة لمن يرغب. وتدخّلت الدبلوماسيّة اللبنانية يومها، لحمل كي مون على إدخال تعديل طفيف على بيانه، باستبدال عبارة «العودة الطوعيّة» بـ«العودة الإلزاميّة»، لكنها لم توفّق.
وكان مون قد حثّ الأسرة الدوليّة، والدول المانحة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على تقديم ما يكفي من دعم مالي لتجنيب لبنان الانهيار الاقتصادي، والمالي، والأمني، إلاّ أن ردود الفعل قد جاءت مخيّبة، ومشروطة: «مال.. مقابل اندماج، وتوطين؟!».
حاولت الدبلوماسيّة اللبنانية تغيير هذه المعادلة. وشارك لبنان بوفد رسمي في اجتماعات وزراء خارجية 68 دولة منضوية تحت لواء «الحلف الدولي ضد الإرهاب»، في واشنطن، في نيسان الماضي. وسعى الوفد إلى «استبدال محاولات تنظيم وجود النازحين على الأراضي اللبنانية، بتنظيم عودتهم إلى بلادهم»، لكنه فوجىء بأن أقصى ما يمكن أن يذهب إليه الدعم الدولي، هو استحداث وكالة «أونروا» جديدة خاصة بالنازحين، على غرار تلك التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينييّن في لبنان؟!
اغتنم الوفد اللبناني الفرصة، وكانت له لقاءات جانبيّة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، ومجلس الأمن القومي، وعددٍ من وزراء خارجية الـ68 الذين التقوا في ضيافة نظيرهم الأميركي ريكس تيلرسون. وأكد الوفد صراحة رفض لبنان الدعم الهادف إلى تنظيم الوجود السوري على الأراضي اللبنانية، ما لم يكن هادفًا إلى إعادتهم إلى بلدهم، على أن يتزامن مع دعم السلطات اللبنانية المضيفة لهم، وإعادة ترميم البنى التحتية التي يستخدمها النازحون.
وكان الوفد اللبناني واضحًا في شرح أفكاره لجهة دعم لبنان لمشروع «إقامة المناطق الآمنة» في سوريا لإعادة النازحين بالسرعة القصوى، وإن المجتمع الدولي قادر على المساعدة سواء في المناطق التي تسيطر عليها القوى النظاميّة، أو تلك التي تتواجد فيها القوات الدوليّة من أميركيّة وروسيّة وتركية، وإن كلفة تنظيم العودة إليها ستكون أقل بكثير مما يصرف في بلدان الجوار السوري، ودول الشتات الأخرى التي تستضيف نحو 5 ملايين سوري.
من واشنطن توجّه الوفد اللبناني إلى بروكسيل حيث شارك في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد يومها تحت شعار: «دعم السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة لمنعهم من الهجرة نحو الشواطىء الأوروبيّة والغربيّة». وقدّم ورقة عمل لحظت مبلغًا قدره 17 مليار دولار يمثّل حجم الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالقطاعات اللبنانية نتيجة النزوح. كما قدّم «خطة لبنان للاستجابة للأزمة»، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي في 19 كانون الثاني 2017، وقد لحظت مبلغ 10 مليارات دولار لإعادة بناء البنى التحتيّة وترميمها.
صحيفة «لو موند» الفرنسيّة التي واكبت يومها مؤتمري واشنطن، وبروكسيل، ذكرت في تقرير خاص «بأن لغة الأرقام التي قد تبدو خياليّة في بعض الأحيان، تفوح منها روائح كريهة، لا تتوافق والذوق العام، ولا مزاج شعوب العديد من الدول المضيفة للنازحين. صحيح أن البعض لديه الإمكانات، والقدرات (تركيا)، وراح يستثمر في هذا الملف في غير مكان لإثبات حضوره على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة، وتوصل بعد مفاوضات شاقة إلى اتفاق أبرم ما بين أنقرة، والاتحاد الأوروبي في آذار من العام 2016، تحت شعار «إقفال بحر إيجه أمام النازحين نحو أوروبا»، وقد استغل، ولا يزال هذا الاتفاق لابتزاز الأوروبييّن. لكن في المقابل هناك دول أخرى مضيفة، ترى نفسها على أنها أصبحت وجها لوجه أمام تحديات مصيريّة تتحكم بأمنها، بإمكاناتها الإقتصاديـــة، بسيادتهـــا، بثقافتهـــا، بنظامها السياسي، وهذا ليس بالسهل، لأن الذين يقامرون اليوم بورقة النزوح في المنتديات الدوليّة سيجدون أنفسهم، وفي مستقبل غير بعيد، أمام قنابل موقتة ستفجّر دولًا، وستكون تداعيتها خطيرة على المجتمع الدولي».
عناوين مصيريّة
لا تغفل البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة في بيروت حجم العبء الذي يتحمله لبنان، من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي، الى سفراء الدول الكبرى، وسفراء الدول المانحة. أمّا الخلاصة المتداولة في مجالسهم فتقتصر على عناوين ثلاثة:
الأول: إنّ لبنان لا يزال في عهدة الرعاية الدولية التي تمثلها « المجموعة الدوليّة لدعم لبنان»، خصوصًا لجهة توفير الاستقرار الأمني، والمصرفي، ودعم الجيش اللبناني، والقوى الأمنية الشرعية الأخرى، لتمكينها من محاربة الإرهاب، وحماية لبنان من الثقافة المتوحشة.
الثاني: إن الدول المضيفة للنزوح تتعامل بواقعية مع هذا الملف، تخطط، ترسم الاستراتيجيات، وتواكب كل مستجد قد يلحق ضررًا بمصالحها، فيما لبنان يتعامل بنظرة محدودة، وصدر ضيق، والدليل أن الانقسام السياسي الحاد الذي ظهر حول الطريقة التي يجب اعتمادها لمعالجة قضيّة العودة، قد ترك أصداء سلبيّة لدى الدول الصديقة، والتي تغار على مصالح لبنان العليا. والمؤسف أن هذا الخلاف قد انطوى على تباعدات سياسيّة، وطائفيّة، وفئوية...
الثالث: هل يتذكر اللبنانيّون الرقم الذي يتحدث عن 70 ألف ولادة في مجتمع النزوح، خلال عام؟ كيف سيكون هذا الرقم بعد عشر سنوات؟!... وأي تغيير سيضرب هذا البلد المنقسم على نفسه تجاه خطر وجودي؟!...
غادرت «أم مهى» خيمتها تحت السنديانة، لتستظل قرميد الضيعة الصغيرة... لكنّ السنديانة باقية.. لا تقوى عليها الرياح!...