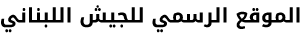- En
- Fr
- عربي
حوار
ليس من السهولة وضع الكاتب والمؤرخ والمحامي والروائي ألكسندر نجار في زاوية شكل روائي، أو منهج فكري محدّد، أو قالب شعري. فنتاجه الغزير والمتنوّع يندرج في إطار مسار يهتدي بالتاريخ، ويزاوج بين جمالية الكتابة واختبار دينامية البحث، والتوسع إلى نبش الذاكرة، والانتقال إلى رحابة الشعر، وفق تحدّ ذاتي يبعد عن إرثه عبء اللون الواحد.
ثمة خيوط تشدّ نصوص ألكسندر نجار إلى بعضها، وكأنّ الشخصيات مشتركة بين النصوص. وكل نصّ يصاغ هو مؤشر إلى رحلة بحث مسرفة في تعقيداتها. فهو يوثّق الحرب، والواقع الاجتماعي، والحياة السياسية بأسلوب يزاوج بين التحقيق الصحفي والشطحة الخيالية، كما في «رواية بيروت»، «حيث الراوي صحافي يروي سيرة مدينته عبر محطات عايشها مستندًا إلى وثائق وشهادات حية جمعتها»، يقول.
التزامه الوطني خيار انطلق منه للتعامل مع اليوميات والتأثير في الحياة والوقائع والأحداث: «أؤمن بالحرية وبالعيش المشترك ورفض الهيمنة الخارجية على لبنان، والتمسك بالسيادة على كامل أراضي الوطن. وهذا الالتزام واضح في كتاباتي نثرًا وشعرًا ومسرحًا».
في الشعر، أو الرواية، أو المسرح، يؤرخ نجار ليوميات الألم والأمل، حيث نعثر على مصالحة حميمة بين النبرة الرافضة المقاومة والدفق التفاؤلي. وفي السِّيَر الذاتية يزيل الغبار عن حياة معينة، راصدًا بدقةٍ المعطيات الحسية التي تكشف عن أعمق الحقائق ذات الصلة المباشرة بها كما في «أوراق جبرانية» و«على خطى جبران».
نتاج ألكسندر نجار ليس انكفاء على الجرج، إنّه صياغة تجربة حيّة تتزامن مع تاريخ في مدى الأمل والوعد.
«الجيش» حاورت نجار، وفي ما يأتي نص الحوار.
العمارة ولغة النار
• في سن التاسعة وضعت الحجارة الأولى لعمارة سوف ترتفع آثارًا شعرية وأدبية وسيرًا ذاتية ومسرحيات وروايات. إلى أي مدى كان لطفولتك الوعي لتطور النفوس والذهنيات، وسط التمايزات الاجتماعية ولغة النار؟
- في بداية الحرب، حاول والداي إيهامي بأنّ الحياة ما زالت طبيعية، فكانت والدتي تقول لي عندما تنهمر القذائف على الحيّ: «لا تخف، إنّها أسهم نارية»، فكنتُ أبتهج للأمر. لكن سرعان ما اكتشفتُ الحقيقة، وفهمتُ أنّ لعبة الموت هذه فتّاكة وأنّ لغة النار هي السائدة... فلجأتُ إلى القراءة وأصبح الكتاب رفيقي في المنزل والملجأ، لا سيما وأنّ المدارس كانت تقفل أبوابها باستمرار. وقد شجّعتني والدتي على المطالعة وقَرَأَتْ قصّتي الأولى التي كتبتها وأنا في التاسعة من عمري، فطَبَعتها على الآلة الكاتبة، ما جَعَلني أشعر بالاعتزاز وحَمَلَني على المثابرة في تأليف القصص القصيرة والقصائد والروايات والمسرحيات.
الحرب تجربة للكاتب
• استلهمت الحرب في بعض أعمالك، فهل صقلتها بالمعاش؟ وهل ما زلت تحتفظ من الحرب ببعض الانفعالات التي تنعكس في توجُّهك الأدبي أو تؤثّر فيه؟
- يقول الكاتب إرنست همنغواي: «تجربة الحرب لا تقدّر بثمن بالنسبة للكاتب»، أي أنّها تقدّم له المواد اللازمة لمؤلّفاته، كونها تتضمّن كمًّا كبيرًا من الأحداث والمآسي والبطولات، فضلًا عن أنّها تعلّم التضامن والأخوّة والإيمان والصبر والرجاء. صحيح أنّ الحرب كارثة لا يمكن للإنسان أن يتمنّاها، إلّا أنّه يكون مرغمًا على التأقلم معها حين تحصل، فيتعايش معها. في الواقع، لقد أثّرت فيّ الحرب بشكلٍ كبير فغيّرت مفهومي للوجود وعلّمتني أن أستفيد من كل لحظة، فالحياة الإنسانية هشّة. كما علّمتني الحرب قيمة الأمور البسيطة، كالشمعة والخبز والمياه التي تصبح ثمينة فنقدّر أهمّيتها. ولقد كتبت «مدرسة الحرب» لأروي تجربتي كطفل ثم كمراهق خلال فترة الحرب اللبنانية، علمًا أنّ هذا الكتاب يتضمّن ذكريات شخصية بالإضافة إلى شهادات لأصدقاء من جيلي. كما خصّصت عدّة صفحات في «رواية بيروت» و«قاموس جبران» لمرحلة الحرب التي لا تغيب أبدًا عن بالي.
لا أبحث بل أجد
• نصوصك تشي برغبة عميقة في الصقل اللغوي، هل هذا نابع من إملاءات العقل بمنأى عن أي اهتمام جمالي، أم من رغبة الابتعاد عن الكتابة التقليدية فحسب؟
- تنبع الكتابة من الذات، عقلًا وقلبًا، من دون أن يخطّط الكاتب بصورة «علمية» لكيفية التعبير عن أفكاره. صحيح أنّني أهتمّ بالصقل اللغوي إلّا أنّني لا أطرح على نفسي تساؤلات حول الجمالية وإملاءات العقل، فالكتابة هي حصيلة الإلهام والإبداع. وإنّي، في هذا المجال أشاطر الرسّام بيكاسو رأيه: «إنّني لا أبحث، بل أجد!» (Je ne cherche pas, je trouve).
• نتاجك الغزير وعملك الدؤوب يؤشران إلى الإمساك الواضح بالنص الروائي عبر أقنية الحبكة والشخصيات وتلاوين الزمان والمكان، هل يعكس هذا البعد التقني الروائي فقط أم أيضًا البعدَين السياسي والإيديولوجي، مع العمل على صهرها كلها في ترابط عضوي؟
- تشكّل الرواية فعلًا بنى متكاملة ومتماسكة تجمع الأسلوب والأفكار والخيال والسردية والشخصيات وتلاوين الزمان والمكان... وفي بعض الأحيان، أحبّ أن أضيف إلى الرواية بُعدًا روحانيًا كما في «قاديشا» أو سياسيًا كما في «برلين ١٩٣٦»، أو سوسيولوجيًا كما في «رواية بيروت»... ولكن هذه الأبعاد ليست ضرورية لإنجاح الرواية إذ يُعقل أن تكون رواية عبثية Absurde أو بوليسية أو رومنطيقية أو مبنيّة على تجدّد في الأسلوب كما في «الرواية الجديدة» «Nouveau Roman» التي ترفض شخصية البطل التقليدية ومحدودية المكان والزمان...
• هل لمواكبتك الحرب من جهة، والمستجدات الأمنية والسياسية في تواترها اللاهث من جهة أخرى، وتناولك للعوالم الروائية والشعرية، علاقة أو ارتباط بهاجس الصدور؟
- أنا أؤمن مع جان بول سارتـر بأنّ الكاتب يجب أن يكون «حاضرًا في عصره» (En situation dans son époque) وبأنّ ثمّة مسؤولية تقع على عاتقه... فعندما حلّـت جائحة كورونا علينا، مثلًا، سارعتُ إلى إصدار كتاب «التاج اللعين» الذي يروي «الفصل الأول من التراجيديا»... كما كتبتُ ديوانًا شعريًا حول «الخيام» عند تحرير الجنوب في العام ٢٠٠٠ نشرته دار النهار في حينه، بالإضافة إلى ديوانٍ آخر حول
الزلزال الرهيب الذي دمّر جزيرة هايتي، وحول تحطّم طائرة الخطوط الجويّة الأثيوبية في ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٠ بعد لحظات من انطلاقها من مطار بيروت...
من هنا، فإنّ صدور بعض الكتب يمكن أن يتأثّر فعلًا بالتطوّرات الأمنية أو السياسية أو بأحداث أو كوارث معينة...
جدلية الكاتب والالتزام
• أسلوب كتاباتك عبر تنوّعه وإيقاعيّته يعطي انطباعًا بأنّك رجل حرية في كل الميادين، بما في ذلك ميدان الرفاهية. إلى أي مدى يبدو هذا الانطباع صحيحًا؟
- «الحياة من دون حريّة كالجسد من دون روح» يقول جبران خليل جبران. الحرية موجودة في جميع مؤلّفاتي حتى في السّيَر كسيرة جبران أو يوحنّا المعمدان أو ميشال زكور الذين كانوا أحرارًا. ولعلّ الكتاب الذي يجسّد تمسّكي بالحرية هو «أثينا» الذي يروي حرب الاستقلال اليونانية ضدّ الأمبراطورية العثمانية.
أما لجهة «الرفاهية»، فإنّ مسرحياتي تتضمّن شيئًا من السخرية والفكاهة وتسودُها فكرة التحرّر من التقاليد البالية أو الأفكار المسبقة أو تجاوزات القضاء أو الرقابة... في الحقيقية، إنّ لبنان من دون حرية يفقد هويته، ما يستوجب حماية الحريات العامة فيه، وخصوصًا حرية التعبير التي سقط من أجلها العديد من الصحافيين والكتّاب الأحرار.
أعشق الصحافة
• نلاحظ في بعض رواياتك هاجسًا توثيقيًا يشبه التحقيق الصحفي في رصد معطيات الوقائع والأحداث وإضفاء طابع الدينامية على وصف متعدد الزوايا والملامح، هل هذا صحيح؟
- نعم... فأنا أعشق الصحافة واخترت أن يكون بعض أبطال رواياتي صحافيين... لذلك، نرى فعلًا في كتبي هامشًا توثيقيًا يشبه التحقيق الصحفي، وهذا ينهض بشكلٍ خاص بـ«رواية بيروت» حيث الراوي صحافي يروي سيرة مدينته عبر محطّات عايشها، مستندًا بذلك إلى وثائق وشهادات حية جمعتُها. غير أنّه يقتضي على الكاتب أن يبقى متيقّظًا لتجنّب إغراق الرواية بالمعطيات التاريخية والتفاصيل المملّة، لئلا يتحوّل كتابه من رواية إلى كتاب تاريخ أو مقالة صحفية أو... أطروحة!
جبران مفكّر وليس فيلسوفًا
• كتابك «سيرة جبران خليل جبران» أهو إضافة تراكمية، أم أنّه أعطى الشخصية بعدًا استدراكيًا يبلور ناحية جديدة في فلسفته وفكره؟
- إنّي أرفض صفة «الفيلسوف» لجبران، إذ كان يرفض استخدام هذا المصطلح بالنسبة لأعماله. جبران مفكّر ولكنّه ليس فيلسوفًا وإن تأثّر بأعمال الفيلسوف الألماني نيتشه. في الواقع، لقد شرب من ينابيع عديدة وتمكّن بفضل عبقريته، من صبّها في قالب مميّز وخاص يحاكي القرّاء من جميع الأجيال والعصور والبلدان... لقد ألّفتُ ٥ كتب حول جبران منها «قاموس جبران» الصادر عن دار الساقي، كما أشرفتُ على ترجمة أعماله الكاملة إلى اللغة الفرنسية لدى دار روبير لافون في باريس. وأعتقد أنّ هذه الكتب لخّصت حياته ومؤلّفاته وأفكاره ورسومه واضعةً الأمور في نصابها الصحيح ومبدّدة بعض المزاعم المغرضة أو الخيالية حول سيرته. كما اكتشفت في جامعة هارفرد وفي جامعات أميركية أخرى رسائل ورسومًا جديدة له نشرتُها في «أوراق جبرانية» و«على خطى جبران»، بالإضافة إلى نشر صور للوحات جبران الموجودة في متحف «سوميّا» في مكسيكو حيث تُحفظ مجموعة اشتراها رجل الأعمال المعروف كارلوس سليم من عائلة النحّات خليل جورج جبران، الذي كان يحتفظ في بوسطن بأعمال ومقتنيات عائدة لقريبه جبران خليل جبران.
والحقيقة أنّي عشقت جبران لدرجة أنّه الموضوع الوحيد الذي بقيت أتابعه منذ أول كتاب أصدرته عنه، على خلاف كتبي الأخرى إذ أطوي الصفحة عند صدور الرواية أو السيرة.
صورة العائلة وهاجس الكتابة
• في نسيج كتاباتك، ما الهاجس الذي تعتبره الأكثر سيطرة على فكرك؟
- صورة العائلة موجودة في كتاباتي لا سيما في كتاب «ميموزا» الذي أهديته إلى أمي و«أمير البحار» الذي يروي علاقتي مع والدي، صورة الحرب أيضًا لا تغيب عن بالي كما قلت، إلّا أنّ كل كتاب يستحضر صورًا جديدة ويفتح أفقًا جديدًا فيستحيل عليّ حصر رواياتي بصور محدّدة تسيطر على توجهاتي...
• من رواية إلى رواية، ومن سيرة إلى سيرة، ومن نصّ إلى نصّ، ثمة تأملات في تعاقب الأحداث، وتواتر التواريخ، تطرح معها المصير الفردي ووعي الشعور الوطني. هل هناك في هذا الإطار تجاوز للمعطيات باتجاه فعل إيمان بالمستقبل؟
- كتابي «قاموس لبنان»، يُعد قاموسًا عاطفيًا لكونه يتحدّث عن لبنان، عبر أكثر من ٢٠٠ مدخل من منظاري الشخصي، بعيدًا من القواميس المعتادة التي تتضمّن معلومات جامدة وباهتة وموضوعية إلى حدّ ما. يجسّد هذا القاموس نظرتي إلى لبنان ويعبّر عن عشقي لوطني، وقد أبرزت فيه معالمه وميزاته وشخصياته العظيمة، وأعربت فيه عن تقديري للجيش اللبناني الذي أعتبره الحصن الأول والأخير وضمانةً لوحدة لبنان... كما يعبّر هذا القاموس عن قلقي حيال مستقبل لبنان، وعن امتعاضي ممّا وصلنا إليه اليوم بسبب الاستهتار واللامسؤولية والفوضى. لقد احتفلنا في أيلول ٢٠٢٠ بمئوية لبنان الكبير، ولكن لبنان اليوم هو في حالة أتعس ممّا كان عليه منذ مئة عام! أي بلد آخر في العالم كان وضعه أفضل في القرن السابق؟
في الواقع، عندما أكتب عن لبنان، أحاول دائمًا أن أتخطّى المصير الفردي للشخصية التي تتمحور حولها الرواية لأعرض المسائل الوطنية من وجهة جماعية ومن منظار المصير المشترك وديمومة لبنان.
أحد مفاتيح الحل
في كتابه "قاموس لبنان" يكتب ألكسندر نجار عن الجيش، فيقول: يُنظر إلى الجيش في لبنان على أنّه الحصن الأخير في وجه الفوضى...رغم المحن التي واجهتها عرفت المؤسسة العسكرية كيف تصون الديموقراطية اللبنانية (على هشاشتها)، والدليل على ذلك تساهلها مع المتظاهرين خلال "ثورة الأرز"، كما أنّها لم تغامر بقلب النظام وتحويله إلى ديكتاتورية عسكرية...
ويبقى الجيش البوتقة الأساسية للوحدة الوطنية اللبنانية شرط الحفاظ على استقلاليته وتأمين الدول الغربية التجهيزات اللازمة له. قبل خمس وعشرون سنة نشر أحد الضباط بحثًا بعنوان "ويبقى الجيش هو الحل". لا أدري هل الجيش هو فعلًا الحل الوحيد، لكنني على يقين أنّ الجيش حتمًا هو أحد مفاتيح هذا الحل!