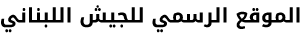- En
- Fr
- عربي
قصة قصيرة
تنهّد تنهدة عميقة وأعقبها بأووف (تأفّفية)... طويلة، ثم تمتم:
«ها قد عدت ولا أدري إن كانت عودتي ستفرحني أو تشعرني بالراحة والإطمئنان...
يا ألله! كيف مرّت السنون بسرعة!...».
تناول من جيب سترته الداخلية علبة معدنية، فتحها من دون إكتراث وتناول منها سيجارة.
ثم أطبق العلبة وأعادها إلى حيث كانت.
وقبل أن يشعل السيجارة استدرك بلباقة وهو يقدّمها لي:
«عفواً... لا تؤاخذني... لم أعد أركّز...تفضل...!».
فأومأت له بيدي أن:
«لا شكراً... أنا لا أدخّن».
تبسّم، ثم علّق:
«أنا أعرف ضررها كما يعرف الكثيرون ضرر المعلّبات. ومع ذلك يقدمون على تناولها...».
ثم أشعل السيجارة وأخذ نفساً طويلاً وتابع:
«لعلها الرفيقة الأخيرة الباقية بجانبي...».
ثم تابع:
«... كنت أقول ما إذا كنت فرحاً مطمئناً بعودتي إلى الوطن بعد مضيّ نصف قرن!».
ثم سحب نفساً آخر من سيجارته وهزّ رأسه هزّات متتالية... يبحث في عالمه عن صور ما تزال تضج في ذهنه بفوضى وتابع:
«هاجرت إلى أميركا في الـ 49 على متن «بابور» نقلنا من «بور» بيروت إلى البرازيل... أربعون يوماً ونحن في البحر... لم أهتم للتعب ولا للدوخة التي تصيب عادة المسافرين في البحر. كنت أفكر بالعمل... ماذا سأعمل في مكان لا أعرف ناسه ولا لغته. نعم كنت ذاهباً إلى المجهول وأنا أعرف أنني سأشقى في البداية وسأنام كالمشردين وسأتعرّض للبرد والجوع... ومع ذلك فقد كنت أشعر بإرادة متينة وعزم قويّ. لا تسألني عن سبب سفري أو هجرتي، فالآلاف من اللبنانيين سبقوني منذ ما قبل العام 1900. ولكل واحد منهم سبب. والأسباب معظمها بحثاً عن رزق وحياة أفضل.
آه طبعاً... أنا كان لي سبب آخر عجّل بسفري... وهل أنسى ذلك؟
لن تجعل مني السنون الست والسبعون أنسى...
كان ذلك بسبب إبنة قريتي سعاد... سعاد التي عرّفتني على الحب... فتحت قلبي برفق... ووضعت فيه شيئاً من سحر لم أعرفه قبلاً.
بإختصار... علّمتني سعاد الحب وأنا في الخامسة عشرة من العمر. لم يكن يشغلني في قريتي إلاّ حفظ قصيدة، أو حلّ مسألة حسابية حتى لا أعاقب في المدرسة. وأحياناً كنت أساعد والدي في نكش «جلّ البطم». كان والدي يردد دائماً أن الأرض هي الأم المعطاءة. نعم كان لديّ طموح آخر يعتمد على زيارة خاصة يقوم بها أبي إلى النائب الفلاني فأحصل بواسطته على وظيفة تؤمّن لي مستقبلي فأتجرّأ وأطلب من أبي أن يخطب لي حبيبتي سعاد.
إلاّ أن سفينتي اشتهت ريحاً ما لبثت أن حطّمت شراعها وقلبتها.
لقد عاجل الموت أبي ولم يترك لي سوى المحراث كمصدر للرزق، فتركت المدرسة ولبّيت نداء الثور والحمار فلحقت بهما أفلح وأزرع، ثم جاء من يخبرني أن سعاد خطبت لإبن «بو صالح» تاجر البقر.
لم أصدّق الخبر، فقد تواعدنا على المصير الواحد. فسعيت مخاطراً لمقابلتها وبرّرت قبولها بأن الحياة «قسمة ونصيب» وأنني ما زلت فتيّاً على الزواج.
كلام جديد وكبير من سعاد لم أعهده من قبل. لم أكن أعلم أنها تملك كل هذا العقل وحدها؟!... فصاحة وبلاغة وفهم عجز عنه كثير من الفلاسفة وسألتها:
«وحبّنا؟ ووعدنا؟
فأجابت كعالمة إجتماع محاضر أمام الطلبة بكلام كثير ونصائح وإرشادات لطفل في السابعة من عمره.
وكنت استمع إليها وعيناي تتّسعان دهشة، وقبل أن تغادرني، طبعت على خدّها الأيسر أربع علامات حمراء أشفق الإصبع الخامس عليها فتمرّد.
لا تلمني على ما فعلت. فللقلب أيضاً كرامته وعليه أن يثأر لها.
من أجل ذلك عجّلت بالسفر لأحصل على ثروة أشتري بها مزرعة كبيرة تضاهي عدداً ونوعاً أبقار مزرعة «ابو صالح» وتدر حليباً أكثر فأغطي حاجات أبناء قريتي والجوار.
حاولت والدتي أن تثنيني عن رغبتي بالسفر فأصريت وبإلحاح. كنت آنذاك أشد عناداً من تيس المعزى. واضطرت والدتي مرغمة الى أن تبيع «جل البطم» من أجل تكاليف السفر وأنا اعدها بأن أرسل لها أضعاف هذا المبلغ فتستعيد الجلّ، وتشتري الحقول المجاورة لإقامة مزرعة الأبقار فيها.
في ساو باولو تنقّلت في أعمال لا تحتاج إلى لغة أو تخاطب، كجلي الأطباق في مطعم أو غسيل سيارات.
وجهدت لأفهم لغة أهل البرازيل البرتغالية.
كنت أعمل من دون توقف لأوقف شريط الذكريات الذي ما انفك يعود بي إلى القرية فأسرح في الليل أنا والأصحاب في كرم أبي خليل البرطاشي، نصافح التينات بهمس، نكور حباتها ونحن «نصهصن» ثم تميل الدوالي المتراخية على السياج فنقطف عناقيد العنب.
كنت أحاول منع هذه الذكريات كي لا تنال من إرادتي وغربتي فتضعفني.
وما أن كنت أضع رأسي على الوسادة حتى يطل وجه أمي الحنون تلوح لي بمنديلها الأبيض وهي تقف على رصيف ميناء بيروت وصوتها يذكّرني بإرسال المال لتستعيد «جل البطم».
لجأت إلى الملاهي الليلية لأجد في الموسيقى ورقص الرومبا والسامبا والسالسا ما يلهيني عما يضعف إرادتي في البقاء.
كان يلفتني عشق البرازيليين للحياة فيعبّرون عن ذلك برقص لا يتوقف.
وفي أثناء تأملاتي بهم إذا بفتاة برازيلية تتقدّم مني وتشدّني الى حلبة الرقص فتفك عقدة خجلي وشرودي. تعوّدت يداي مناعم الخصر و...أكثر... غرقت في لجج الرقص اللاتيني المثير فالتهيت عن قريتي وعن «جل البطم» و«مزرعة البقر» و... سعاد.
بعد سنوات جاء من يخبرني أن والدتي يئست من عودتي فآثرت الرحيل الى جوار أبي... رحمهما الله.
استوقفني هذا النبأ مع دموع حارة ما لبث ان قطع التفكير نهائياً بعودتي الى لبنان والثأر لقلبي وكرامته!
تعرّفت على روزا... فتاة برازيلية في الثامنة عشرة من العمر...
كان كل ما فيها يتوهّج كالنحاس. وجهها بكل تفاصيله، جسدها، حتى عيناها كانتا ترشقان الناظر سهاماً نحاسية تنفذ إلى أعماق النفس. تعلّقت بها... عرضت عليها الزواج لتبقى لي... لي وحدي.
وقبل أن يمنعها التفكير كنت أغرقها بالهدايا... فقبلت.
لم نكن بحاجة الى حضور أهلها ولو أنهم حضروا في ما بعد للتهنئة.
وأمضينا سنوات مضطربة قلّما خلت من الصراخ والزعيق لامتناعها عن تغيير سلوكها حتى بعد أن رزقنا بسليمان وكلوديا.
كانت تردّد دائماً أنها تعيش حياتها. في إحدى الليالي كانت ترقص مع شاب يعرف أكثر مني «الحياة الحلوة»... فاقتربا من بعضهما حتى التصقا في جسد واحد يهتزّ. لم احتمل. دخلت حلبة الرقص لانتزعها نزعاً من يدي صديقها الملتصق بها. وعاجلته بلكمة - ذكّرتني بلبطة حمارنا الأغبر - ألقته أرضاً. وأما روزا فقد كرّرت العلامات الحمراء على خدها وهذه المرة كانت خمساً. فانتفضت تزأر كلبوءة وتصهل كفرس وتقوقىء كدجاجة وتعوي كذئبة وتخور كبقرة، ترميني بأقسى وأبشع العبارات أقلها أنني متخلّف وبدائي ومتحجّر الأحاسيس وجاهل لا أعرف كيف أعيش؛ وكان الحل السريع بالطلاق.
ولأنها تريد أن «تعيش حياتها» تخلّت لي ومن دون تردد عن سليمان وكلوديا - طبعاً كي تعيش - وهكذا كان عليّ أن أعدّل من أسلوب حياتي لأريح ولديّ.
كنت أدفع مبلغاً من المال لسيدة تجالسهما فور عودتهما من المدرسة وحتى أعود، فأتابع العمل: أباً، وأماً، مربياً، خادماً، قصّاصاً أو حكواتياً.
نعم شعرت بفرح وبأهمية الهدف لأن أكون حكواتياً. فصرت مساء كل يوم أحدّث ولديّ عن قريتي وعن قرى أخرى من لبنان. كنت أحاول أن أنقل إليهما الإحساس بالإنتماء إلى كل ما أحب في وطني لبنان...
أذكر لهما كيف نحيي الأعراس و«ندبك» يداً بيد. لم أذكر لهما كيف كنت أنتظر هذه الدبكة لأمسك يد سعاد وأضغط على أصابعها فتفلت منها صرخة «آخ» وتضيع في صخب وضجيج قرع الطبل وخبطة أقدام الراقصين وغناء الدلعونا.
لا لم أذكر لهما حبي الأول البريء لسعاد وشعرها الفاحم المسدول على الكتفين وعينيها العسليتين وشفتيها الرقيقتين وصوتها الموسيقي ومشيتها الغناجة.
حدثتهما عن «خلة بو مرعي» وكيف كنا نتسابق والواوية للحصول على «المقتي» والفول - حسب المواسم - كيف كنا نجلس على الصخور المشرفة على الوادي. كنت أذكر لهما كل شيء ليس بهدف التذكر أو لأنني مشتاق، بل لأعلمهما على الحب وأنقل إليهما شيئاً من البيئة التي نشأت فيها فأجعلهما يتعلّقان بأهلهما فأكفّر عمّا فعلت.
كان ولداي يكبران وأنا أراقبهما. وكلما شعرت أو رأيت ما لا أرضى عنه في سلوكهما ولباسهما حتى أعود إلى سرد ما أتذكر أو ما أستطيع تأليفه، فأجول بحديثي على قلعة بعلبك وجبيل وصيدا وصور... أو ما أجاد به الله على لبنان من روائع من هضاب وأنهار وشطآن ومناخ وغير ذلك. كنت أسهب في الوصف وبإحساس أكثر صدقاً ليعبّر عما في نفسي ولاحظت أن اللياقة والإحترام وأدب الإستماع قد غابت عنهما إذ كان سليمان يقاطعني في بداية حديثي قائلاً إنه على موعد مع صديقته ويرحل من دون أن ينتظر ردّي، ثم تقاطعني كلوديا أنها مشغولة في غرفتها فأتسمّر في مكاني، أردّد آخر كلماتهما كـ«الأهبل».
لم أكن أنتظر بعد سنين أمضيتها في تربيتهما أن يأتي ذلك اليوم حين علّق سليمان حقيبته بكتفه، وقال لي بكل سذاجة:
«باي»!...
سألته: «إلى أين؟!».
قال: «استأجرت غرفة... وسوف أسكن فيها!».
أجبت بذهول:
«لماذا؟ هل سمعت مني ما لم يعجبك؟!... أو قصّرت بواجبي تجاهك أنت وأختك؟!
قال متبسماً:
«لا... لماذا تقول هذا الكلام بابا... بالعكس. كنت أباً جيداً، ولكني أصبحت في التاسعة عشرة من عمري، وها قد بقيت أشهراً من دون أن أستقل بحياتي».
نعم لم أكن أنتظر ذلك مع علمي بسلوك وتقاليد وعادات وتفكير أهل البرازيل وأميركا وأوروبا. بل كنت أعرف أن الإبن أو الإبنة إذا ما بقيا في المنزل بعد هذا العمر أصبحا عرضة للإنتقادات.
رددت وهو يخرج، و«حاكورة» أم سعيد، «وخلّة بو مرعي»، و«تينات» خليل السمراني:
«ألا تحب التين والعنب؟!»
فأجابني الباب وهو يصفق وراءه:
«أسكت يا أجدب!».
بعد مدة عدت من العمل وكنت قد نلت علاوة على راتبي. فكّرت بأن احتفل بالمناسبة فأخرج وإبنتي كلوديا إلى أحد المطاعم لتناول العشاء... دخلت الى المنزل وناديت:
«كلوديا... كلوديا!».
فلم أسمع جواباً... دخلت غرفتها فلم أجدها. رحت أفكر بسبب ما لغيابها في الوقت الذي وقع نظري على ظرف في مكان ظاهر، وبخط عريض:
«إلى والدي العزيز!».
تناولته وفضضته بسرعة لأقرأ... بأنها رحلت الى مدينة ريو دو جانيرو... بعدما قبل طلبها للعمل في إحدى الشركات.
كيف؟ ولو؟ ألا تسألني؟ ألا تخبرني؟ ألست والدها ووالد أخيها؟ بلى... أنا كل هذا ولكن هذه التقاليد؟!
عليك أن تحترم تقاليد البلد الذي تعيش فيه.
كنت بعد ذلك أتابع الإتصال بكلوديا وسليمان، أحياناً... لتمضي السنون ثقيلة في المنزل بسبب الوحدة، فألجأ إلى الملاهي من جديد... أمضي الليالي في صخب كي لا أستمع إلى ما تحدثني به نفسي من شجون.
ومرّت السنون وتقاعدت عن العمل وعن الملاهي... لم يعد يليق بي النظر لا إلى الأجساد النحاسية ولا الخشبية... عافت نفسي ارتياد أماكن كهذه.
صرت أتناول الكحول في المنزل وأحياناً في أماكن عديدة في الطبيعة. كنت أشعر أن الوقت يحزّ بعمري من دون أن يسألني رأيي... أو يخبرني كيف ستكون نهايتي... مع أن دور العجزة متوافرة هناك!
احترت كثيراً في ما أفعل. طبعاً كنت أفكر في العودة الى قريتي... وهكذا فعلت.
في أقل من يوم عدت إلى لبنان... بالطائرة.
وصلت مطار بيروت. استقليت سيارة أجرة وذكرت للسائق إسم قريتي...
نظر إليّ السائق مفكّراً... كمن يتذكر أمراً...
سألته: ألا تعرفها؟!
أجاب متبّسماً: بلى... معقول؟!
ثم انطلقت بنا السيارة... كنت أشاهد شوارع ومبانٍ في أثناء توجهنا الى قريتي... لم تكن تعني لي شيئاً.
ووصلت الى قريتي... جهدت لمعرفة عنوان منزلي:
بيت عتيق - بل خربة - تهدّم سقفها وقسم من جدرانها وحولها استوطنت الحشائش والأشواك من دون استئذان من أحد.
قدم بعض الناس الذين دفعتهم الحشرية للسؤال عن «غريب» جاء إلى قريتهم أو مَن عرف بعودتي فجاء مستقبلاً مرحّباً.
وكان الجميع من غير جيلي. سألت كبيرهم عن فارس الحسني. فنظروا إلى بعضهم البعض متسائلين، ثم قال أحدهم:
- آه. أبو سايد... الله يرحمه!...
ثم سألت عن اسماعيل الدبغي، وعبد المنعم القشوع وابراهيم الناطور وسعاد...
- سعاد بنت بو جميل الدكّنجي... ألا تعرفونها؟
وكانت الإجابات: هذا الله يرحمه... وذاك في بيروت عند ابنه. وذلك مقعد في سريره.
صمت بلهفة: من هو المقعد؟ إبراهيم الناطور؟ ما زال في بيته قرب الجميزة؟
التفتوا الى بعضهم البعض متسائلين عن الجميزة وعن البيت...
- لا ... هدم بيته وبنوا مكانه بناية... ولكن...
صحت: ولكن ماذا؟!
أجاب أربعيني: صار معه نشفان... يعني... لم يعد يعرف أحداً حتى أولاده... لا لن يعرفك فلا تجهد نفسك.
سكتّ ثم استأذنت المستقبلين المرحّبين بي بالإنصراف...
مضيت الى «جل البطم» آملاً أن أجد فيه ما يتذكرني بعد أن رحل أو غاب رفاقي...
فلتكن ذكرياتي إذاً مع النبات شجرة «البطم» العجوز، سنديانة، وزّالة، وقندول.
وصلت إلى حيث كان «جل البطم» ولكني لم أجده. جلت بنظري باحثاً عنه... ولكن... بدون جدوى... هل رحل أيضاً؟
هنا كان... يعني هذا المبنى المؤلف من طبقات... يا ألله... كان من الممكن أن يصبح مزرعة أبقار.
الآن يا بني أبحث عن صخرة عتيقة في قريتي فأحدثها بما بقي لي من العمر وأثني عليها لأنها بقيت ولم تغادر موطنها.