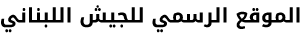- En
- Fr
- عربي
الانتخابات الرئاسية الفرنسية والقطيعة الموعودة في السياستين الداخلية والخارجية
مقدمة
على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية الفرنسي بمفرده، إضافة إلى تلك التي يتقاسمها مع الحكومة والبرلمان، ومع كونه بات ينتخب مباشرة من الشعب منذ التعديل الدستوري العام 1962، فإنه لا يمكن تصنيف النظام السياسي الفرنسي بأنه رئاسي، ذلك أن السلطة التشريعية، بمجلسيها (الشيوخ والهيئة الوطنية)، تملك صلاحيات التشريع ومنها تنبثق الأغلبية الحاكمة، وبالتالي الحكومة التي إذا لم تكن من التيار السياسي الذي ينتمي إليه أو يتزعَّمه الرئيس، يمكن لها أن تقيّد عمله بالكثير من السلاسل الدستورية والسياسية، كما حصل في إبان رئاستي ميتران وشيراك. من هنا، يمكن القول إن فوز المرشح في الانتخابات الرئاسية لا يصبح مكتملاً إذا لم يتبعه استحواذ على أكثرية نيابية مريحة تولد من رحمها حكومة تنسجم مع رئيس الجمهورية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسي وفقًا للنظام الأكثري أو الأغلبي، إذ يفوز منذ الدورة الأولى من يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وتجري دورة ثانية نهار الأحد ما بعد التالي، أي بعد أسبوعين تماماً من الأولى، تنحصر فيها المنافسة بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات في الدورة الأولى. ويغدو رئيسًا للجمهورية من يحصل على العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدورة الثانية(1).
وللحد من عدد المرشحين، لا سيما أولئك الذين لا وزن شعبياً أو سياسياً لهم، يفرض القانون أن لا يستحوذ على صفة المرشح إلا من ينجح في جمع خمسماية توقيع من قبل ممثلين منتخبين من الشعب على الصعيدين الوطني والمحلي، موزَّعين على ثلاثين محافظة، شريطة ألاّ تتجاوز تواقيع كل محافظة عُشر التواقيع المطلوبة. كما يخسر المرشح رسم الضمانة الذي يدفعه إذا لم يحصل على نسبة الخمسة في الماية على الأقل من أصوات المقترعين. وفد نجحت هذه الطريقة في الحد من عدد المتبارزين للوصول إلى الإليزيه والذين بلغ عددهم عشرة العام 1981، وتسعة في كل من العامين 1988 و1995، ثم ستة عشر العام 2002، واثني عشر في الانتخابات الأخيرة.
وتخضع الحملة الإنتخابية لقوانين منظمة للإنفاق المالي والمساواة بين المرشحين لجهة الدعايات الإعلامية. وتقع تحت رقابة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة ولجنة التحقق من صحة سبر الآراء ولجنة وطنية مؤلفة من خمسة أعضاء من كبار القضاة.
وبعيداً عن الغوص في تحليل دستوري وقانوني للانتخابات الرئاسية الفرنسية أو لصلاحيات الرئيس ومهامه ومسؤوليته السياسية وحصانته بعد هذه الانتخابات، ولا سيما أن الذي فاز فيها حمل شعار القطيعة مع السياسات التي كانت سائدة إلى اليوم.
وبعد قراءة سريعة وهادئة للحقبة الشيراكية المنصرمة، سوف نحاول قراءة ما بين سطور المعركة الانتخابية نفسها عبر المرشحين، والرهانات، والمفارقات، والدروس المستفادة من الدورتين، مع تسليط الأضواء على مكانة السياسة الخارجية في الجدل الانتخابي، والتساؤل حول مقدرة المرشح الفائز على الوفاء بالوعد الذي قطعه أمام الناخبين بالتغيير وأحياناً القطيعة مع ما كان سائداً.
قراءة سريعة في الحقبة الشيراكية المنصرمة
غادر الرئيس شيراك قصر الإليزيه بعد إقامة فيه دامت إثني عشر عاماً هي عمر ولايتين رئاسيتين، واحدة امتدت سبع سنوات قبل أن يتم تعديل الدستور فتُقصَّر ولاية رئيس الجمهورية الفرنسية إلى خمس سنوات قابلة للتجديد (2). لكن شيراك لم يفلت من «سندروم» السنة العاشرة الذي ضرب قبله شارل ديغول وفرنسوا ميتران. ففي سنة حكمه العاشرة أضرب الطلاب في وجه الجنرال الذي اضطر إلى الاستقالة ومغادرة الحياة السياسية. أما ميتران فتجمَّعت الفضائح حوله من كل الأنواع والأجناس في سنة حكمه العاشرة لتصيبه بالعزلة والوهن على الرغم من عناده وتمسكه بالسلطة حتى الرمق الأخير. وكانت هذه حال شيراك الذي قرَّر عدم الاحتفال بمناسبة مرور عقد على مكوثه في الإليزيه في وقت راحت تعاني شعبيته التراجع المتسارع. إنه «سندروم السنة العاشرة» الذي كان على الأرجح وراء فكرة تقصير ولاية الرئيس(3).
كان من الطبيعي ألا يترشَّح الرجل لولاية ثالثة، وأن يتوجَّه إلى الفرنسيين مودعاً وواعداً بأن ثمة وسائل كثيرة لخدمتهم خارج الإليزيه(4) بعد أربعين عاماً قضاها في العمل السياسي منذ انتخابه نائباً عن مدينة «كوريز» في 12 آذار/مارس 1967، مروراً بالحقائب الوزارية العديدة التي تسلَّمها، ورئاسة الوزراء في عهود الرؤساء الأربعة الذين سبقوه في الجمهورية الخامسة، من ديغول إلى ميتران(5). لكن الخروج من الإليزيه لا يعني بالضرورة خروجاً من الحياة السياسية أو الحقل العام. فبصفته رئيساً سابقاً للجمهورية سيكون شيراك عضواً في المجلس الدستوري، وصاحب خبرة ورأي مؤثر كما هي حال الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي، وعلى الرغم من تقدمه في السن، ما يزال فاعلاً في الحياة السياسة، بدليل ترؤسه للجنة الحكماء التي صاغت الدستور الأوروبي المشترك.
وعلى غرار ميتران، وصل شيراك إلى السلطة مع الوعد برأب «الشرخ الاجتماعي»، ليرحل عنها وقد غدا هذا الشرخ أكثر عمقًا واتساعًا. لكن ولايته الأولى عكّرت صفوها خمس سنوات من «المساكنة» مع رئيس وزراء اشتراكي هو ليونيل جوسبان. هكذا ردَّت بضاعة شيراك اليه، إذ انه أول من افتتح ما سمّي وقتها بالمساكنة أو التعايش عندما أضحى، العام 1986، رئيساً للوزراء في عهد الاشتراكي ميتران.
صداقته مع رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري، ووفاؤه له بعد اغتياله، جلبا له الانتقادات والاتهامات في بعض الأوساط بأنه عمل على شخصنة السياسة وتسييس العواطف. وأخذ عليه البعض انقلابه المفاجىء على سوريا والتحاقه بالركب الأميركي، لا سيما بعد صدور القرار الدولي الرقم 1559. وإذا كان مؤيدوه لا ينكرون تطلعاته الدائمة إلى علاقات شخصية جيدة مع الآخرين، إلا انه، في رأيهم، لم ينقلب على سوريا ولم يلتحق ببوش قطّ. جلّ ما فعله أنه أعاد العلاقة الفرنسية-السورية (الحارة في عهده) إلى ما كانت عليه على الدوام (تراوح بين الفتور والقطيعة والعادية) بعد ان يئس من تعاون دمشق معه على الرغم من كل الخدمات التي قدَّمها لها بإيعاز من الرئيس الحريري. أما بالنسبة إلى الموقف من واشنطن، فلم تتوقف انتقاداته لها وإداناته لسياساتها الأحادية على الرغم من بعض التنسيق إزاء المسألة اللبنانية. وكانت سياساته العربية ومواقفه من الصراع العربي - الإسرائيلي قد دفعت اللوبي الصهيوني في فرنسا إلى اتهامه بالتحيّز للعرب وحتى بمعاداة السامية، ذلك أن أول سفر له إلى الخارج بعيْد انتخابه العام 1995 كان إلى القاهرة حيث كشف عن سياسته الشرق - أوسطية الواقعة في الإطار الديغولي التقليدي. وفي زيارة له إلى القدس العام التالي لم يتردَّد في نهر الحراس الاسرائيليين المكلفين مرافقته والذين «تضايقوا» من الجموع الفلسطينية المرحبة به. وقد تعمقت علاقاته بعدد من الزعماء العرب لتتحوَّل إلى صداقات شخصية متينة جلبت له الكثير من الاتهامات بعد ان كان الرئيس الغربي الوحيد الذي يشارك في مراسم تشييع الرئيس حافظ الأسد في دمشق، الأمر الذي فتح ضده كل الأبواق الإعلامية والسياسية في باريس وواشنطن ومعظم العواصم الأوروبية. وكان هو الذي أعلن امام البرلمان اللبناني أن الوجود السوري في لبنان شرعي وباقٍ إلى حين العثور على حل شامل للصراع العربي - الإسرائيلي. وهو أيضاً الذي فتح أمام الرئيس السوري بشَّار الأسد، ليس أبواب الإليزيه وحسب، بل أيضاً أبواب كل العواصم الأوروبية قبل أن تنقلب بينهما الأحوال.
العام 2004 رفض شيراك استقبال شارون في الإليزيه واعتبره شخصاً غير مرغوب فيه، قبل أن تجبره الضغوط على استقباله في تموز/يوليو العام 2005 تشجيعاً له على الانسحاب من غزة. وإذا كان صحيحاً أنه عجز عن إدخال تغيير في المعادلة القائمة في المنطقة، فذلك لأن حجم الضغوط الداخلية والأوروبية والأميركية عليه كان أكبر من أن يتغلَّب عليها أيّ رئيس فرنسي مهما كان قوياً.
العام 1998 ارتكب شيراك خطأ جسيماً سيترك آثاراً سلبية على ولايته الرئاسية الأولى برمتها، إذ قام بحل البرلمان طمعاً في الحصول على أغلبية تشريعية مريحة. لكن النتيجة جاءت عكس المتوخى. فقد خسر اليمين 225 مقعداً من الجمعية الوطنية التي «اجتاحها» اليسار الاشتراكي، ففرض زعيمه ليونيل جوسبان رئيساً للحكومة. وبقي هذا الأخير في منصبه خمس سنوات كاد في نهايتها أن يفوز برئاسة الجمهورية. وقد رجّحت استطلاعات الرأي فوز جوسبان في انتخابات الرئاسة العام 2002، لكن أصوات الناخبين توزَّعت بين مرشحي «اليسار المتعدد» في الدورة الأولى التي انتهت بمفاجأة مدوّية: لم يحصل جوسبان على عدد كافٍ من الأصوات يؤهله خوض المعركة في الدورة الثانية التي تأهل لها الرئيس المرشح شيراك في وجه زعيم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة جان-ماري لوبان.
لا يشعر الرئيس شيراك بالفخر لأنه حصد 82 في الماية من الأصوات في هذه الانتخابات، وهو الرقم الأعلى في التاريخ الفرنسي. فقد حاز أقل من عشرين في الماية في الدورة الأولى، ثم إن الجميع، بمن فيهم ألدّ أعدائه السياسيين،استنفروا للتصويت له في الدورة الثانية، فقط لقطع طريق الإليزيه أمام اليمين المتطرف. وقد تحقق شيراك وقتها، وبالعين المجردة، كم أنه فشل في وعده الانتخابي العام 1995 بالقضاء على ظاهرة اليمين المتطرف(6).
إشترك الرئيس اليميني شيراك مع سلفه اليساري ميتران في أمور كثيرة. فقد كان لديهما إرادة صلبة للدفاع عن البناء الأوروبي، ميتران ساهم في صياغة معاهدة ماستريخت، وشيراك في تطبيقها وتحقيق إنجازاتها وأهمها اليورو. الرجلان دافعا بشراسة عن دور فرنسا في حماية حقوق الإنسان ودعم بلدان العالم الثالث، وعن حضور فرنسا العالمي والأوروبي، وعن العلاقة الفريدة مع الجار الألماني. وحتى في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لم تقف الأيديولوجيا حائلاً دون ممارسة السياسات نفسها أحيانًا والتعلق نفسه بـ«النموذج الاجتماعي الفرنسي» في وجه العولمة الليبرالية المتنامية. وعانى الرجلان فضائح الفساد في عهديهما، لكن يبدو أن الفرنسيين يرون أن النظام هو المسؤول عن الفساد، وليس الأشخاص، بمن فيهم رؤساء الجمهورية. والرجلان وعدا بمكافحة التفاوت الطبقي والشرخ الاجتماعي وصعود اليمين المتطرف، وفشلا في تحقيق الوعد.
وإذا كانت المساكنة مع رئيس الوزراء جوسبان قد حدَّت من قدرة شيراك على تحقيق ما يبتغيه في الداخل، إلا أنها لم تحدّ من قدراته على ممارسة السياسة الخارجية المنوطة بالرئيس بحسب الدستور الفرنسي. في هذا المضمار لمع نجم الرئيس شيراك مناهضاً لصدام الحضارات والحرب على العراق والأحادية الأميركية، حاملاً لواء التعددية القطبية، والدفاع عن البيئة، والتقارب بين الشمال والجنوب، والتقدم التكنولوجي للصالح الإنساني العام، وأوروبا القوية الموحدة، وقيم الجمهورية الفرنسية. في البوسنة-الهرسك وكوسوفو كان دوره أساسياً في وقف المجازر الإتنية، وساهم في التأثير على كلينتون قبل أن يقنع الرئيس بوش الإبن (في قمم أيرلندا وسي-آيلند واسطنبول) بالتخلي عن الأحادية، ولو ظاهرياً، بعد فشله في العراق. ومنذ العام 1995 كان الرئيس الذي فهم قبل الجميع أن تقدم الأمن الجماعي بالقوة المعطاة للحق أضحى، بالنسبة إلى البشرية، مسألة حياة أو موت.
كان العام 2005 الأسوأ في حياة شيراك على الاطلاق. ففي 14 شباط/فبراير منه فقد صديقه العزيز رفيق الحريري اغتيالاً وبطريقة بشعة في بيروت. بعدها أجبر وزير الاقتصاد الموالي له إيرفيه غيمار على الاستقالة تحت وطأة فضيحة مالية. ثم أصيب بجلطة دماغية فتحت تكهنات في الساحة العامة عن إمكان استمراره في الحكم. وفي نهاية أيار/مايو حلّت كارثة الاستفتاء السلبي على الدستور الأوروبي المشترك، الأمر الذي أضعف من مكانة شيراك في فرنسا، ومكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، ومكانة هذا الاتحاد على المستوى العالمي. لقد أُخِذَ على شيراك تهوره، وعرضه الدستور المشترك على الاستفتاء الشعبي قبل تأكده من اقتناع الشعب به. ثم جاءت انتفاضة الضواحي رداً على وصف وزير الداخلية ساركوزي لسكانها بالحثالة والأوباش، لتنهي عاماً سيئاً تخطّت نسبة البطالة فيه عتبة العشرة في الماية بعد أن كان شيراك قد وعد بمكافحتها.
العام 2006 حمل بعض الآمال إذ أن رئيس الوزراء الشاب الجديد دومينيك دوفيلبان كان قد لمع في العالم وزيراً للخارجية، ما يجعل منه خليفة محتملاً للرئيس شيراك إذا نجح في تحقيق الوعد بخفض البطالة. لكن فضيحة «كليرستريم»، التي مثل بسببها دوفيلبان بصفة شاهد أمام القضاء حيث حاول زج اسم خصمه وزير الداخلية ساركوزي، أضعفته قبل أن يفشل في فرض قانون «عقد التوظيف الأول» الذي وقفت في وجهه النقابات فأعلنت الإضراب عن العمل وحشدت المظاهرات الصاخبة. وقد فشل دوفيلبان واستفاد ساركوزي من فشله فبات المرشح اليميني الأقوى لخلافة رئيسه اللدود شيراك(7).
في كل الأحوال ترك شيراك بصمات قوية في الساحتين الداخلية والخارجية، وهو أخلى سدّة الرئاسة ببعض المرارة، لكن فترة رئاسته كانت، على الأرجح، صفحة تاريخية هامة، ليس بالنسبة إلى فرنسا وأوروبا وحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى العلاقات الدولية المعاصرة. لقد طُويت معه مرحلة الرئيس - الملك في فرنسا لأن من يخلفه سيكون مضطراً، بسبب صغر سنه وقلة خبرته، إلى أن يكون أكثر حرصاً على إرضاء الرأي العام، وقد تنتهي معه الجمهورية الخامسة حيث أن الانتقال إلى الجمهورية السادسة احتل حيزاً واسعاً في النقاش خلال المعركة الانتخابية(8).
من مفارقات المعركة الانتخابية
كشف رفض الشعب الفرنسي الدستور الأوروبي المشترك لدى الاستفتاء عليه في أيار/مايو 2004 عن هواجس حقيقية تعتري الفرنسيين ازاء مستقبل بلادهم وهويتهم الوطنية، ونموذجهم الاجتماعي، والمكتسبات التي حققتها طبقاتهم العمالية والفلاحية طوال العقود المنصرمة، وذلك إزاء عولمة تهب رياحها العاصفة على أوروبا المتوسعة إلى الشرق والجنوب(9). وقد فشلت حكومة دوفيلبان في تقديم الإجابات المقنعة على مثل هذه التحديَّات، فخسر دوفيلبان مستقبله السياسي وقدرته على خوض غمار المعركة الرئاسية.
وأفاد وزير الداخلية نيكولا ساركوزي كثيراً من إخفاق رئيسه وعدوه اللدود دوفيلبان، كما سبق وأفاد من كل شيء في صعوده السريع من عمدة بلدية نيللي سور - سان إلى مركز «الشرطي الأول»، مروراً بالنيابة وصولاً إلى رئاسة حزب «تجمّع الحركة الشعبية» الذي رشحه بقوة لخلافة الرئيس شيراك. وقد اضطر الأخير، بعد تردد طويل، إلى الإعلان بأنه «بطبيعة الحال» يدعم رئيس الحزب ساركوزي(10)، على الرغم من أن هذا الأخير جعل من القطيعة مع الحقبة الشيراكية شعاراً لحملته الانتخابية.
في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل 2007 توجَّه الناخبون الفرنسيون للتصويت لأحد المرشحين الإثني عشر للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. لكن ثلاثة فقط من هؤلاء كانوا يملكون حظوظاً حقيقية للوصول إلى الإليزيه في الدورة الثانية(11)، وهم:
- نيكولا ساركوزي الملقَّب بـ «ساركو»(52 عاماً) المعروف بطموحه المفرط، وحيويته الهائلة، وقدرته على تسلق الجبال السياسية الوعرة، والذي يدعو إلى «تغيير هادىء» يقود إلى «تبدل عميق» يكون مثل «قطيعة» مع الممارسات السياسية السائدة في الإليزيه. وهو التزم ألاّ تتخطَّى نسبة البطالة الخمسة في الماية في نهاية ولايته الأولى إذا انتخب رئيساً للبلاد، كما تعهَّد خفضًا قويًا للضرائب، وممارسة الصدق والشفافية في السعي إلى ابتكار نموذج فرنسي جديد يقوم على قيمة العمل والابتكار (12). إتهمه خصومه بالانتهازية والفساد والكذب، وبأنه يجسد «الكابوس الأميركي» لأنه من أشد المعجبين بالولايات المتحدة والمقربين من سياساتها الأخيرة. وقد انتقد علانية سياسة شيراك المناهضة للاحتلال الاميركي للعراق، كما فاخر بأطلسيته وتأييده لإسرائيل. وبالمناسبة فإن اللوبي الفرنسي المؤيد لإسرائيل أعلن تبنِّيه الكامل للمرشح ساركو(13). وفي المقابل، تسبَّب هذا الأخير، ومن موقعه كوزير للداخلية، بانتفاضة الضواحي الباريسية الشهيرة في العام الماضي بعد وصفه لسكانها بـ «الحثالة والأوباش»، ما استنفر المهاجرين من أصول عربية للتصويت ضده في الانتخابات.
- سيغولين رويال (53 عامًا) مرشحة الحزب الاشتراكي التي لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى خوض معركة انتخابات رئاسية عن هذا الحزب الذي يضم الكثير من الشخصيات المخضرمة ذات التجربة القديمة في الممارسة السياسية والحزبية. حاولت الإفادة من كونها امرأة جميلة وأنيقة فرفعت شعار «فرنسا رئيسة» أي أن لفظة فرنسا هي في صيغة المؤنث، ومن الطبيعي ان ترئسها إمرأة هي زوجة (لرئيس الحزب فرنسوا هولاند) وأم لأربعة أولاد. لذلك كلما توجَّهت إلى الناخبين كانت تذكِّرهم بأنها تنظر إليهم نظرة الأم الحنون التي تعرف همومهم وتفهمهم، وستبذل الجهود لمساعدتهم، ولمحاربة العنف ضد النساء، ولمواجهة سوء معاملة الأطفال. كذلك دعت إلى «الديمقراطية التشاركية» التي تقضي بتشكيل لجان من الأهالي لمراقبة عمل المنتخَبين. وقد أخذ عليها خصومها افتقادها الخبرة والتجربة على الرغم من أنها كانت في البدء مستشارة للرئيس ميتران بعد تخرجها من المدرسة العليا للإدارة (إينا) التي يتخرَّج منها عادة كبار المسؤولين الفرنسيين، قبل أن تدخل إلى البرلمان، وتتبوَّأ حقائب البيئة والتعليم المدرسي والعائلة والطفولة. ولو نجحت في الانتخابات لكانت أول امراة تحكم فرنسا في التاريخ المعاصر.
- فرانسوا بايرو (55عامًا) مرشح الوسط، وهو الآخر فاجأ الجميع بوصوله إلى هذا الموقع المتقدم في الصراع على الإليزيه. في البدء، لم تكن استطلاعات الرأي تعطيه أكثر من عشرة في الماية من الأصوات، ربما بسبب ضعف حزبه (الإتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية) الذي انصرفت عنه إلى الحزب الحاكم شخصيات كبيرة مثل رئيس الوزراء الأسبق جان - بيار رافاران، ووزير الخارجية الحالي فيليب دوست - بلازي. ولأنه تسبَّب بإضرابات طلابية عاصفة عندما كان وزيراً للتربية العام 1994، فقد أثّر ذلك على مكانته السياسية، لكن خطبه في الأسابيع الأولى للمعركة الانتخابية دفعته إلى المركز الثالث، وربما الثاني بحسب استطلاعات الرأي. وعلى غرار المرشحين الآخرين فقد وعد بايرو بالتغيير وبإحداث «ثورة سلمية» تكسر الشرخ القائم بين اليمين واليسار عبر برنامج هو خليط من أفكار اليسار واليمين والوسط يعمل على تطبيقه «نساء ورجال ذوو كفاءة وشجاعة من المعسكرين» بعد إغلاق مدرسة «إينا» النخبوية البورجوازية، واستبدالها بمعهد عالي المستوى مفتوح على كل الكفاءات (14) . فاخر بايرو بأصوله الفلاحية، وبكونه يقود جراراً زراعياً عندما يذهب إلى قريته، وبأنه كاثوليكي مؤمن يرتاد الكنيسة بانتظام على الرغم من أنه من أشد الحريصين على الفصل بين السياسة والدين. أخذ عليه خصومه ضبابيته وعدم وضوح برنامجه وسعيه المحموم لاكتساب الأصوات من اليمين واليسار، الأمر الذي يقود في حال فوزه إلى رئاسة مربكة ومشلولة هي عكس التغيير «الثوري» الموعود(15).
يبقى المرشح اليميني المتطرف جان-ماري لوبان الذي، وإن وصل إلى الدورة الثانية، فإن حظوظه في اعتلاء سدّة الرئاسة كانت ستبقى معدومة لأن الأصوات كانت ستذهب عندها إلى خصمه أياً كان هذا الخصم كما بيَّنت التجربة في انتخابات العام 2002، وقتها، وخلافًا لكل التوقعات، وصل لوبان إلى الدورة الثانية في مواجهة جاك شيراك، على حساب المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان الذي كان متقدمًا على الجميع في استطلاعات الرأي. واضطرت كل الأحزاب المتخاصمة في ما بينها إلى استنفار قواها لدعم شيراك منعاً لاحتمال فوز لوبان، فكان أن حصل شيراك على ثمانين في الماية من الأصوات للمرة الأولى في التاريخ الفرنسي.
المفارقة هذه المرة أن وصول فرنسوا بايرو إلى الدورة الثانية كان سيجعل منه رئيساً متوجاً لأنه، بالإضافة إلى أصوات ناخبيه، كان سيحصل عندها على أصوات اليسار في حال كانت المواجهة مع ساركو، وعلى أصوات اليمين في حال كانت هذه المواجهة مع رويال.
مفارقة أخرى في هذه الانتخابات هي النسبة الهزيلة من الأصوات التي توقَّع أن يحصل عليها حزب المدافعين عن البيئة، على الرغم من الأهمية التي يوليها الفرنسيون للبيئة. «المفارقة الخضراء» سببها، ليس افتقار حزب الخضر إلى قائد مقنع، إذ أن مرشحتهم دومينيك فوينيه وزيرة البيئة السابقة، التي توقَّعت لها استطلاعات الرأي ما بين الواحد والإثنين في الماية من الأصوات، ليست امرأة ضعيفة على الاطلاق. لكن السبب، على الأرجح، هو أن كل المرشحين الآخرين وضعوا البيئة في رأس أولوياتهم إلى جانب أولويات أخرى في مجالات تهم الفرنسيين الذين ما زالوا ينظرون إلى الخضر كما لو أنهم مجرد جمعية أو منظمة لا ترقى إلى مستوى المسؤوليات الرئاسية الكبرى(16).
ودوماً في مجال المفارقات، يلاحظ المراقب للانتخابات الفرنسية الحالية افتقارها للنقاش السياسي الحقيقي، ليس، وحسب، بسبب غياب المواجهات المتلفزة المعتادة بين المرشحين، ولكن لأسباب عديدة أخرى. فثمة غياب للفروقات الأيديولوجية الواضحة في خطاب المرشحين الذين استعاروا الشعارات بعضهم من البعض الآخر (التغيير والهوية الوطنية، والموقف من العولمة، وإصلاح المؤسسات وغيرها). رويال شبّهت نفسها بجان - دارك على ما اعتاد فعله زعيم اليمين المتطرف المعروف بكراهيته للعرب والمهاجرين، والذي لم يتردَّد في الذهاب بنفسه إلى ضاحية «أرجانتاي» التي يسكنها هؤلاء ليقول لهم إنهم فرنسيون بالكامل، منتقداً وصف وزير الداخلية ساركوزي لهم بالحثالة والأوباش. وهو نفسه استحضر معارك فرنسا التاريخية ضد الممالك الأوروبية في مديحه لروح الجمهورية. رويال طلبت من مؤيديها في المهرجانات الانتخابية إنشاد النشيد الوطني ورفع العلم الثلاثي الألوان على شبابيكهم في الأعياد الوطنية. ساركوزي تكلَّم بافتخار عن زعماء فرنسا التاريخيين من جان جوريس وليون بلوم إلى جول فيري وجورج ماندل، وهم يساريون، من دون أن ينسى كليمنصو وديغول، متوجهاً إلى العمال والفلاحين والفقراء والمهمَّشين، في حين أن بايرو قدَّم نفسه كمرشح للشعب آتٍ من صفوف المزارعين ومستحضراً مآثر الملك هنري الرابع(17).
في المحصلة الكل تكلَّم عن الشعب والأمة والهوية الوطنية وروح الجمهورية والأمجاد الفرنسية والتاريخ المجيد(18)، وكل ذلك بهدف طمأنة الفرنسيين حيال العولمة والمهاجرين وتوسع الاتحاد الأوروبي. الناخبون باتوا يدركون أن الوعود هي لزوم الحملات الانتخابية ليس إلاّ، لذلك لم يبدوا كبير اهتمام بالمعركة، بدليل أن نصفهم لم يقرر ما إذا كان سوف يشارك في التصويت أم لا، ولمن يصوّت في حال المشاركة، وذلك قبل أيام معدودة من الاقتراع(19) الذي كان معروفاً ان الفوز فيه سيكون على الأرجح لمن يمتلك القدرة على إغراء المتردِّدين، وليس إقناعهم بالضرورة.
معركة ما بين الدورتين
سجَّلت الديمقراطية الفرنسية انتصاراً على نفسها وعلى متطرفيها في الدورة الأولى. فبعد أن اقتنع المحلِّلون بأن طلاقاً نهائياً قد حصل بين الفرنسيين والسياسة منذ عقود شهدت تراجعاً مستمراً لنسبة المشاركين في الاقتراع، جاءت هذه الانتخابات لتنفي هذه القناعة(20)إذ بلغت نسبة هؤلاء 85 في الماية للمرة الأولى منذ العام 1965(21). وللمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً يتراجع اليمين المتطرف بزعامة جان - ماري لوبان الذي ينهي حياته السياسية بخسارة مليون صوت (من أصل 000,800,4) عن العام 2002 عندما نافس جاك شيراك في الدورة الثانية. وللمرة الأولى في الجمهورية الخامسة، لا يكون بين المرشحين للإليزيه رئيس سابق للجمهورية، أو رئيس سابق للوزراء أو للنواب، أو عضو في الحكومة التي تشرف على الانتخاب. وللمرة الأولى أيضاً يخوض المرشحان المتنافسان معركة الرئاسة للمرة الأولى في حياتهما، من دون أن ننسى أن أحدهما امرأة، وهذا بدوره يحصل للمرة الأولى في فرنسا. وللمرة الأولى يكون الرئيس الفرنسي في الثانية أو الثالثة والخمسين من العمر فقط، أي الأصغر سناً في تاريخ فرنسا المعاصر.
كذلك، فإنها المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً التي يحصل فيها المرشحان الفائزان على هذه النسبة المرتفعة (94,56 في الماية) من الأصوات (العام 2002 حصل كلّ من المرشحين الأوائل الثلاثة على نسبة 9,42 في الماية من الأصوات)، وللمرة الأولى منذ عشرين عاماً يبتعد عنهما الذي وصل إلى المرتبة الثالثة بهذا الفارق من الأصوات (5,18 في الماية لبايرو في مقابل 11,31 لساركوزي و83,25 لرويال). وللمرة الأولى لا يتخطَّى أي من المرشحين «الصغار» التسعة عتبة الخمسة في الماية. وللمرة الأولى يمسك مرشح مهزوم، هو مرشح الوسط فرنسوا بايرو، بمفاتيح الإليزيه فيغدو المنتصر الحقيقي، ذلك أن الأصوات كانت سترجِّح كفة المرشح الذي ستصب لمصلحته في الدورة الثانية. وقد بدأ الصراع عليها منذ صدور النتائج كذا السباق على مغازلة بايرو وإغرائه هو الذي أعلن عن نيته تشكيل حزب جديد هو «الحزب الديمقراطي» الذي يود إحداث تغيير عميق في المشهد السياسي والحزبي القائم والمنقسم بين يمين ويسار.
هزيمة بايرو تعني أن الفرنسيين ما زالوا يركنون إلى الثنائية - الحزبية على الرغم من أنهم أعطوا للوسط هذه المرة ما لم يعطوه له العام 2002 عندما جاهد ليتخطَّى عتبة الخمسة في الماية من الأصوات. لكن المفارقة أن المعركة النهائية دارت رحاها في الدورة الثانية حول أفكار الوسط وطروحاته طمعاً في أصواته بعد أن تم دحر الأحزاب المتطرفة يساراً ويميناً(22).
لكن هذا لا يخفي حقيقة أن ساركوزي قد تمكن من حصد هذه النسبة الأعلى لمرشح يميني منذ العام 1974 (وقتها حصل فاليري جيسكار - ديستان على 6,32 في الماية)، لأنه عرف كيف يصطاد في مياه هذا اليمين المتطرِّف العكرة، إلى درجة أن لوبان اتهمه بأنه يسرق أفكاره ولا سيما المتعلق منها بالهوية الوطنية والهجرة، مع الوعد بإنشاء وزارة خاصة بهذا الشأن. أما من جهة اليسار فقد نجحت رويال في الارتقاء إلى مستوى «معلمها» فرنسوا ميتران العام 1981 عندما انتُخب رئيساً، بفضل «التصويت المفيد» الذي لجأ اليه الناخبون اليساريون المتوجِّسون من تبعثر أصواتهم كما حصل العام 2002 عندما خسر زعيم الحزب الاشتراكي ليونيل جوسبان منذ الدورة الأولى لمصلحة لوبان، في حين كانت استطلاعات الرأي ترجِّح وصوله إلى الإليزيه. يومها حصل مرشحو الأحزاب اليسارية الأخرى على نسب معقولة من الأصوات ذهبت من طريق جوسبان. هذه المرة، مثلاً، لم يتخطَّ كل من التروتسكيين والخضر وجوزيه بوفيه وحتى الحزب الشيوعي نفسه، الإثنين في الماية من الأصوات. وللتذكير فقط، كانت قوة الحزب الشيوعي في ثمانينيات القرن المنصرم تدور حول الخمس عشرة في الماية، ما جعله شريكاً أساسياً إلى جانب الحزب الاشتراكي في الانتخابات والحكم على السواء.
اليوم تغيَّرت الأوقات واختفى«اليسار المتعدد» كما كان يقول جوسبان أو «شعب اليسار» كما كان يحلو لميتران أن يردِّد. لذا كانت مهمة رويال شاقة بين الدورتين، وكان عليها التعويل كثيراً على الوسط الذي اقترحت التحالف معه، وليس على «خزان» ينضب من أصوات اليسار. لكن ساركوزي امتلك سلاحاً ماضياً في وجه بايرو إذ لم يتعاون معه، فقد هدَّد بأن يرشح «حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي يتزعَّمه، مرشحين في كل دوائر حزب الوسط في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، الأمر الذي من شأنه أن يصيب بايرو بهزائم في عدد كبير من الدوائر الانتخابية. ولم يكن بمستطاع بايرو أن يفك تحالفاً انتخابياً قائماً منذ عقود طويلة لمصلحة مرشحة اشتراكية قد تعجز عن هزيمة ساركوزي. وجل ما كان يطلبه هذا الأخير، الواثق من قدرته على الاستحواذ على أصوات الوسط، أن يبقى بايرو على الحياد طمعاً ربما بتحسين حظوظه كمرشح لرئاسة الوزراء. في هذه الحال، اختارت رويال الاستمرار في حملتها تحت شعار «كل شيء ما عدا ساركوزي» الذي لا يبعث بالثقة في نفوس الفرنسيين الذين ربما صوّتوا له لمجرد تسجيل الاحتجاج وليس بالضرورة رغبة منهم في رؤيته يسكن الإليزيه. لكن هذا ما لا تقوله استطلاعات الرأي التي بقيت تعتبره الأوفر حظاً في الدورة الثانية. وبالمناسبة فإن استطلاعات الرأي أظهرت صدقية مرتفعة إذ أن معظم توقعاتها تحقق بشكل ملفت.
في الأسبوعين الفاصلين بين الدورتين الأولى والثانية من السباق إلى الإليزيه، اتجه اليميني ساركوزي إلى اليسار في طروحاته ووعوده، في حين استدارت اليسارية رويال إلى اليمين (23)، فالتقيا في الوسط. هذه هي الديمقراطية التي تنتصر على المتطرفين لأن الفوز في سباقها يجبر المرشحين على رفع شعارات الوحدة والتجمع والتضامن وحماية الضعفاء ومساعدة الفقراء وما شابه. هذا على الرغم من أن التجربة لا تنفك تثبت أن الوعود الانتخابية شيء وممارسة السلطة شيء آخر. لكنها قواعد اللعبة.
السياسة الخارجية في المعركة الانتخابية
تفيد استطلاعات الرأي في الدول الكبرى أن السياسة الخارجية تقبع في آخر سلم أولويات المواطنين. فالشعب الإنكليزي الذي عارض، في جلِّه، سياسات بلير الخارجية، ولا سيما حربه على العراق والتحاقه بالرئيس بوش، عاد وانتخبه للمرة الثالثة العام 2005، مكافأة له على إنجازاته في الداخل. وقد نجح بوش في التجديد لولاية ثانية بسبب تمكنه من إقناع الناخبين بأولوية الحرب على الارهاب وضرورة مكافحته،انطلاقاً من أفغانستان والعراق، حتى لا يضرب في الداخل الأميركي كما حصل في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وأدار الناخبون الإسبان ظهرهم لرئيس وزرائهم أزنار بسبب فشله في التعامل مع الارهاب الذي ضرب مدريد في آذار/مارس 2004.
أما الغياب النسبي للمسائل الدولية عن النقاش في المعركة الانتخابية الفرنسية، فلم يكن أمراً غريباً أو جديداً. فمنذ انتخابات العام 1965 الرئاسية بات التشديد على هموم الداخل تقليداً راسخاً. هذا على الرغم من العولمة والتقدم الهائل في وسائل الاعلام والاتصال ما جعل من الرأي العام لاعباً أساسياً على بيّنة وتفاعل مع الشأن الدولي الذي أضحى في صلب الوظائف الحكومية. ويتفق علماء السياسة على أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، ما يعني أن تغييب السياسة الخارجية عن النقاش الانتخابي يذهب في عكس اتجاه اللعبة الديمقراطية الصحيحة.
وفي ذروة صعود الإتحاد الأوروبي وتوسعه، هل من المعقول ألاّ يحتل الموضوع الأوروبي مركز الصدارة في المعركة الانتخابية؟ الواقع أن هذا هو ما جرى، وسببه أن كل الأحزاب الفرنسية تقريباً منقسمة على نفسها في رؤية المستقبل الأوروبي ما عدا مرشح الوسط فرنسوا بايرو، ولذا لم يجازف المرشحون الآخرون بالاستثمار في هذا المجال. مرشح اليمين الحاكم نيكولا ساركوزي اقترح صياغة دستور مختصر (نصف دستور أوروبي مشترك) لاستفتاء الشعب حوله، في حين أن مرشحة الحزب الاشتراكي سيغولين رويال خاضت في كلام غامض حول أوروبا التي ينبغي ان تكون أقل ليبرالية وأكثر اجتماعية(24).
كلام ساركوزي المتكرر عن القطيعة مع الماضي تضمن تغييراً أساسياً في السياسة الخارجية. أطلسيته ودعمه الواضح لاسرائيل ووصفه حزب الله وحماس بالإرهاب ودعمه لحرب أميركا على العراق وغير ذلك... يشكل قطيعة مع الديغولية، بما فيها عهدي ميتران وشيراك، أي مع سياسة خارجية فرنسية مستقلة إلى حد كبير عن الحليف الأميركي(25). لكن«الكابوس الأميركي» كما يصفه خصومه، لن يكون حراً في إحداث مثل هذه القطيعة. المقرَّبون منه ليسوا أطلسيين إلى هذه الدرجة، ولابد أن الـ «كي دورسيه» (وزارة الخارجية) والجهاز الأمني والعسكري وجهاز الادارة العامة العليا ستكون له بالمرصاد. وإزاء ضعف التحالف الحكومي الذي تتزعمه أنجيلا مركيل في ألمانيا، وبعد رحيل أزنار وبرلسكوني، وبفعل الضبابية التي باتت تغشو مستقبل البليرية في بريطانيا، فإن ساركوزي قد يغدو زعيم الأطلسية الأوروبية الجديدة المدعومة من بعض المنضوين الجدد في الاتحاد الأوروبي، مثل بولونيا وتشيكيا. لكنه سيكون مثل سابقيه محكوماً بسقف التقليد الخاص بالدبلوماسية الفرنسية، كما كان قبله فاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران اللذان عُرفا، لحظة انتخاب كلٍ منهما، بالانتماء إلى الأطلسية ما بعد الديغولية، وبالتاييد المفرط لإسرائيل، واللذان سرعان ما وجدا نفسيهما في إطار إرث ديغولي لم يحيدا عنه في سياساتهما الخارجية.
في اليسار لا أحد يدعو إلى إعادة تفعيل التضامن الغربي كما يفعل ساركوزي. لكن ينبغي ألاّ ننسى أن اليسار المعادي للأطلسية وحتى للولايات المتحدة لا يقوم على أساس متين كما هي حال التيار الديغولي في اليمين فهو منقسم على نفسه بين ماركسية تختفي رويداً رويداً، وديغولية مقاومة للأطلسة، وعالم - ثالثية يعوزها الوضوح، وجمهورية سيادية تنزع إلى الالتقاء مع بعض تيارات الديغولية-الجديدة. هذا التبعثر منع اليسار من انتاج سياسة خارجية جديدة متماسكة وواضحة. وقد دلَّ الاستفتاء على الدستور الأوروبي المشترك، في أيار/مايو 2004 على هذا التخبط(26).
بقي الشرق الأوسط، على الرغم من أهميته الحيوية وقربه الجغرافي، منطقة لا يجازف المرشحون بالسير في حقول ألغامها. وحده جوزيه بوفيه اعتمر الكوفية الفلسطينية وأعلن موقفاً لم يعطه أكثر من نسبة واحد في الماية من الأصوات على ما توقعت استطلاعات الرأي. ولم يحقق مفهوم «التهديد الإيراني» أيّ إجماع حوله، بدليل زلة لسان شيراك عندما قال إن القنبلة النووية الإيرانية الافتراضية لا تهدد أحداً ولا حتى إسرائيل. وقد نجح ساركوزي في إجهاض عزم شيراك على إيفاد مبعوثين للتفاوض مع طهران، فكشف عن موقف راديكالي متضامن مع واشنطن. لكن المرشحة الاشتراكية رويال بدت غير متمكنة من هذا الملف الذي لم تقدم أي رؤية للحل فيه، الأمر الذي عكسته التصريحات المتباينة لزعماء الحزب الاشتراكي في هذا المضمار. أما عن الصراع العربي - الإسرائيلي، فما عدا ساركوزي الذي جنح بعض الشيء في بعض المواقف، سعى الآخرون إلى تقديم «مقاربات أكثر توازناً». لقد تعرَّضت رويال إلى سيل من الانتقادات بسبب اجتماعها مع أحد نواب حزب الله في بيروت، فسارعت إلى تعويض ذلك برفض الاجتماع مع ممثلين لحماس في فلسطين. ومنذ جولتها الشرق - أوسطية الفاشلة، تفادت الخوض في الموضوع، فمارست لعبة اصطناعية وسطحية تبحث من خلالها عن أصوات عربية وتخشى فقدان أصوات يهودية، وكل ذلك على حساب رؤية دبلوماسية واضحة وبناءة قامت بالتضحية بها.
وما عدا قضية دارفور التي جمعت كل المرشحين تقريباً في دعمهم للتدخل الإنساني الجديد، سادت في هذه المعركة الانتخابية النزعة إلى القفز عن كل المواضيع الحساسة التي هي بطبيعتها أكثر تعقيداً، والتي سوف تدور حولها كل الدبلوماسية الفرنسية في الساحة الدولية. وتكمن المشكلة في أن الحملة الانتخابية، التي من المفروض فيها أن تفتح النقاش العام حول مسائل أساسية تهم الرأي العام المؤثر في انتاج علاقات دولية، راحت تقود، لأسباب تتعلق بالماركتنغ الانتخابي والسعي وراء الأصوات، إلى إغلاق هذا النقاش الذي من دونه ليس من لعبة ديمقراطية حقيقية.
وإذا أردنا أن نعثر على نقاش حقيقي في هذه الانتخابات، فقد نجده في تلك الهوة ما بين الواقعية السياسية التي يجسدها ساركوزي، ونوع من المثالية التي يتفق حولها مرشحا اليسار والوسط رويال وبايرو(27). فساركوزي شدَّد على مفاهيم القوة والمصالح الوطنية والتحالفات والإدارة التقليدية للنزاعات، في حين أن رويال وبايرو ركَّزا على السياسات الأخلاقية والاجتماعية مع المحافظة على البيئة والعدالة الدولية، ومساعدة العالم - الثالث والإرث الإنساني المشترك والتعددية-القطبية. هنا، وحسب، قد نعثر على نقاش حقيقي، ولو في الحالة المضمرة بين خيارين أيديولوجيين حول السياسة الخارجية المزمع صياغتها بعد شيراك، مع القناعة بأنها، مهما حاولت، لن تتمكن من الابتعاد كثيراً في العمق عن الخطوط العريضة التي سبق ورسمها مؤسس الجمهورية الخامسة شارل ديغول.
هل تنجح الساركوزية في الحلول محل الديغولية - الجديدة؟
أخيراً، دخل نيكولا ساركوزي بقوة إلى قصر الإليزيه (أكثر من 53 في الماية من الأصوات، أي بتقدم واضح على رويال التي لم تتخطَّ الـ 47 في الماية) ليسكنه خمس سنوات قابلة للتجديد، بصفته الرئيس الثالث والعشرين للجمهورية الفرنسية، والسادس للجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال ديغول. حقق الرجل حلماً راوده منذ نعومة أظفاره وتأكد له إمكان تحقيقه عندما أضحى عمدة لبلدية نييلي - سير - سان القريبة من باريس، وهو لم يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، أي العمدة الأصغر سناً في تاريخ البلدات المهمة في فرنسا. وقتها سأله الصحافي المعروف دوهاميل ما إذا كان يفكر برئاسة الجمهورية في كل مرة يحلق ذقنه أمام المرآة فأجابه ساركوزي: «ليس فقط عندما أحلق ذقني». وفي مسيرته السياسية، القصيرة نسبياً، تمكَّن من سحق خصومه داخل حزبه واستفاد من أخطاء الجميع ومن هجومهم عليه، مبيناً قدرة فائقة على المناورة والمجادلة والتعاطي الذكي مع الإعلام.
يصفه المراقبون بأنه الرئيس الأكثر يمينية منذ خمسين عاماً، وبأنه «محافظ جديد» سيُدخل فرنسا في منعطف جديد، تماماً كما فعلت مرغريت تاتشر في بريطانيا، ورونالد ريغان في الولايات المتحدة، وخوسيه ماريا أزنار في إسبانيا، وسيلفيو برلسكوني في إيطاليا. وهو أعلن خلال حملته الانتخابية أنه لا يخجل أبداً من الانتماء إلى اليمين، لكنه يمين يريد أن يحدث قطيعة مع كل تلك الممارسات التي سادت في العهود السابقة من يمينية ويسارية على السواء، وإلى قيمة العمل التي ارتقى بها إلى مصاف القيمة المثالية الأعلى، وإلى الأمن الذي من دونه لا عمل ولا سياسة ولا من يحزنون. والذين وصفهم ساركوزي بـ «الحثالة» و«الأوباش» هم برأيه الذين يعكِّرون صفو الأمن ويعتدون على «الهوية الوطنية»، لذلك وعد باستحداث وزارة خاصة بـ «الهوية الوطنية والهجرة» قيل إنه سيكلف بها صديقه الفرنسي - الإسرائيلي أرنو كلارسفيلد الآتي لتوّه من إسرائيل حيث أدّى خدمته العسكرية في لواء حرس الحدود. إلا أن «الرئيس ساركوزي» عدل عن ذلك بمجرد أن دخل الإليزيه.
لقد جنح ساركوزي إلى اليمين مقترباً من أقصاه في بعض شعاراته الانتخابية، إلى درجة أن زعيم «الجبهة الوطنية» جان - ماري لوبان اتهمه بسرقة أفكاره وشعاراته، وزعيم اليمين النمسوي المتطرف يورغ هايدر علّق على فوزه في الانتخابات بالقول إنه تبنى برنامجه بالكامل. وسواء كان هذا القول صحيحاً أو مبالغاً فيه، فلا شك أن الجنوح المبالغ فيه إلى اليمين من قبل زعيم حزب حاكم هو أمر يحصل في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد هذه الحرب والمصالحة التاريخية بين فرنسا وألمانيا، ثم تشكيل «المجموعة الاقتصادية الأوروبية»، راح المشهد السياسي والحزبي في فرنسا يتجه تدريجًا وببطء صوب الوسط واليسار تحت تأثير من الديغولية التي عبّدت الطريق أمام انتخاب الاشتراكي فرنسوا ميتران العام 1981، أو جعلته على الأقل خليفة لليميني الوسطي فاليري - جيسكار ديستان. وفي الثمانينيات من القرن المنصرم، وبتأثير من الموجة اليسارية تحت حكم التحالف الاشتراكي - الشيوعي، اتجه اليمين أكثر فأكثر نحو الوسط، فأخلى مساحة في المشهد السياسي سرعان ما احتلها اليمين المتطرف بزعامة لوبان الذي راح يتقدم، مستفيداً من عجز اليسار عن تحقيق الوعود التي رفعته إلى السلطة.
لكن، وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة تدريجاً كما عبَّرت عنها مجموعة من عمليات الانتخاب التشريعية والرئاسية - وآخرها كان وصول لوبان إلى الدورة الثانية ضد شيراك العام 2002 - فقد بقي خطاب لوبان الموصوف بالعنصري والمتطرف والمعادي للسامية هدفاً لهجوم اليمين واليسار على حد سواء. وبقي هذا اليمين المتطرف بمثابة «التابو» الذي يأباه الجميع ويستحي أعتى غلاة اليمين الجمهوري من الإفادة من أصواته، ويستشيط غضباً من مجرد المقارنة به. فاليمين الفرنسي عموماً بقي يعاني عقدة وصفه بالمتعاون مع الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وبالبيتانية (نسبة إلى الماريشال بيتان). أما الجنرال ديغول - كما الحزب الشيوعي - فكان على رأس المقاومة التي انتصرت فحرَّرت فرنسا وأعادتها إلى مصاف الدول الكبرى في العالم. من هنا التمييز المقصود في الخطاب السياسي ما بين «الديغولية» واليمين، أو دمج المفردتين بقصد التحديد والإيضاح عند القول «اليمين الديغولي» الذي حارب الاحتلال الألماني والذي يفخر بتمايزه عن الحليف الأميركي وبسعيه لحماية «النموذج الفرنسي».
لكن هذا النموذج بدأ يتعرَّض للاهتزاز نتيجة الأزمات العديدة التي واجهته، ولا سيما مع تحولات النظام الدولي والعولمة، ومع تراكم الإخفاقات في كل المجالات الداخلية تقريباً. وبدأت الحاجة إلى خطاب جديد تفرض نفسها في صفوف الفرنسيين الذين، وإزاء إشكاليات العولمة وتوسيع أوروبا وارتفاع البطالة وانخفاض القوة الشرائية والهاجس الأمني واضطرابات الضواحي المهمشة ومشكلة الهجرة والمهاجرين وغيرها، عبّروا عن قلقهم في غير مناسبة أبرزها التصويت الاحتجاجي في الاقتراع العام، ورفض الدستور الأوروبي المشترك لدى الاستفتاء الشعبي عليه، على الرغم من أن، على رأس صائغيه، كان الرئيس الفرنسي الأسبق ديستان، وأنه قام أساساً بمبادرة فرنسية دعمتها ألمانيا.
ساركوزي تلقف الفرصة. لقد بات الخطاب اليميني المتشدد ممكناً. انكسر التابو، واليسار، المتخبِّط هو الآخر في نزاع داخلي مرير والعاجز عن العثور على خطاب عصري جامع مقنع، لم يعد قادراً على الاستمرار في ابتزاز اليمين بالعودة إلى البيتانية والفاشية وغيرها. رفع ساركوزي شعار اليمين المتخلِّص من عقده والمعتز «بتاريخ فرنسا وأمجادها وعظمتها»، هذا التاريخ الذي ينبغي التعاطي معه على أنه «كلٌ واحدٌ وليس مقاطعَ تناسبنا فنعتز بها، وأخرى نخجل بها فنرفضها»، على حد قول المرشح ساركو. وهو يعتبر أنه، لا هو ولا أنصاره والمحيطون به، كانوا قد ولدوا أو شاركوا في ما جرى خلال هذه الحرب، وبالتالي فلا مجال للاعتذار أو للشعور بالذنب. لكنه شدَّد أيضاً على أن انتقال فرنسا من وضعية البلد المحتل العام 1940 إلى موقع البلد المنتصر العام 1945 كان بفضل مساعدة الحلفاء وفي طليعتهم الولايات المتحدة، والتي لا يخفى إعجابه بها، على ما كتب مرة في جريدة «لوموند».
لكن ساركوزي ذهب بعيداً في اعترافه بفضل الولايات المتحدة، ولا سيما عندما ذهب إلى واشنطن ليقدم شبه اعتذار للرئيس بوش على مواقف شيراك من سياساته الدولية واحتلاله للعراق، وأفرط في أطلسيته المعلنة وفرنسيته المفرطة وهو ابن «المهاجر اليهودي من سالونيك» على ما وصفه الإسرائيليون الذين وضعوا صورته على طابع بريدي، بعدما قال موجهاً خطابه للمهاجرين (العرب والمسلمين تحديداً): «إما أن تحبّوا فرنسا أو أن تغادروها»، وبذلك فقد كسر عدداً من «التابوات» أو المحرّمات في الخطاب السياسي السائد، حتى في صفوف اليمين المبتعد عن الوسط، فوفَّر للاشتراكية سيغولين رويال أرضية للهجوم عليه والتحذير من عدم الاستقرار الذي قد يتسبَّب به إذا وصل إلى السلطة رئيسًا، وهذا ما قد بدأ يطل برأسه من خلال أعمال الشغب وحرق السيارات في الضواحي، والإضراب الذي أعلنه طلاب جامعة باريس الأولى غداة إعلان فوزه برئاسة الجمهورية.
لقد نجح المرشح ساركوزي في تخليص اليمين الفرنسي من عقدته التاريخية ودفعه إلى المزيد من اليمينية. لكن ساركوزي الرئيس سيكون مضطراً إلى الايفاء بوعد واحد من وعوده الانتخابية الكثيرة على الأقل، وهو أن يكون «الناطق باسم جميع الفرنسيين» وليس باسم أولئك الذين صوّتوا له وحسب. فمن بين هؤلاء من أعطاه صوتاً لمجرد الاحتجاج وليس إعجاباً بأفكاره وبرامجه، ثم إن اليسار، وعلى الرغم من كل مشاكله وتخبطه، نجح في الحصول على قدر لا يمكن الاستهانة به من أصوات الناخبين، بلغ أقل بقليل من النصف.
وتدل التجارب في كل الدول الديمقراطية الغربية على أن اليمين الحاكم الواثق من نفسه يقدم خدمة لليسار بدفعه إلى إصلاح نفسه ولمّ شمله قبل المبادرة إلى الهجوم والعودة إلى السلطة.
هل تقطع الساركوزية مع سياسة فرنسا الخارجية التقليدية؟
لم ينجح نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفضل برنامج أو أفكار أو وعود تقدَّم بها في مجال السياسة الخارجية الفرنسية. لقد كانت المفارقة البارزة في المعركة الانتخابية، بحسب كل المراقبين، هي غياب النقاش حول مثل هذه السياسة، لا سيما في بلد كبير مثل فرنسا يؤثر ويتأثر بمجريات الساحة الدولية، وفي زمن محت فيه العولمة الحدود والحواجز بين السياسات الداخلية والخارجية. لم يتطرَّق المرشحون إلا لماماً الى بعض المواضيع الدولية، ولا سيما تلك التي لا إحراج فيها وتلك التي يكون حولها إجماع، إلى حد كبير. وعلى الرغم من ذلك بقي المرشح اليميني نيكولا ساركوزي أوضحهم لجهة الانتماء الأيديولوجي غير الخجول إلى أطلسيته ويمينيته.
وفور إعلان نتيجة الانتخاب بدأت تتدفَّق رسائل التهنئة على الرئيس المنتخب من كل حدب وصوب. وإذا كان الأمر طبيعياً كما يقتضي البروتوكول بين الدول، إلا أنه لا يمكن إلا أن نميِّز بين تعابير التهنئة «العادية» أو الروتينية كما يقتضي العرف والتقليد، وتلك البرقيات الإحتفائية بالنصر الصادرة عن حلفاء الرئيس الجديد وأصدقائه، من أمثال بوش الإبن وبلير وبرلسكوني وأزنار وأولمرت وبنيامين نتنياهو المتفائل كثيراً بوصول «صديقه العزيز» إلى قصر الإليزيه ليأخذ مكان شيراك «صديق العرب». لقد أعرب ساركوزي عن تأييده الواضح لإسرائيل(28) التي زارها من دون أن يقوم بزيارة واحدة، لا إلى السلطة الفلسطينية ولا إلى أي بلد عربي ولو كان من حلف «المعتدلين». وأكثر من ذلك، فقد تلقى تأييد المنظمات والجمعيات الفرنسية الصهيونية كمرشح، وراهن على هذا التأييد، لكن من دون أن يدير ظهره لملايين الأصوات من ذوي الأصول العربية والمسلمة، إذ عيّن منهم مديرين لحملته الانتخابية واعداً بإشراكهم في الحكم، ولو أنه كان قد عادى سكان الضواحي من هؤلاء.
لقد نجح رهان الرجل الذي كان يحلم بالرئاسة منذ نعومة أظفاره، فوصل إلى مبتغاه (29) على ظهر وعود قاطعة بإحداث قطيعة جذرية مع كل السياسات التي كانت سائدة قبله والتي انتهجها اليمين واليسار على حد سواء. فهل ينجح الرجل في إحداث مثل هذه القطيعة في مجال السياسة الخارجية؟
لم يكن من قبيل المصادفة ابداً ان يكون أول سياسي أجنبي يستقبله الرئيس المنتخب وهو لمّا يتسلّم مهامه بعد، وبحضور الرئيس شيراك، هو سعد رفيق الحريري. وكانت الصورة الرمزية التي جمعت الثلاثة في قصر الإليزيه مفعمة بالمعاني، وفي طليعتها أنه في أحد الملفات الدولية البارزة - الملف اللبناني تحديداً مع تداعياته الإقليمية والدولية - سوف تكون سياسة الخلف استمراراً لسياسة السلف، ولو بوسائل ومفردات جديدة. وكان المرشح ساركوزي قد أكّد، في مقابلة نشرتها أسبوعيتا «الأسبوع العربي»(30). و«الماغازين» اللبنانيتان (والثانية ناطقة بالفرنسية)، عن تطابق سياسة ساركو اللبنانية مع تلك التي كان يقودها شيراك. وربما لهذا السبب حصل ساركوزي على سبعين في الماية من أصوات الفرنسيين من أصل لبناني بحسب تعليق المحللين الفرنسيين لنتيجة الانتخاب.
أما الموقف الثاني المشبع هو الآخر بالرمزية، والذي اتخذه ساركوزي فور تسلّمه السلطة، فهو مسارعته إلى زيارة برلين للقاء المستشارة أنجيلا ميركل والتأكيد على العلاقة المميزة بين البلدين والتي أرسى دعائمها الجنرال ديغول وباتت تقليداً راسخاً لدى باريس، بمعزل عمن يسكن قصر الإليزيه.
أما في خطابه لحظة إعلان فوزه(31) فهو وإن أكد على العلاقة المميزة مع الحليف الأميركي، لكنه حرص على التأكيد في المقابل على أن الأصدقاء يمكن لهم أن يختلفوا، وهذا موقف ديغولي. وفي الخطاب نفسه أعاد التأكيد على حرصه على أمن «إسرائيل» وسلامتها وحقها في الوجود، ألا أنه أضاف أن ذلك لا يقلل أبداً من قناعته بحق الفلسطينيين أيضاً في دولة حرة مستقلة، وبأن هذا الحلم يجب أن يتحقَّق. وإذا كان ساركوزي هو المرشح الوحيد الذي يعلن موقفاً واضحاً رافضاً إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه فعل ذلك لمعرفته بأن هذا هو موقف أكثر من سبعين في الماية من الفرنسيين. وكان شيراك قد عبّر عن القناعة بأن مثل هذا الانضمام ينبغي أن يُعرض على الاستفتاء الشعبي العام في فرنسا، وهو موقف يصب في رفض الانضمام التركي لكن بطريقة دبلوماسية وغير مباشرة. هنا أيضاً يستمر ساركوزي في ما نهجه شيراك ولو بأسلوب أكثر مباشرة في زمن التسابق على أصوات الناخبين.
لقد وصل الزعيم اليميني المتطرف جان - ماري لوبان إلى الدورة الثانية في مواجهة الرئيس شيراك في انتخابات العام 2002 على خلفية مآزق وأزمات اقتصادية واجتماعية تعانيها فرنسا. وقد تلقَّف ساركوزي الدرس سريعاً في سعي محموم لاكتساب المزيد من الأصوات من اليمين المتطرف، فقدَّم خطاباً قاطعاً واضحاً «لا خجل فيه» كما كان يردِّد. قال علناً ما كان يهمس به كثيرون في السر، ضد الارهاب والأصولية الإسلامية والمقاومة والهجرة والمهاجرين من لون معين ودين معين. لكنه كان «يضيف ماء إلى النبيذ الذي يقدمه»، كما يقول الفرنسيون، بقدر ما كان يقترب من عتبة الإليزيه. وهكذا مثلاً، بعد أن عاين ردود الفعل السلبية على مقاله المعجب بالأميركيين في جريدة «لوموند»، وزيارته البيت الأبيض مؤيداً الرئيس بوش ومنتقداً الموقف الفرنسي الرسمي منه، عاد ليركز على إعجابه بالنمط السياسي - الاجتماعي الداخلي في الولايات المتحدة، وليس سياستها الخارجية، ولا سيما احتلال العراق الذي أضحى خطأ ينبغي تصحيحه. ثم زار ضريح الجنرال ديغول مؤكداً على إعجابه بالرئيس الراحل ومحافظته على ميراثه لا سيما لجهة عظمة فرنسا ذات السياسة الخارجية المستقلة. ثم أعلن أنه سيكون ناطقاً باسم كل الشعب الفرنسي وليس وحسب باسم محازبيه أو مناصريه. باختصار، راح الرجل يقترب من السياسة الفرنسية التقليدية بقدر ما كان يقترب من الإليزيه، وعندما وصل إليه، اتخذ موقفين في السياسة الخارجية يقعان في صميم الاستمرارية بعيداً عن القطيعة الموعودة.
بعد يومين اثنين على تبوّئه الرئاسة، عيّن ساركوزي فرنسوا فيون، الذي كان يوصف بـ «الديغولي الاشتراكي المعتدل» رئيساً لحكومة ضمت خمسة عشر وزيراً، سبعة منهم من النساء - كما وعد - وفيهم من حزبي الوسط والاشتراكي (32). حقيبة العدل تسلمتها ذات الأصل المغربي رشيدة داتي، وهو ما يحصل للمرة الأولى في فرنسا، الأمر الذي دفع جان - ماري لوبان إلى شن حملة عليها بسبب حيازتها الجنسيتين الفرنسية والمغربية معاً. أما حقيبة الخارجية، فأوكلت إلى الطبيب اليساري المعروف بتأييده لمبدأ التدخل الانساني، برنار كوشنير، والذي سارع حزبه الاشتراكي إلى طرده بسبب قبوله العمل في حكومة ساركوزي. وأول زيارة خارج أوروبا قام بها كوشنير بعد أيام على تسلّمه منصبه، كانت إلى لبنان حيث عبّر عن مواقف لا تختلف أبداً عن مواقف سلفه دوست - بلازي.
إنفتاح الرئيس ساركوزي الملفت والمفاجىء بحجمه وأهميته، على الرغم من أنه كان وعد به، اعتبره خصومه مناورة هدفها الفوز بغالبية مريحة في الانتخابات التشريعية. هذا الكلام ربما يكون صحيحاً، لكنه يثبت مجدداً أن الرئيس الفرنسي يبقى محكوماً بالحدود التي يرسمها توازن في الحياة السياسية أرسته سنوات وعقود طويلة ماضية يصعب عليه تجاوزها مهما كان من أنصار القطيعة.
وينبغي عدم المبالغة في قدرة الرئيس الفرنسي على إحداث تغييرات جذرية، ولا سيما في مجال السياسة الخارجية التي ترسمها تراكمات على أيدي رؤساء سابقين وحكومات ووزارات خارجية سابقة طوال عقود طويلة ممتدة. وهناك مراكز قوى يصعب على الرئيس تجاوزها في الإدارة العليا وأجهزة الأمن والجيش وجماعات الضغط والمصالح والـ «كي دورسيه» وغيرها. بمستطاع الرئيس بالطبع استخدام عبارات ومفردات جديدة، وإضفاء لمسته الخاصة، واتخاذ بعض المواقف التي تحظى بإجماع عام أو بإغلبية مريحة، لكن ليس بمستطاعه، مهما كان قوياً وراغباً، الذهاب في عكس رياح المصلحة العليا لبلاده والتي يتطلّب تعريفها نوعًا من الإجماع، والذي لم يخرج عنه حتى الاشتراكي ميتران الذي وعد ذات مرة بمثل القطيعة مع الماضي التي وعد بها المرشح ساركوزي.
.1 Cf Jean -Claude ACQUAVIVA ˝Droit constitutionnel et institutions politiques˝ 2éme éd.Dunod,Paris 1994. et Philippe ARDANT "Institutions politiques et droit constitutionnel˝ 6me éd. LGDJ,Paris 1993 et du même auteur ˝les institutions de la 5éme republique˝,éd.Hachette,Paris 1993.
2. في آذار الماضي نشر الرئيس شيراك مذكراته تحت عنوان:
Jacques Chirac, texts et interventions “1-mon combat pour la France”, “2-mon combat pour la paix”,éd.Odile jacob,650 pages et 560 pages,Paris 01-06-2007
3. انظر مقالتنا في جريدة الخليج الاماراتية «عشر سنوات على رئاسة شيراك لفرنسا»، الخليج 22/5/2005
4. في خطاب متلفز عرضته محطات التلفزة الفرنسية بعد نشرة اخبار الساعة الثامنة من مساء11/3/2007
انظر مقالة رندة تقي الدين في جريدة الحياة في اليوم التالي
5 . Cf Henri de Bresson “les adieux de Jacques Chirac à l’Europe”, et Francois Probst “Chirac mon ami de 30 ans”, le Monde 25-03-2007.
6. Pierre Giacometti, “Jacques Chirac est à l’image des contradictions de Francais eux-mêmes”,le Monde 12/3/2007
7.Cf Béatrice Gurrey, "Une presidence sans cesse perdue et reconquise",le Monde 12à 15/3/2007
8. Cf francois Colcombet "Les Francais sont-ils prêts pour une 6éme Republique?",le Monde 21/3/1007
9. Elvie Fabry "Pourquoi les Français craignent-ils tant la mondialisation?",le Figaro 22/3/2007
10. في خطاب متلفز لم يدم اكثر من دقيقتين،مساء 12 نيسان 2007، الأمر الذي فسره المراقبون دعما فاترا لساركوزي
11. Guillaume Tobard "quatre lecons d'une campagne dominée par quatre candidats" ,Le Figaro 21/4/2007
12. Philippe Bernard "Nicolas Sarkozy et l'identite nationale", le Monde 19/3/2007
13. انظر مهدي شحادة «اللوبي الاميركي-الاسرائيلي يدعم ساركوزي»- و محمد نعمة «الحلقة العربية المفقودة في التوازن الفرنسي» جريدة «الاخبار»البيروتية 13/4/2007
14.انظر عبدالله اسكندر «الحملة لاسقاط بايروس الحياة 20/3/2007
15. Richard Robert "quelle place pour le centre sur la scène politique francaise" ,le Figaro 24/4/2007
16. Rodolphe Geisler "comment les verts ont disparu d'une campagne pourtant marquee par l'écologie", le Figaro 5/4/2007
17 . Jean-René Vander Plaetsen "en arborant les symboles nationaux,les candidats cherchent à rassurer l'electorat", le Figaro,2/4/2007. Cf aussi Sophie de Ravinel "la place des religions alimente la campagne",le Figaro 9/4/2007
18. Ivan Rioufole "la Nation,enjeu presidential" le Figaro 30/3/2007
19. Alain Garrigou "l'indécision est en partie une creation des sondages", le Monde 12/4/2007
20. Cf Gerard Courtois in le Monde 22/4/2007
21. في 23 نيسان الماضي نشرت كل الصحف الفرنسية نتائج الانتخابات بشكل مفصل مدينة مدينة وقرية قرية مع تعليقات مسهبة،يمكن العودة اليها لمزيد من التفاصيل.
22. Cf le Figaro du 27/4/2007 "Lourdes accusations du Francois Bayrou contre Sarkozy" et du 3/5/2007 "Que feront les deputés UDF le 6mai".
23. "la France neuve de Segolène Royal" ,le Figaro 1/5/2007
24. Bertrand Badie "la classe politique s'interdit une reflexion sur les transformations des relations internationales" ,le Monde 6,7 et 8/4/2007
25. Cf Council of foreign relation "Sarkozy and the world" May 7,2007
26. Peter Schwarz "Sarkozy's electoral victory and the bankruptcy of the French left", world Socialist Website, May 9,2007
27. Bertrand Badie ,Op.Cit.
28. قالت صحيفة جيروزالم الاسرائيلية (عدد 9/5/2007) ان ساركوزي سوف يعين صديقه الفرنسي-الاسرائيلي ارنو كلارسفيلد العائد لتوه من الخدمة في حرس الحدود الاسرائيلي وزيرا للهوية الوطنية والهجرة التي وعد باستحداثها.لكن ذلك لم يحصل.
29. جورج ساسين «ساركوزي يخطف فرنسا...ويرتاح» صدى البلد 8/5/2007
30. الاسبوع العربي العدد 2476 الاثنين 26 ايار 2007-06-30
31. اذاعته مباشرة على الهواء كل وسائل الاعلام الفرنسية المسموعة والمرئية مساء السادس من ايار 2007 ونشرته كل الصحف صبيحة اليوم التالي
32. Cf la presse francaise du 18 et 19 mai 2007
The French presidential elections and the promised rupture of relations in the internal and external policies
The researcher sheds light on the French presidential elections which led Nicolas Sarkozy to the presidency. The researcher tackles at first the issue of the elections according to the French constitution with the mechanism and laws which regulate the process of the electoral procedure. Afterwards he makes a quick survey of the past era of president Chirac and especially the status of coexistence which constituted a rare experience in government. Later on, the researcher examined some paradoxes in the past electoral campaign and the technique used by Sarkozy in these elections. He also sheds light on all the other candidas who competed in the ballots. The researcher also assigned a chapter to discuss the French external policy and its minimal effect on the electoral battle to guide his research towards reading the future of president Sarkozy’s era which is newly incoming to the Elysee and its chances of replacing from one part the new Degaulism and the possibilities of adopting a new and different French external policy.
Les élections présidentielles françaises et la rupture promise dans les deux politiques interne et extérieure
Le chercheur illumine sur les élections présidentielles françaises qui ont porté Nicolas Sarkozy à la présidence. Il évoque au début le mécanisme de l’élection selon la Constitution française et les lois organisant la procédure des élections, puis il se lance dans une lecture rapide de la phase chiraquienne écoulée, notamment la coexistence en tant qu’expérience unique. Le chercheur expose ensuite certaines étapes de la dernière bataille des élections et la façon dont Sarkozy a participé aux élections, tout en illuminant sur les autres candidats. De même, le chercheur a évoqué la politique extérieure française et son influence faible dans la bataille des élections pour enfin aboutir à une lecture concernant le futur de la phase Sarkozienne et ses chances pour occuper la place de la phase de la nouvelle De Gaullienne d’une part, et les possibilités d’adopter une nouvelle politique française extérieure et différente, d’autre part.