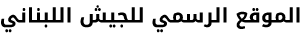- En
- Fr
- عربي
باختصار
شهيد آخر يحمل الورد إلى من سبقه من الشهداء، ويصحب التطمينات إلى الخالدين هؤلاء بأن وطنهم بخير، وأن عائلاتهم تتابع مسيرتهم في الحياة، وأن المؤسسة العسكرية الأم لا تنسى تضحياتهم، وهي تقف إلى جانب تلك العائلات، وتتقاسم معها الخبز والملح، والإخلاص للوطن.
المقدم الشهيد عباس جمعة كان يعدّ نفسه لمواجهة العدو، وحماية الحدود، والذود عن التراب، فإذا به ضحية عنف داخلي، وخروج سافر على القانون، وعلى أحكام المواطنة والأنظمة والأعراف. بالتأكيد، لم يكن الشهيد قد عزل نفسه عن السلاح، فهو عسكري والسلاح جزء منه لا يفارقه، أما المواطن، فمن يا ترى شرّع له حمل السلاح في الوقت الذي يتولى فيه جيش بلاده، وقواها الأمنية، حمايته، والدفاع عن حقوقه، وحقوق أهله وجيرانه...؟ قد يقول قائل: كان من الممكن أن يستخدم العسكري سلاحه إذن. والجواب: العسكري ليس غادرًا هنا. إنه يعلن عن مهمته، وعن تفاصيل واجبه في كل حين. وجوده على مساحة الوطن مسيرة دفاعية أمنية، وهو لم يترك عيادته، أو مدرسته، أو حقله ومصنعه، ليحمل السلاح فجأة، ومن دون وجه حق. المسلّحون المخالفون هم من تعدّى على السلاح، وتجاوز القانون، وجنى على رجال الأمن، وأساء إلى الاستقرار، وشغل العسكريين عن واجبهم الأساسي الذي هو صد العدوان الخارجي، والقيام بالأعمال الكبيرة دفاعًا عن كرامة البلاد. مع ذلك، فإن العسكري لا يدوّن اسم المواطن القاتل ذاك في خانة الأعداء، وهو لا يميل إلى قتله ثأرًا أو تأديبًا، بل يحرص على ضبط رعونته، فيلقي القبض على تهوُّره، ويعتقل جنونه وإجرامه وشرود أفكاره ومشاعره الهوجاء، لكن المواطن المجنون يشد على زناد سلاحه الممنوع، ويقع الحادث المرفوض، ويستشهد المقدم جمعة.
صحيح أنه لا يمكن الدفاع عن الوطن من دون أن نحيي الاستقرار في مجتمعه، وأنّ إحياء الاستقرار مكلف كثيرًا، ويستدعي التضحية، إلا أن المقاربة بين دم ندفعه في مواجهة العدو الإسرائيلي، ودم ندفعه في الحفاظ على أمن الداخل، تبقى بعيدة عن الرضا، ليس فقط لأن الدم العسكري سكب في غير موقعه، إنما أيضًا، لأن دم المواطن لم يكن جاهزًا لأن يسكب إلى جانبه عند مذبح تلك المواجهة، حيث يهون الموت، ويقتضي الاستشهاد، وتصبح المهج كأوراق الشجر متوافرة ميسّرة، وجاهزة لكبير العطاء.