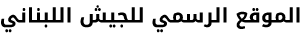- En
- Fr
- عربي
بلى فلسفة
ضاع الحام
في ذكريات طفولتي، رحلةٌ قمت بها مع جارتي مروى إلى جبل مجاور لمنازلنا حيث رحنا نمشي صعداً في الطبيعة، وكان الفصل هو الصيف، والخضرة كانت قليلة إلا في الأشجار، والأعشاب المحيطة بالدرب كانت في معظمها قد يبست، كما ان الدرب نفسه كان مغطى بالحجارة التي زادتها خطوات الأجيال نعومة ورسوخاً لفرط ما قُذفت يميناً وأُزيحت يساراً حتى استقرت وهدأت. لم يكن النسيم ليغيب لحظة في ذلك الجبل، فما يكاد يطل من الوادي خفيف الجناحين عميق الصّفير بادي الشوق واللهفة إلى لقاءٍ ما، حتى يغلّ في أحضان الغصون يتزوّد العطر والخير والأخبار الراقدة بين الورق، ويروح مودعاً على مهل في هدأة السفوح.
إلاّ انه، وأنا أعرف عن نظاميته ورزانته وحكمته الكثير، أطلّ هذه المرة عاصفاً لصيقاً بالأرض زاحفاً بين منعرجاتها، وتناول جارتي من ساقيها في إجراء مفاجئ بدا منه إن هناك من كلّفه إحضار عروس ما من بين الحقول، وإلاّ سدّ عليه أبواب العزائم من كل صوب. وكان خطف الصبايا شائعاً في ذلك الزمان لأسباب وأسباب، منها انّه كان للأهل آراء صارمة في مستقبل بناتهم، وإنهم كانوا يرفضون في أحيانٍ كثيرة الطلبات الساعية إلى الأيدي الناعمة المقيمة في حماهم، وانّ الأيدي الناعمة تلك كانت معدودة قليلة الانتشار مما كان يضفي على صاحباتها الكثير من الدلال، ثم ان طالبي الأيدي لم يكونوا من «مدحرجي النهود كالثمار»، بل كان مسعى الواحد منهم في الغالب يسير به الى اثنين فقط هما قمتان من الخير للعمر بأسره. لم يكن النسيم العاصف ليتمكن من جارتي خصوصاً وإنها كانت من الثوابت الثابتات في أرض القرية. وعلى الرغم من نحول جسمها فإنها لم تكن لتلين عوداً أو لتهون عزيمة أو لترضى بما يعاكس رأيها، لذا كنت على يقين من أن مرور العاصف بها لن يكون أوسع أثراً من مروره بواحدة من سندياناتنا الراسخات اللواتي يميل بهنّ الهوى يمنة ويسرة من دون أن ينال من أي من عروقهنّ الممتدة في أرض الجدود. وكنت على يقين أيضاً أن المقصود ما هو إلا دعابة عابرة قد تصيب فستان جارتي إصابة عابرة لن يصعب عليها اتقاؤها بمفردها من دون أن أتدخل أنا.
ما إن سيطر العاصف على أطراف الفستان وهمّت جارتي بأن تلوي عنقها وتستدير محاوِلة إبقاء الأمور على نصابها، حتى وجّهت نظري في الحال الى الجهة المعاكسة، إلى الوراء، إلى أول الدرب وكأنّي أنوي الإدبار وترك الجارة تتدبر أمرها بنفسها. إلا أن الجارة صرخت مطلقة اسمي عالياً لا لتشكو إليّ، إنما لتشكوني، أو على الأقل، لتنبّهني إلى أنه ليس من المسموح أبداً، وليس من الجائز وليس من المرغوب وليس من الحلال، أن أنظر إليها وهي تعالج نزوة النسيم! لم يتأخر الفرج بالتأكيد، لقد فرّ النسيم، وأغلب الظن إنه فوجئ بالصراخ، وحسِب انه موجّه اليه، وهل كان ليخطر في باله ان جارتي قد تصرخ بي وأنا رفيق دربها، على الأقل في تلك اللحظات؟
على مدى العمر كان ذلك المشهد يعود اليّ من وقت إلى آخر، خصوصاً عندما تتناهى إليّ قصيدة أحمد شوقي أمير شعراء العربية، «جبل التوباد» في الشطر القائل: «ورعينا غنم الأهل معاً...»، وأيضاً عندما تستقر في عيني الصورة المشهورة لماريلين مونرو، حسناء العالم، تضحك ما وسعها الضحك، وتخلي رأسها من الأفكار ما وسعها الإخلاء، وهي تشد فستانها من جهتين فيما يدفعه الهواء، الذي يهب من تحت قدميها، في جهات وجهات من جمالها الذي لم يعرف الحدود على الإطلاق.
ما دفعني إلى كل ذلك التقديم هو حلم غريب يسّر لي، في المنام، لقاء هو الأول من نوعه والأكبر في حجمه والأغرب في صفاته، مع ماريلين مونرو نفسها.
يقول المحللون والمفسرون والشارحون إننا نرى في أحلام المنام ما كنا نفكر به في أمنيات الصحوة في وقت سابق غير بعيد. والردّ: أنا لم أكن قد فكرت بالموضوع لا قبل يوم ولا قبل أيام ولا قبل شهور. لا أنكر أن لحسناء العالم ملفاً وثائقياً صغيراً صغيراً في مكتبتي إلى جانب ملفات تولستوي وفاليري وغاندي وأبي النواس وأحمد رامي وأمين نخلة والياس أبي شبكة وسامي الشوا وداوود حسني... وهي تضاهي رؤوسهم الملأى بجمال رأسها الخفيف، إلاّ أنه «بقى لي زمان» لم أرجع إلى ذلك الملف. كما إن جارتي - لو افترضتُ انها السبب - قد غفت، في البال وفي الذاكرة، منذ مدة بعد أن امتلكتها الأوجاع وتمكّن منها المرض. أما أرض قريتي، فلا أنكر انها في بالي وأنها، أو أنّي، أو أن كلانا حينما يبتعد عن الآخر يوماً فإنما يقوم بين الاثنين دهر من الحنين والذكريات والأمنيات الخائبة.
اللافت في الحلم الذي تصيّدته في غفوتي هو انني، وبعد يوم واحد لا غير قرأت في الجرائد انه تم رصد آراء عيّنة من أفراد بلاد الانكليز حول أهم الشخصيات الراحلة التي يتمنون لقاءها فيما لو عادت الى الحياة، فجاءت ماريلين مونرو في الدرجة الرابعة. لو علمت بذلك قبل الحلم بيوم مثلاً لنجح المحللون والمفسرون والشارحون، لكن، ما دام الحلم قد سبق الخبر فلا تفسير عندهم كما أحسب. أعود إلى مشاهد الحلم وأحداثه: نحن ثلاثة في حقل يسيطر على نبتاته اللون الحزيراني الذي رافقني في رحلتي مع جارة الطفولة. وفي الحقل أنا، نعم أنا، وماريلين مونرو ورجل لطيف، لم أره من قبل، كان يصطحب حسناء العالم من أجل أن يقيم التعارف بيني وبينها. تم التعارف سريعاً. سلّمَنا الرجل الواحد للأخرى، أو الواحدة للآخر، من دون أن يذكر أو يفترض وجود أي حسنات أو صفات أو مؤهلات عندي ترضي تلك المرأة الخيالية الواقفة أمامي. كانت في فستان وكأنها، وهي ابنة أميركا، لم تنظر إلى المستقبل، الذي هو حاضرنا اليوم، لتتعلم إسقاط ساقيها في اسطوانتي البنطلون، ولتتدرب على كشف جلد بطنها أمام العيون. كانت في فستان مثل جارتي الراحلة في الأسلوب، وقبلها في الزمان، فستان يتراوح لونه بين الكحلي والأزرق، تتوزع فيه النقاط البيضاء كأزهار الياسمين. شعرها كان كعادته أشقر، شبيهاً بما حوله من النباتات الحزيرانية التي تنتظر سواعد الحاصدين. كانت لائقة باسمة راضية متألقة متواضعة، ولم تُسمعني على الاطلاق No Way الكلمة المشهورة التي «أنكلزتها» نساء بلادي المشقّرات.
كان التوقيت سابقاً للغروب بقليل مما زاد في ذهبية الألوان، الشمس والحقل والشَّعر. شُغلت أنا على الفور بضرورة تأمين مكان مناسب لتمضية هذه الليلة السحرية، وقد تيسّر في ذاكرتي حلاّن لدى صديقين أطمئن الى حسن استقبالهما، وافترضت انه لا بدّ لي أن أوفّق الى واحد منهما. بقي أن أتصل بالصديقين. لم يكن في المكان أثر لهاتف سلكي أو لاسلكي. أعمدة الهاتف الخشبية لم تكن موجودة. الهاتف الجوال كنت ممن لا يعرفونه، فالحقل وأنا بدائيان بدائيان أصيلان مع أن التي تقف أمامنا ليست فلاحة من بني أمّنا، بل إنها إنسانة يفصل الحرير على الدوام بينها وبين الأشياء، وقد تلمس، إن لمست، كاسيت الموسيقى أو قارورة العطر أو خاتم الماس فقط. رحت أفتش عن وسيلة اتصال، وكنت بين الوقت والآخر أعود إلى ضيفتي حسناء العالم، أطمئن اليها، ويدور بيننا كلام بسيط، فلا أنا أعرف من انكليزيتها إلاّ كلمات معدودة ولا هي تعرف من عربيتي إلا نظرات هادئة بالغة التعبير. الوقت يمضي والليلة تكاد تنقضي. التفتيش عقيم وصاحباي في المجهول لا يسمعان ندائي المكتوم، ورغبتي الخجولة لم تدرك طريقها إليهما. لم أعثر في الحقل على قطعة حديد تشبه آلة الهاتف. لم أصادف شريطاً من الفولاذ أو القنّب أو الكتان أو... سلك الهاتف. هبطت إلى أحد المنحدرات مفتشاً، فلم أجد فيه هو الآخر شيئاً. أسرعت في الرجوع، ليس من أجل تجنّب خطورة المنحدر، إنّما لكي أطمئن إلى الحسناء وأطمئنها إلى أنني ما زلت أفتش في لهفة وحيوية، ولكي أوضح لها أن الدروب ما زالت مسدودة أمامي لكنني لم أفقد الأمل. وكان عليّ أن أتسلّق جداراً مرتفعاً فيه بعض الحجارة الناتئة التي كانت أصابعي تمسك بها حذرة مضطربة، إلى أن أمسكت، في سبيل القفز إلى الأعلى، حجراً متأرجحاً ما لبث أن أفلت من مكانه على الفور، وتدحرج الى الأعماق، وقبل أن أتوارى معه، شدني الخوف من على سريري وكان العتم يلف الدنيا، فقلت للتو، وفي صمت رهيب وأنا مطبق الشفتين: يا للسعد، لقد أنقذتني يقظتي من رعب هذا الكابوس. لكنني عدت لأغير رأيي بعد قليل، حين عاد الأمان إلى القلب: لا، كان عليّ أن أحاول مرة أخرى قبل أن أسلّم بضياع ليلتي.