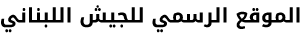- En
- Fr
- عربي
جدلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الإقتصادية
ثمة سمة ممِّيزة للتطوُّر العالمي اليوم تتمثَّل في التصاعد المتعاظم للإنفاق العسكري في معظم البلدان، بحيث صار يشكل عبئاً يرهق كاهل موازنات الدول، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وعائقاً للتنمية الإقتصادية في هذه الدول. ويرى العديد من المحلِّلين الإقتصاديين في العالم أن أعباء الحرب في كل من العراق وأفغانستان هي أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الراهنة التي ضربت الإقتصاد الأميركي ابتداء من العام 2007، ثم تحوَّلت إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية تعيد إلى الأذهان أزمة «الكساد العظيم» في بداية الثلاثينيات من القرن المنصرم.
لقد كانت الطفرة الإقتصادية التي شهدها الإقتصاد العالمي في التسعينيات من القرن الماضي ثمرة مباشرة لانتهاء الحرب الباردة. إذ أن جزءاً أساسياً من الأموال التي كانت تنفق على سباق التسلح، أخذت تتوجَّه حينذاك نحو مشاريع تطوير البنى التحتية المادية والإجتماعية. غير أن تلك الحقبة الذهبية لم تدم طويلاً. فنهاية الحرب الباردة لم تجلب السلام النهائي للعالم، وسرعان ما احتدمت التناقضات بين الدول، وانتشرت النزاعات وتفاقمت الصراعات ووقعت الحروب، وتسارعت عجلة سباق التسلُّح، سواء بين الدول الكبرى، أم بين دول نامية وفقيرة ذات دخول منخفضة ومتوسطة، في آسيا وإفريقيا بالدرجة الأولى.
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أثر الإنفاق العسكري على التنمية الإقتصادية. ولتحقيق هذا الغرض سوف نقسم البحث إلى أربعة أقسام:
1) القسم الأول، يتناول مفهوم الإنفاق العسكري والعوامل المؤثرة في تحديد مستواه.
2) القسم الثاني، يتضمَّن عرضاً لتزايد الإنفاق العسكري في العالم، خصوصاً في بعض البلدان الكبرى، وذلك بالإستناد أساساً إلى المعطيات الواردة في الكتاب السنوي (إصدار 2009)، الذي يصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri).
3) القسم الثالث، يبحث في جدلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الإقتصادية.
4) أما القسم الرابع، فيتوقَّف عند مفهوم جديد أطلقه بعض دعاة النظرة الإيجابية، في الولايات المتحدة خصوصاً،إلى الإنفاق العسكري من حيث تأثيره المحفز للنمو الإقتصادي، نقصد به مفهوم ما يسمَّى «الكينزية العسكرية».
1) تعريف الإنفاق العسكري،والعوامل المؤثرة في تحديد مستواه
تعريف الإنفاق العسكري
ثمة تعريفات مختلفة لمفهوم الإنفاق العسكري. بعضها يتناوله من منظور ضيِّق حيث يختصره بتلك «الموارد المكرَّسة للدفاع في الموازنة العامة للدولة»، وبأنه «جزء من الإنفاق العام للدولة، تقوم به من أجل الدفاع عن نفسها في حالة تعرُّضها لخطر خارجي، أو لمواجهة خطر واقع عليها فعلاً، أو لتسخير قوتها العسكرية لتحقيق أهداف توسعية»[1]. هذا التعريف لا يأخذ في الحسبان مختلف أوجه الإنفاق المرتبط بالأغراض العسكرية، وإنما يركز فحسب على الإنفاق الوارد في الموازنة العامة للدولة. كما أنه لا يتضمَّن الأنشطة المدنيَّة التي تقع ضمن موازنة الدفاع، كمشاريع الأبنية الأساسية وأعمال الإغاثة. وإذا ما أخذ بهذا المفهوم للإنفاق العسكري فإنه سيكون مضللاً ولا يعبر عن حقيقة هذا الإنفاق، لأنه سيكون في الغالب أدنى مما هو في الواقع، وسيجعل مقارنته مع الإنفاق العسكري في الدول الأخرى غير دقيقة.
على العكس من هذا التعريف الضيِّق للإنفاق العسكري يتناول البعض هذا المفهوم بمنظور أوسع، فيعتبر أنه يضم كلاً من البنود الآتية:
- النفقات الكلية لوزارة الدفاع للأغراض العسكرية.
- النفقات التي تدعم بشكل مباشر البرامج الدفاعية، بصرف النظر عن الإدارة التي تقوم بها.
- نفقات البرامج الأخرى المبرَّرة على أرضية الأمن القومي.
- المدفوعات كلها للحروب السابقة أو البرامج العسكرية السابقة[2].
غير أن التعريف الأوسع والأكثر شمولية للإنفاق العسكري هو ذلك الذي يستخدمه معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri)، حيث يرى أن الإنفاق العسكري «يتضمَّن الإنفاق على الجهات الفاعلة والأنشطة الآتية:
أ) القوات المسلحة، بما فيها قوات حفظ السلام.
ب) وزارات الدفاع وهيئات حكومية أخرى مشتركة في مشاريع دفاعية
ج) القوات شبه العسكرية، عندما يُحسب أنها مدرَّبة ومجهَّزة لعمليات عسكرية.
د) الأنشطة العسكرية في الفضاء. وهو يشمل جميع الإنفاق الجاري والرأسمالي على:
1) الأفراد العسكريين والمدنيين، بما في ذلك رواتب تقاعد العسكريين والخدمات الإجتماعية للأفراد.
2) العمليات والصيانة.
3) المشتريات.
4) البحث والتطوير العسكريين
5) المساعدة العسكرية (في الإنفاق العسكري للبلد المانح).
أما المستثنى من الإنفاق فهو الدفاع المدني والإنفاق الحالي على أنشطة عسكرية سابقة، مثل الإعانات المخصَّصة لمحاربين قدامى، ولإجراءات تسريح من الخدمة، وتبديل أسلحة وتدميرها»[3].
العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الإنفاق العسكري
إن الإنفاق العسكري هو بمنزلة قرار سياسي، استراتيجي، اقتصادي. وبدهي أن تخضع عملية اتخاذ القرار في هذا الخصوص لتأثير عوامل مختلفة، تتفاعل في ما بينها، سياسية واستراتيجية واقتصادية[4]:
العوامل السياسية، تتمثَّل في الوضع السياسي القائم في البلد المعني، وطبيعة نظام الحكم، ودرجة الإستقرار السياسي فيه. وطبيعي أن ثمة علاقة مباشرة بين عدم الإستقرار السياسي والإنفاق العسكري. وكذلك في التحالفات الإقليمية للبلد المعني ومدى ارتباطه بتحالفات عسكرية يمكن أن تجعل إنفاق البلد عند مستويات عالية.
العوامل الإستراتيجية، وتتمثَّل في خطر نشوب حرب، حيث أن الإنفاق العسكري يكون عالياً في المناطق التي تلوح في أفقها احتمالات الحرب. وكذلك الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية، التي تطلق سباقات تسلُّح بين دول المنطقة.
العوامل الإقتصادية، وتتمثَّل في:
-1 توافر الموارد الإقتصادية، فكلما كانت الدولة غنية بالموارد الإقتصادية، كانت أكثر قدرة من غيرها على الإنفاق على الأغراض العسكرية، والعكس صحيح.
-2 مستوى التنمية الإقتصادية، والذي يُعبر عنه عادة بالتغيُّرات في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج الوطني. حيث أن مستوى التنمية الإقتصادية يؤدي دوراً مؤثراً في تحديد مستويات الإنفاق العسكري. فمع تزايد وتائر النمو قد يميل الإنفاق العسكري إلى الإرتفاع.
-3 الصرف الأجنبي، فتوافر الصرف الأجنبي يمكن أن يساعد الدولة على تلبية حاجاتها من المعدات العسكرية المتطورة، ما يدفع النفقات العسكرية إلى الإرتفاع، والعكس صحيح.
-4 التصنيع العسكري، أي مدى وجود صناعة عسكرية محلية. ففي الدول التي تتوافر فيها صناعات عسكرية، تجد المؤسسة العسكرية نفسها تحت ضغط ضمان طلب مستمر كافٍ على إنتاج هذه الصناعات، الأمر الذي يجعل الإنفاق العسكري عند مستويات مرتفعة.
2) الإنفاق العسكري يتعاظم
لم تجلب نهاية الحرب الباردة، كما ذكرنا، السلام النهائي للعالم، وكانت النتيجة الحتمية لاحتدام التناقضات بين الدول، وانتشار النزاعات وتفاقم الصراعات، وتسارع عجلة سباق التسلح، أن تعاظمت النفقات العسكرية لغالبية بلدان العالم. فحسب معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri)، شهدت الفترة من العام 1989 وحتى العام 2008، ارتفاعاً كبيراً جداً في النفقات العسكرية على مستوى العالم. وكان قصب السبق فيها بالطبع للولايات المتحدة التي شكَّل الإنفاق العسكري فيها قرابة نصف مجموع الإنفاق العسكري على مستوى العالم ككل.
قُدِّر الإنفاق العسكري العالمي بنحو 1464 مليار دولار العام 2008، بزيادة مقدارها 4 % بالأسعار الحقيقية، مقارنة بإنفاق العام 2007، وزيادة بنسبة 45 % على فترة السنوات العشر 1999 – 2008. وقد شكَّل ذلك قرابة 2,4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أو 217 دولاراً لكل فرد. وبقيت الولايات المتحدة الدولة الأكثر إنفاقاً العام 2008، حيث استـأثرت بـ41,5 % من الإنفاق العسكري الإجمالي في العالم، تلتها الصين بنسبة 5,8 %، ثم فرنسا وبريطانيا وروسيا بنسبة 4 – 4,5 لكل منها[5].
ويظهر الجدول الآتي، الإنفاق العسكري للبلدان الخمسة عشر الأكثر إنفاقاُ في العالم العام 2008:
الجدول الرقم 1: البلدان الـ15 ذات الإنفاق العسكري الأعلى العام 2008
المصدر: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي. 2009، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي(sipri)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص 264 – 265.
ملاحظات: الأرقام الموضوعة بين قوسين [ ]، هي أرقام مقدَّرة.
|
المرتبة |
البلد |
الإنفاق (مليار $) |
الحصة العالمية (%) |
نصيب الفرد من الإنفاق ($) |
العبء العسكري 2007 (%) |
التغيير 1999-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
الولايات المتحدة |
607 |
41,5 |
1967 |
4,0 |
66,5 |
|
2 |
الصين |
[84,9] |
[5,8] |
[63] |
[2,0] |
194 |
|
3 |
فرنسا |
65,7 |
4,5 |
1061 |
2,3 |
3,5 |
|
4 |
بريطانيا |
65,3 |
4,5 |
1070 |
2,4 |
20,7 |
|
5 |
روسيا |
[58,6] |
[4,0] |
[413] |
[3,5] |
173 |
|
المجموع للدول الخمس الأولى |
882 |
60 |
|
|
|
|
|
6 |
ألمانيا |
46,8 |
3,2 |
568 |
1,3 |
-11,0 |
|
7 |
اليابان |
46,3 |
3,2 |
361 |
0,9 |
1.7 |
|
8 |
إيطاليا |
40,6 |
2,8 |
689 |
1,8 |
0,4 |
|
9 |
السعودية |
38,2 |
2,6 |
1511 |
9,3 |
81,5 |
|
10 |
الهند |
30,0 |
2,1 |
25 |
2,5 |
44,1 |
|
المجموع للدول العشر الأولى |
1084 |
74 |
|
|
|
|
|
11 |
كوريا الجنوبية |
24,2 |
1,7 |
501 |
2,7 |
51,5 |
|
12 |
البرازيل |
23,3 |
1,6 |
120 |
1,5 |
29,9 |
|
13 |
كندا |
19,3 |
1,3 |
581 |
1,2 |
37,4 |
|
14 |
أسبانيا |
19,2 |
1,3 |
430 |
1,2 |
37,7 |
|
15 |
أستراليا |
18,4 |
1,3 |
876 |
1,9 |
38,6 |
|
المجموع للدول الخمس عشرة الأولى |
1188 |
81 |
|
|
|
|
|
العالم |
1464 |
100 |
217 |
2,4 |
44,7 |
|
العبء العسكري للدولة، هو الإنفاق العسكري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. الأرقام بخصوص العبء العسكري للدولة تخص العام 2007، وهو آخر عام توافرت فيه بيانات عن إجمالي الناتج المحلي.
تتضمَّن البيانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الإنفاق على النظام والسلامة العامين. وقد يكون ثمة مبالغة طفيفة في التقدير.
يتبيَّن من الجدول أن البلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقاً عسكرياً في العالم العام 2008، قد استأثرت بنحو 81 % من الإنفاق العسكري العالمي، بينما استأثرت البلدان الخمسة الأولى بنحو 60 %. وهذه الحصص مماثلة للحصص العام 2007. وقد استأثرت الولايات المتحدة بالحصة الأكبر إلى حد بعيد (41,5 % من المجموع)، وتبعتها على مسافة بعيدة الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
والبلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقاً العام 2008 هي نفسها التي كانت العام 2007، على الرغم من أن بعض المراتب تبدَّل. وعلى نحو خاص، كانت الصين العام 2008 البلد الثاني الأعلى إنفاقاً في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى، حيث تجاوزت فرنسا وبريطانيا. وتُظهر البلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقاً، تفاوتاً واسعاً في نصيب الفرد الواحد من معدلات إنفاقها العسكري، فضلاً عن التفاوت في معدَّلات زيادتها منذ العام 1999. وقد بلغ عبء المملكة العربية السعودية العسكري (أي الإنفاق العسكري كحصة من إجمالي الناتج المحلي) 9,3 % العام 2007 (وهي السنة الأخيرة التي تتوافر فيها الأرقام بالنسبة إلى هذا البلد)، ولم تتجاوز في هذا المؤشر سوى عُمان، في الوقت الذي تعدَّت كوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة أيضاً المتوسط العالمي البالغ 2,4 %.
على الطرف الآخر، كانت نسبة الأعباء العسكرية لكل من أستراليا وكندا والبرازيل وإيطاليا واليابان وأسبانيا دون 2 %. كما كان لدى كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان نمو بطيء، بل سلبي بالأسعار الحقيقية، في الإنفاق العسكري منذ العام 1999. أما بالنسبة إلى إنفاق البلدان الأخرى، فقد ازداد بصورة كبيرة. فقد زادت الصين وروسيا إنفاقهما العسكري بسرعة قصوى (حيث بلغت نسبة النمو 194 % في الصين، و173 % في روسيا)، إذ ضاعفتاه ثلاث مرات تقريباً منذ العام 1999. كما زادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و كوريا الجنوبية الإنفاق بأكثر من 50 %[6].
يستخدم معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri) أسعار الصرف في السوق لتحويل أرقام الإنفاق العسكري في مختلف البلدان والمحدَّدة بالعملات المحليَّة، إلى دولارات أميركية، حيث إن ذلك يوفر المعيار الأسهل للقياس الذي يمكن أن يتم بواسطته عقد المقارنات الدولية للإنفاق العسكري. لكن ثمة طريقة أخرى هي تحويل الأرقام باستخدام ما يسمى «أسعار صرف تكافؤ القدرة الشرائية» (PPP) وهي معدَّلات تمثِّل على وجه أفضل حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمبلغ معيَّن من المال في كل بلد. ولو تم استخدام معدلات تكافؤ القدرة الشرائية مرتكزة على إجمالي الناتج المحلي، لتغيَّرت بعض الشيء تراتبية الدول الخمس عشرة من حيث مستوى الإنفاق العسكري. ففي هذه الحالة ستنتقل روسيا إلى المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات المتحدة والصين، والهند إلى المرتبة الرابعة، وبريطانيا إلى المرتبة الخامسة، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة. وستدخل كل من إيران وتركيا قائمة البلدان الخمسة عشر الأولى، لتحلا مكان أستراليا وأسبانيا. أما الولايات فستبقى متقدِّمة على بقية الدول إلى حد كبير. غير أن سيطرتها ستتراجع: فإذا استخدمنا أسعار صرف السوق، تكون نسبة الإنفاق العسكري الأميركي إلى الإنفاق العسكري الصيني 7,2: 1، في حين أن استخدام أسعار صرف تكافؤ القدرة الشرائية يخفض النسبة إلى النصف، أي إلى 3,6: 1.
ولكن، مع أن معدلات تكافؤ القدرة الشرائية القائمة على إجمالي الناتج المحلي تقيس حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في الإقتصاد الكلي لكل بلد، فإن ذلك لا يعني أنها أفضل من أسعار الصرف في السوق، لقياس حجم السلع والخدمات العسكرية التي يمكن الحصول عليها. وعلى وجه الخصوص، من غير المرجَّح أن تعكس معدلات تكافؤ القدرة الشرائية، التكاليف النسبية لتكنولوجيا الأسلحة والأنظمة المتطورة لكل بلد[7].
وسوف نقدِّم في ما يأتي عرضاً موجزاً لتطور الإنفاق العسكري في بعض البلدان والمناطق:
الولايات المتحدة الأميركية
إزدادت النفقات العسكرية الأميركية (بالأسعار الحقيقية) في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الإبن، إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وقد حصل هذا الإرتفاع السريع نتيجة للميزانيات المخصَّصة للحرب في كل من العراق وأفغانستان، تحت عنوان «الحرب العالمية على الإرهاب». وخلافاً للحروب الأخرى التي خاضتها الولايات المتحدة سابقاً، جرى تمويل هاتين الحربين بصورة أساسية من خلال مخصَّصات إضافية طارئة خارج الميزانية العادية، أي بصورة منفصلة عن الميزانية العسكرية الرسمية (نفقات الدفاع الوطني). وقد جرت عملية التمويل هذه من خلال الإقتراض بصورة أساسية. ومن المتوقَّع أن يستمر الإنفاق عليها في المستقبل القريب، حتى ولو نفذت إدارة الرئيس باراك أوباما تعهدها بتحقيق انسحابات كبيرة من العراق. وقد أدت سياسة إدارة بوش إلى انقلاب الفائض في الميزانية العامة، إلى عجز كبير وإلى ارتفاع حاد في الدين العام. وكان تعاظم الإنفاق العسكري أحد الأسباب الأساسية لذلك.
إرتفعت النفقات العسكرية الرسمية في الولايات المتحدة (نفقات الدفاع الوطني) من 294,4 مليار دولار العام 2000، إلى 607,3 مليارات في السنة المالية 2008. وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 675 ملياراً العام 2009. وهذا ما يشير إلى زيادة في الإنفاق العسكري الأميركي بالأسعار الحقيقية، تبلغ 71 % خلال الفترة ما بين 2000 و2009. وقد شكلت نفقات الدفاع الوطني حصة متزايدة من إجمالي الناتج المحلي، حيث ارتفعت من 3 % العام 2000 إلى 4,5 % العام 2009. فضلاً عن ذلك، بما أن التكاليف المتوقعة للعمليات في العراق وأفغانستان لم تكن مموَّلة بالكامل في السنة المالية 2009، فمن المتوقع طلب ميزانية إضافية، الأمر الذي سيرفع الزيادة العامة أكثر من ذي قبل. وقد طرأت الزيادة الكبرى في الإنشاءات العسكرية ومشتريات الأسلحة والعمليات والصيانة[8].
فضلاً عن الإنفاق العسكري الرسمي، أسفرت سياسة «الحرب على الإرهاب»، التي أطلقتها إدارة الرئيس بوش، عن إنفاق إجمالي قدره حوالى 797 مليار دولار خلال الفترة ما بين العامين 2002 و2008، كان الجزء الأكبر منه (أي 749 ملياراً) لحساب وزارة الدفاع. وبما أنه جرى اللجوء إلى الإقتراض لتمويل هذه الحرب، فقد أدى ذلك إلى تحول الفائض السنوي في الميزانية العامة، البالغ 236 مليار دولار العام 2000، إلى عجز قدره حوالى 407 مليارات العام 2009. غير أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، رفعت العجز إلى رقم مذهل هو 1,2 تريليون دولار، أو 8,3 % من إجمالي الناتج المحلي. وهو يتجاوز الرقم القياسي الذي سجل بعد الحرب العالمية الثانية، والبالغ 6 % من إجمالي الناتج المحلي[9]. ونتيجة للعجز الكبير في الميزانية، تضاعف الدين العام الأميركي من 6,5 تريليون دولار العام 2000، إلى قرابة 10,4 مليارات دولار العام 2009، أي ما يعادل 69 % من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من أن الزيادة في الإنفاق العسكري ليست السبب الوحيد للزيادة الكبيرة في عجز الميزانية العامة الأميركية والدين العام، فمن الواضح أنها أسهمت مساهمة كبيرة في ذلك[10].
- أوروبا
استمر اتجاه الإنفاق العسكري في أوروبا الغربية والوسطى منخفضاً بعض الشيء العام 2008. فقد ازداد في أوروبا الغربية بنسبة 0,6 % فقط خلال الفترة ما بين 1999 و2008، و4,5 % في أوروبا الوسطى خلال الفترة نفسها. ويُفَسَّر هذا النمو المنخفض بعدم وجود تهديدات عسكرية جدية في تلك المنطقة، وإلى النمو الإقتصادي المتواضع، والرغبة في تقليص العجز في الميزانية إلى أدنى حد. ويخطِّط عدد من بلدان المنطقة، تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، لإجراء تخفيضات في الميزانيات العسكرية. وثمة ميزة مشتركة لعدد كبير من هذه البلدان تتمثَّل في التوجه لتخصيص الموارد في ميزانياتها العسكرية في مجالات المعدات والبحث والتطوير، حيث تسعى القوى إلى التكيف مع مهمات حملات عسكرية تميل نحو سياسة التدخل، وإلى استغلال تكنولوجيات متطورة في مضماري المعلومات والإتصالات.
سوف نتناول في ما يأتي طبيعة الإنفاق العسكري في بلدين رئيسين في تلك المنطقة هما بريطانيا وفرنسا، بالإعتماد، مجدداً، على المعطيات الواردة في الكتاب السنوي لسيبري، المذكورة آنفاً:
مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن الإنفاق العسكري في بريطانيا بلغ 65,3 مليار دولار العام 2008، محققاً بذلك زيادة بنسبة 3 % (بالأسعار الحقيقية)، وبنسبة نمو سنوي قدرها 20,7 % خلال فترة ما بين العامين 1999 و2008. ومع ذلك فقد واجهت بريطانيا قصوراً بالغاً في الميزانية العسكرية العام 2008، ويعود ذلك جزئياً إلى التورُّط في حربي العراق وأفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة. وكان من المتوقَّع أن تصل كلفة هاتين الحربين إلى 12 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار) العام 2009 [11]. كما أنه يعود جزئياً إلى التزامات عدة مشاريع لتطوير أسلحة، تفتقر إلى خطط تمويل واضحة. ويرى مسؤولون في الحكومة أن القصور سيبلغ 1,5 – 2 مليار جنيه استرليني في الفترة ما بين العامين 2009 و2011. ولسد هذه الفجوة فضَّلت الحكومة العام 2008، تقليص عدد من المشاريع أو تأجيلها وليس إلغاءها[12].
أما فرنسا، التي أصدرت «كتاباً أبيض» جديداً للدفاع في حزيران/يونيو 2008، فقد خفضت إنفاقها العسكري بصورة طفيفة العام 2008، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية، علماً إنه كان من المتوقَّع أن يتجاوز في ذاك العام نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي، التي اتفق عليها أعضاء الإتحاد الأوروبي. وفق الكتاب الأبيض، ستبقى الميزانية العسكرية الفرنسية ثابتة بالأسعار الحقيقية حتى العام 2012. وسيتركَّز الإنفاق على المعدَّات، على تكنولوجيا القيادة والسيطرة والإتصال والكمبيوتر والمعلومات والمراقبة والإستطلاع، وعلى الأخص تكنولوجيا الفضاء، التي سيتضاعف إنفاقها، وحماية القوات، والحركية الإستراتيجية، وحرب الغواصات، وقدرات توجيه ضربات في العمق. وستتم زيادة الإنفاق على المعدات من متوسط سنوي قدره 15,5 مليار يورو (22,7 مليار دولار) بأسعار العام 2008 الثابتة خلال الفترة ما بين العامين 2003 و2008، إلى قرابة 18 مليار يورو (26,4 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2009 و2020 [13].
– روسيا
أما روسيا التي تراجع إنفاقها العسكري إلى حد كبير بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، وحقبة التضعضع التي عاشتها في تسعينيات القرن المنصرم، فقد عادت إلى مضاعفة نفقاتها على الأغراض العسكرية بوتائر متسارعة في السنوات الأخيرة. وبناء على معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri)، احتلَّت روسيا المركز الخامس في العالم من حيث الإنفاق العسكري العام 2008 (كانت في المركز السابع العام 2007)، علماً أنها تحتل المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة في تصدير الأسلحة، حيث تبلغ حصتها 25 % من سوق الأسلحة (مقابل حوالى 31 % للولايات المتحدة). والجدير بالذكر في هذا السياق، هو أن الصناعة العسكرية الروسية تعتمد على الأسواق الخارجية لتحقيق الأرباح، في حين أن الصناعة العسكرية الأميركية تعتمد بصورة أساسية على السوق المحلية، أي على عقود ومشتريات الحكومة الأميركية.
مع التحسن الكبير في الوضعين السياسي والإقتصادي في روسيا في العقد الأول من القرن الحالي، خصوصاً بعد تولي فلاديمير بوتين قيادة البلاد، وتعزز الإستقرار ومستويات النمو الواعدة في الإقتصاد الروسي عشية الأزمة المالية العالمية (بلغت معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام 2008 نسبة 7,5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007)، وامتلاك البلاد لثالث أكبر احتياطي من العملات الأجنبية، والإنخفاض الكبير في دينها الخارجي، والفائض الهائل في الميزان التجاري بفضل صادرات النفط والغاز، وإنشاء صندوق الثروة السيادية بمقدار 141 مليار دولار، ومن ثم عودة روسيا كلاعب أساسي على الساحة الدولية، وانتقالها إلى اتباع سياسة هجومية في مواجهة ما تراه تهديدات لمصالحها الإستراتيجية والجيوسياسية ولأمنها القومي (الحرب مع جورجيا أبرز مثال على النهج السياسي الجديد لروسيا). بعد ذلك كله قررت القيادة الروسية اعتماد زيادة كبيرة في الموازنة العسكرية للبلاد للعام 2009، وأعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن الإنفاق العسكري ينبغي ألا يقل عن 3 % من إجمالي الناتج المحلي.
على هذا الأساس كانت ميزانية روسيا العسكرية العام 2008، أعلى من الإنفاق الفعلي العام 2007، بنسبة 13 % بالأسعار الحقيقية. وقد جرت مراجعة الميزانية أربع مرات خلال السنة التي تلت الحرب مع جورجيا، وتفجر الأزمة المالية العالمية، وهبوط أسعار النفط. وعلى الرغم من الأزمة وعواقبها الشديدة على روسيا، فقد ازدادت ميزانية الدفاع الوطني الرسمية للعام 2009 أكثر من 20 %، أي إلى 1,3 تريليون روبل (حوالى 50 مليار دولار)، وذلك بموافقة مجلس الدوما (وهو المجلس الأدنى في البرلمان الروسي)،علماً أن ميزانية الدفاع الوطني الروسية الرسمية تستبعد الكثير من مواد الإنفاق العسكري، بما فيها معاشات التقاعد والإنفاق على الإسكان والصحة والتعليم وعلى القوات شبه العسكرية وبعض أنشطة البحث والتطوير العسكرية. وهذا ما يفسر جزئياً التناقض الظاهر بين رقم الخمسين مليار دولار للعام 2009، والمعطيات الواردة في الجدول الرقم واحد الوارد أعلاه (58,6 مليار دولار للعام 2008)[14].
على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي كان الإقتصاد الروسي من أكثر الإقتصادات تضرراً من جرائها، تضمن قرار «الدفاع عن الدولة» للفترة ما بين العامين 2009 و2011، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008، جميع الإمدادات للقوات المسلحة وشبه العسكرية، والبالغ مجموعها 4 تريليون روبل (حوالى 142 مليار دولار) على امتداد السنوات الثلاث، بما في ذلك زيادة للعام 2009 تبلغ نسبتها 28 %. وينوي رئيس الوزراء الرئيس فلاديمير بوتين زيادة حصة نفقات التطوير إلى 70 % ضمن الميزانية العسكرية، مقارنة بالعام 2006. كما أن الحكومة الروسية أقرَّت رزمة مساعدة طارئة لتعزيز الصناعة العسكرية الروسية قدرها 5,4 مليار دولار[15].
تعطي القيادة الروسية الأولوية لمسألة إصلاح الجيش الروسي، ولتطوير صناعة الأسلحة وتحديثها، سواء بهدف تأمين أحدث الأسلحة للجيش نفسه، أو لكون هذه الصناعة تشكل مصدراً بالغ الأهمية لتعزيز موارد الدولة المالية. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى دخول الإقتصاد الروسي مرحلة انكماش نتيجة الأزمة المالية العالمية، ولكون هذا الإقتصاد يعتمد إلى حد كبير على تصدير مصادر الطاقة والمواد الأولية، التي انخفضت أسعارها بصورة حادة، فإن القيادة الروسية تعتزم الإبقاء على المستويات العالية للإنفاق العسكري، وعلى خطط إصلاح الجيش الروسي وتحديثه ومده بأكثر أنواع الأسلحة تطوراً.
– الصين
حققت الصين زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، محققة أعلى نسبة نمو بين البلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقاً عسكرياً في العالم خلال الفترة ما بين العامين 1999 و2008 (194 %). وكان لها حصة ضخمة من إجمالي الإنفاق العسكري في شرق آسيا. ويقدر معهد sipri أن إنفاق الصين العسكري بلغ 590 مليار يوان (84,9 مليار دولار) العام 2008، أي بزيادة نسبتها 10 % بالأسعار الحقيقية على ما كان عليه العام 2007. غير أن سياسيين وخبراء عسكريين أميركيين وغربيين يشكِّكون بالأرقام التي تعلنها بكين، ويؤكدون بأن هذه الأرقام لا تعكس الموازنة العسكرية الفعلية للصين، التي تراوح حسب تأكيد وزارة الدفاع الأميركية، بين 97 و139 مليار دولار للعام 2007 (في حين كانت الميزانية الرسمية المعلنة تشير إلى 46 مليار دولار للعام نفسه). في حين أن باحثين غربيين يقترحون رفع الرقم المعلن رسمياً إلى ما بين 40 و70 %، حيث أن الميزانية الرسمية تستثني العديد من البنود المهمة، بما فيها واردات الأسلحة [16].
تظهر المعطيات الواردة في الجدول الرقم واحد، أن الصين تقدَّمت في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على الأغراض العسكرية، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وإن على مسافة بعيدة جداً. وهي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل نمو الإنفاق العسكري خلال الفترة ما بين العامين 1999 و2008، التي يتناولها الجدول. غير أن المحلِّلين الصينيين يقلِّلون من شأن هذه الظاهرة، معتبرين أن وسائل الإعلام الغربية تسعى إلى تضخيم ما تسميه «الخطر الصيني». وقد تناول أحد أبرز الإختصاصيين الصينيين في ميدان الإستراتيجية العسكرية الأدميرال تشان تشاو تشون، هذه المسألة في عدد رأس السنة من صحيفة «هوانتسو شيباو» الصينية. فهو يرى بأن النمو الكبير في الإنفاق العسكري الصيني خلال السنوات الأخيرة، ناجم بالدرجة الأولى عن النقص الكبير في هذا الإنفاق في السنوات السابقة، مقارنة بالولايات المتحدة والبلدان الأخرى المحيطة بالصين، كاليابان والهند وكوريا وتايوان وروسيا، والسعي للتعويض عن هذا النقص. وهو يرى أيضاً أن العدد الكبير جداً لأفراد القوات المسلحة الصينية (المرتبة الأولى في العالم، بعدد يصل إلى مليونين و225 ألف شخص)، لا يشكِّل مؤشراً على القدرة العسكرية للدولة، بقدر ما يدل على تخلُّف الأسلحة التي في حوزة القوات المسلحة الصينية. كما أن كمية الأسلحة، على حد رأيه، لا تشكِّل بدورها مؤشراً على القدرة العسكرية بل على العكس، أن الدليل على قوة الجيوش العصرية أو ضعفه، يتمثَّل في حيازتها أو عدم حيازتها المنظومات العصرية للإدارة والرقابة والإتصالات وجمع المعلومات والإستخبارات، والقدرة على خوض حروب المعلوماتية واستخدام الأسلحة الدقيقة والذكية والنظريات الجديدة لخوض المعارك. ويؤكد أنه لو استخدمنا هذه المعايير لتقييم قدرة الصين العسكرية، فإنها ستبقى حتى العام 2020، من حيث قدرات قواتها المسلحة، في المرتبة الخامسة في العالم، خلف الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وفقط العام 2049، عندما ستحتفل البلاد بالذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية، سترتقي القوات المسلحة الصينية، ربما، إلى المرتبة الثانية في العالم[17].
وقد قدَّمت الصين أيضاً «كتاباً أبيض» حول شؤون الدفاع، يشير إلى أن القسم الأكبر من الإنفاق العسكري المرصود ذهب لتغطية تكاليف الأفراد والأسعار المتزايدة، ولا يتضمَّن التكاليف الفعلية لمشتريات الأسلحة، على الرغم من أن الصين تنفق مبالغ طائلة على حيازة أسلحة محلية وأجنبية، سعياً منها إلى تجهيز قواتها المسلحة لظروف الحرب الحديثة التي «تقوم على المعلومات»، أي الحرب التي تقوم على الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات العالية المستوى، وعلى الأسلحة الدقيقة وتكنولوجيا الإتصالات. وأوجه الإنفاق هذه غير مدرجة في الميزانية العسكرية الرسمية.
– البلدان العربية
لا تقتصر معدَّلات الإرتفاع الكبيرة في الإنفاق العسكري على البلدان الكبيرة والمتقدِّمة، بل أن بلداناً كثيرة نامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية تنفق قسماً كبيراً من ثرواتها الوطنية على اقتناء الأسلحة، وذلك لدواعي حماية الأمن الوطني ومواجهة التهديدات الخارجية الفعلية والمفترضة، وبسبب النزاعات الداخلية والصراعات الإقليمية.. ألخ. وتشير الوقائع والمعطيات المتوافرة إلى أن هذه البلدان هدرت خلال العقود الأخيرة موارد ضخمة على التسلُّح، كان من الممكن أن توجِّهها لمواجهة الفقر والتخلف، ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
أما بالنسبة إلى البلدان العربية، فيقدر تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن العام 2002، أن مجموع إنفاق الدول العربية (باستثناء العراق) يزيد على 60 مليار دولار سنوياً، أكثر من نصفها من نصيب الدول الخليجية. وقد جاء في دراسة نشرها مركز الخليج للأبحاث أن الإنفاق العسكري التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بين العامين 2000 و2005 إلى 233 مليار دولار، أي ما يوازي 70 % من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم العربي، و4 % من الإنفاق العسكري العالمي. وقد أتاحت أسعار النفط المرتفعة للدول الرئيسة المصدرة للنفط إمكان تمويل مشترياتها من الأسلحة. فالمملكة العربية السعودية والجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان، هي من بين الدول التي تكوَّنت لديها أرصدة ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، سمحت لها بالشروع في عمليات شراء واسعة للأسلحة. وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط لاحقاً سيدفع تلك الدول وغيرها في النهاية إلى تقليص الإنفاق العسكري، إلا أن تراكم الدخول من عوائد الصادرات النفطية في فترة فورة الأسعار، أتاح لها الفرصة المالية للتقدم بطلبات ضخمة حتى في العام 2009 [18].
وكما يبيِّن الجدول الرقم واحد، الوارد أعلاه، فإن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر إنفاقاُ على الأغراض العسكرية في العالم العام 2008، واحتلَّت المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (1511 دولاراً للفرد الواحد، مقابل 1967 دولاراً في الولايات المتحدة)، والمركز الأول بين الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقاً عسكرياً، من حيث العبء العسكري (أي نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي). ويجدر بالإشارة في هذا الصدد أن الدول العربية الخليجية تقف في مقدمة دول العالم من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي. ففي سلطنة عُمان راوحت هذه النسبة بين 10,6 % و12,3 % خلال السنوات ما بين 1999 و2007 (10,7 % العام 2007)، وارتفعت إلى 11,04 % العام 2009 (وهي النسبة الأعلى في العالم). وفي السعودية راوحت النسبة بين 8 % و11,5 % (9,3 % العام 2007)، وفي الكويت بين 3,9 % و7,7 % خلال الفترة نفسها (3,9 % العام 2007)، وثمة نسب مشابهة في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. أما اليمن، الدولة الفقيرة بمواردها، فقد راوحت النسبة بين 4,6 % و6,8 %، واستقرت العام 2007 على 5,1 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما بين الدول العربية الأخرى غير الخليجية، فالنسبة الأعلى هي في الأردن، حيث راوحت بين 4,7 % 6,3 % من إجمالي الناتج المحلي لهذا البلد (6,2 % العام 2007)[19]. وللمقارنة فحسب نشير، على سبيل المثال، إلى أن هذه النسبة بلغت في الولايات المتحدة (أكثر الدول إنفاقاً عسكرياً في العالم) 4 % العام 2007، وفي الصين 2 % وفي روسيا 3,5 % [20].
في المقابل تبدو نسب الإنفاق على كل من قطاعي الصحة والتعليم متدنيَّة جداً، مقارنة بالإنفاق العسكري الهائل، مع كل ما في ذلك من انعكاسات سلبية على مستويات التنمية الإقتصادية وفرص تنمية الموارد البشرية وإيجاد رأس المال البشري المؤهل لقيادة عملية التنمية هذه. وعلى الرغم من أن بعض الدول الخليجية نجح في إقامة مستويات جيدة من البنى التحتية المادية والخدمات المعيشية، مقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلا أن النظامين الصحي والتعليمي فيها، ما يزالان دون مستويات البلدان المتقدمة إلى حد كبير. وما يزال النظام التعليمي قاصراً عن خلق رأس المال المعرفي، المؤهل لمواكبة المستويات الحديثة لتقدم العلوم والمعرفة في عصرنا. وعلى الرغم من أن الإمكانات المالية للدول الخليجية كافية لتأمين متطلبات تحقيق هذا الهدف، فترجيح الإنفاق العسكري بهذا الشكل الصارخ على الإنفاق في مجالي التعليم والصحة، اللذين هما من أهم عوامل التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة، يحرم البلاد من فرص تنمية تحقيق قفزة نوعية في هذا الإتجاه على غرار ما حقَّقته دول أخرى، كبلدان جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. علماً أن إنفاق الدول الخليجية العسكري، شأنها شأن الدول العربية الأخرى، هو في الواقع خصم من عملية التنمية، لأن هذه البلدان تعتمد على استيراد كل ما تحتاج إليه من أسلحة، وليس بينها دولة واحدة تملك صناعة فعلية للأسلحة، باستثناء بعض الصناعات التجميعية وصناعة الذخائر وبعض قطع الغيار في عدد محدود من الدول العربية. وذلك على عكس الدول المتقدمة، أو دولة كإسرائيل (إذ تبلغ صادرات هذه الأخيرة من الأسلحة قرابة 12 مليار دولار سنوياً)، التي تشكَّل فيها صناعة الأسلحة ومبيعاتها للخارج، بنداً أساسياً من بنود صادراتها ومصدراً مهماً من مصادر الإضافات إلى الدخل الوطني، وتغذية الصناعات المدنية بالتكنولوجيا المتقدمة.
كثيراً ما تكون مشتريات الأسلحة في بعض الدول العربية، الخليجية منها بصورة خاصة، خاضعة لدوافع وأسباب أوضغوطات سياسية خارجية، من باب توطيد العلاقات والتحالفات مع دول كبرى، كالولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، حيث تلجأ تلك الدول إلى عقد صفقات عسكرية ضخمة في لحظات سياسية معينة، تتضمَّن تجهيزات وأنواع معينة من الأسلحة البالغة التطور، ثمة شكوك في أن تكون قواتها المسلَّحة قادرة على استيعابها أو مضطرة إلى استخدامها في يوم من الأيام. كما أن هذه المشتريات تكون أحياناً نابعة من دوافع تتعلَّق بتعزيز الموقع السياسي للدولة وهيبتها ونفوذها (البرستيج السياسي)، أكثر مما تكون لأسباب تتعلق بتعزيز أمن البلاد وحمايتها من الأخطار الخارجية.
3) بين الإنفاق العسكري وفرص التنمية
ثمة علاقة عكسية بين وتائر ارتفاع الإنفاق العسكري والتنمية الإقتصادية. فثمة دراسة لأحد الخبراء الأوروبيين نشرت في صحيفة «هانديلسبلات» الألمانية في 13 تشرين الأول/أوكتوبر 2002، تشير إلى أن زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1 % فقط من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، يمكن أن تؤدي خلال خمس سنوات إلى تراجع قدرات الإقتصاد الوطني بنسبة 0,7 %. كما أن التنافس في تطوير أسلحة جديدة يساهم بشكل مذهل في استنزاف موارد المجتمع. فعلى سبيل المثال، فإن التكلفة المرتبطة بإنتاج غواصة نووية واحدة، تساوي ميزانية التعليم السنوي لأكثر من 26 بلداً نامياً فيها 180 مليون طفل في سن الدراسة. وفضلاً عن ذلك، فإن الإنفاق العسكري العالمي يفوق ستة أضعاف خدمة الديون الخارجية للبلدان النامية، ومن شأن تخفيض هذا الإنفاق أن يوفر على نطاق واسع الموارد اللازمة لإحراز تقدم سريع نحو حل المشكلات العالمية، كالفقر والجوع والتخلف.
كما أن الإنفاق العسكري المتصاعد، الذي يكون أحياناً وفي جزء أساسي منه، من دون مبرِّرات حقيقية، يؤدي إلى اقتطاع قسم كبير جداً من الموارد المتاحة، خصوصاً في البلدان النامية، والتي يمكن أن تخصَّص للإنفاق على القطاعات الإقتصادية المنتجة وعلى تطوير البنى التحتية المادية والإجتماعية، بما يؤدي إلى دفع عملية «تنويع الإقتصاد» قدماً، أي توسيع قاعدته وتنويع بنيته الإنتاجية، والخروج من دائرة الإقتصاد الأحادي الجانب، القائم أساساً على قطاع النفط والغاز وانتاج المواد الأولية، في بعض البلدان، أو الصناعات الخفيفة في بلدان أخرى، وإلى حد ما على الخدمات في حالات معيَّنة. كما أنه يحرم المجتمع من جزء من الثروة الوطنية يمكن أن يُنْفَق في مجالات تطوير النظام التعليمي وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين. كما أن تطوير الإنتاج العسكري في البلدان التي تصنع الأسلحة، يوجه قسماً كبيراً من أفضل القدرات والكفاءات العلمية والإنتاجية للعمل في القطاع الصناعي العسكري، حارماً قطاعات الإنتاج المدني منها، فتعمل أفضل العقول البشرية في ابتكار أسلحة التدمير والإبادة واختراعها وتطويرها. ويترافق تطوُّر الإنتاج الصناعي العسكري مع هدر موارد ومواد أولية طائلة تتحوَّل إلى أسلحة، لا يستفيد منها المجتمع، لا بل تساهم في تدميره عند نشوب الحروب والنزاعات المسلحة.
فالتنمية البشرية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، والتعليم هو أحد أهم مقوِّمات هذه التنمية. ولا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية إلا بوجود فئة متعلِّمة تواكب التطوُّر العلمي والمعرفي وتقود عملية التنمية الشاملة في المجتمعات. إن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلَّب حيازة المعرفة. ولهذه الغاية على الحكومات أن تستثمر في تأهيل العاملين في مجال المعرفة، أي أن تخصِّص الميزانية اللازمة والبيئة المناسبة لتطوير أنظمة التعليم وتنمية المهارات. فالدولة الحديثة هي التي تموِّل المؤسسات التعليمية، وتشجِّعها على تغيير مناهج التعليم كلما دعت الحاجة، وهي التي تدعو تلك المؤسسات التعليمية إلى تغيير أهدافها من مؤسسات تُدَرِّس مناهج معيَّنة إلى مؤسسات تعلِّم الطالب كيف يدرس ويفكر ويجدد، ما يسمح له بفهم التطورات والمستجدات كلها واستيعابها. والإنفاق المبالغ فيه على الأغراض العسكرية يشكل عائقاً جدياً أمام تحقيق هذه الأهداف، فضلاً عن أن عمليات التسلح الضخمة في البلدان النامية تشكل أداة استنزاف كبيرة لموارد هذه البلدان كونها تؤدي إلى تحويل أموال هائلة إلى أغراض غير منتجة، وإلى تحويل قسم كبير من أفضل الكوادر البشرية وأصحاب الكفاءات والشرائح الأكثر حيوية وتعليماً في المجتمع إلى قطاع غير منتج.
والأخطر من ذلك كله هو تدمير رأس المال البشري نتيجة الحروب والنزاعات، والقضاء أحياناً على هذا الرأسمال الكامن في أجيال من البشر، ما يشكِّل عائقاً هائلاً أمام تقدُّم البشرية. خلاصة القول، إن عمليات التسلُّح تشكِّل أداة استنزاف كبرى لموارد المجتمعات، لأنها تتسبَّب في تحويل موارد هائلة إلى أغراض غير منتجة، وإلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية للبلدان النامية، التي تبقى عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل الأجيال الحالية والقادمة. وهنا تتجسَّد العواقب المدمِّرة لتزايد الإنفاق العسكري وسباق التسلح، في حين تعاني غالبية البلدان (النامية بصورة خاصة) الأزمات الاقتصادية والتطور غير المتوازن، والنقص الهائل في الإمكانات المادية الضرورية لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية عموماً.
عند الحديث عن أثر الإنفاق العسكري على النمو الإقتصادي لا بد من الإشارة أيضاً إلى تأثيره على معدلات التضخم. فمن المعروف أن لهذا النوع من الإنفاق طبيعة تضخمية، وأنه يؤدي إلى تغيُّر في المستوى العام للأسعار، وإلى ارتفاع معدَّلات التضخم، وإعادة توزيع الدخل الوطني، وما يستتبعه ذلك من سوء تخصيص للموارد وتشوُّهات في الإقتصاد الوطني.
على الرغم من هذه الصورة الواضحة، والكالحة، لعواقب تزايد الإنفاق العسكري، فثمة من يحاول التركيز على ما يعتبره جوانب إيجابية في عملية التسلُّح وزيادة الإنتاج العسكري وتطوُّر المجمع الصناعي العسكري، خصوصاً في البلدان الكبيرة والمتقدمة. ومن الحجج التي تطرح في هذا السياق، الإشارة إلى مراحل شهدت فيها البلدان الكبرى خلال القرن العشرين، حالات من النمو الإقتصادي في ظل مستويات عالية من الإنفاق العسكري. من الأمثلة على ذلك النمو الذي شهده الإقتصاد الأميركي في فترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحقبة الحرب الباردة، والنمو الذي شهدته كل من اليابان وألمانيا خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما بلغت عسكرة الإقتصاد والمجتمع في هذين البلدين الذروة. وكذلك وتائر النمو العالية التي شهدها الإتحاد السوفياتي في الفترة ما بين العام 1930 وعام نشوب الحرب العالمية الثانية، وفي حقبة الحرب الباردة وصولاً إلى العام 1970.
ويعلِّل هؤلاء المحلِّلون حججهم على النحو الآتي:
1. يؤدي تطور المجمع الصناعي العسكري إلى خفض البطالة في المجتمع نتيجة استيعابه عشرات الآلاف من العاملين في قطاعاته المختلفة، ما يفضي بالتالي إلى زيادة الطلب الكلي في المجتمع، الأمر الذي يساهم في تطور القطاعات المدنية من الإقتصاد. ولكن يمكننا القول هنا إن برامج الإنفاق المدنية على الحاجات الإجتماعية، يمكنها هي أيضاً أن تساهم في انخفاض مستوى البطالة، وأن تحفز ارتفاع مستوى النمو الإقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
2. تساهم النفقات العسكرية في تطوير التكنولوجيا التي يمكن أن تؤدي بدورها في حال استخدامها في القطاعات المدنيَّة إلى تطور الإقتصاد ونموه. ويشيرون في هذا السياق إلى الإنترنت وتكنولوجيا المعلوماتية والمحرك الصاروخي واللازر، وغيرها. وكلها اختراعات وتطويرات ظهرت بداية في القطاع العسكري، ثم انتقلت إلى القطاعات المدنية في مراحل لاحقة. ولكن ينسى هؤلاء المحلِّلون أن سنوات طويلة تفصل بين بدء استخدم نتائج التطوُّر العلمي والتكنولوجي في القطاع العسكري، والسماح بإدخالها جزئياً إلى القطاعات المدنية، ما يضيع على البشرية سنوات ثمينة من فرص التطور. كما أن الكثير من الإختراعات تبقى سرية ولا يسمح بالإستفادة منها مدنياً على الإطلاق، وبالتالي لا يستفيد المجتمع منها أبداً. ويلاحظ المؤرخ توماس إي وودز Thomas E. Woods، في هذا الخصوص أنه في فترة ما بين الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، كان ما بين ثلث وثلثي مجمل المواهب البحثية في الولايات المتحدة الأميركية تتركز حصراً في القطاع العسكري[21]. ومن المستحيل، بالطبع، معرفة ماهية الابتكارات التي لم يقيَّض لها أن تظهر أو أن تستخدم في القطاعات المدنية، نتيجة هذا التحويل للموارد والقوى المعرفية لتصب في خدمة الإنتاج العسكري وحده.
3. يؤكد أنصار الإنفاق العسكري بأنه يمكن أن يساهم في تطوير البنى التحتية، من وسائل اتصالات ومواصلات وما شابه. ونقول في المقابل أن لا شيء يمنع من إقامة هذه البنى التحتية بجهود القطاع المدني والإنفاق على الحاجات الإجتماعية.
4. أما بخصوص رأس المال البشري فيؤكِّد دعاة تطوير القطاع العسكري أنَّه يساهم في تطويره والحفاظ عليه، وفي صنع أجيال ممن يحملون المعرفة الضمنية التي تتحوَّل إلى رأس مال فكري يمكن أن أن يساهم في تعزيز الثروة المعرفية الوطنية، وفي إيجاد ميزات تنافسية جديدة تقوم على تحويل المعرفة إلى عنصر رئيس من عناصر الإنتاج. ونحن نرى في المقابل أن البرامج المدنية قادرة أكثر على تطوير الموارد البشرية للمجتمع، وإعداد الكوادر التي يحتاج إليها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
5. يقول أنصار زيادة الإنفاق العسكري أن ذلك يؤمن قيام جيش وطني قوي يدافع عن أمن البلاد ويحمي مصالحها، ويواجه التهديدات الخارجية والداخلية. فضمان أمن البلاد يحفز بحد ذاته النمو الإقتصادي ويحمي المجتمع. لا ضير في هذا الكلام إطلاقاً، المهم أن يكون الإنفاق العسكري للبلد المعني في الحجم والحدود التي تؤمن الأهداف المذكورة، بحيث لا تدخل البلد في سباق تسلح لا طائل منه ويمكن أن يدمر أسس وحدتها الوطنية ومقومات استمرارها. وانهيار دولة عظمى كالإتحاد السوفياتي أبرز مثال على ذلك، حيث أدى انخراط هذه الدولة، التي كانت بمنزلة أمبراطورية مترامية الأطراف، في سباق تسلح مكلف استنزف قدراتها ومواردها الإقتصادية والمالية والمادية والبشرية، إلى تفكِّكها وسقوطها المريع كبناء كرتوني هش.
4) «الكينزية العسكرية»؟!
إن الحجج المذكورة آنفاً بشأن التأثير «الإيجابي» للإنفاق العسكري، تجد لها أنصاراً بين أصحاب القرار في الولايات المتحدة. وهي تكّون بمجملها ما يشبه نظرية جديدة، ظهر من يطلق عليها اسم «الكينزية العسكرية». ونحن نعلم بأن جوهر النظرية الإقتصادية الكينزية يتلخَّص في ضرورة تدخُّل الدولة في الإقتصاد، باستخدام الأدوات والضوابط والقوانين الضرورية لضبط آلية عمل السوق والحد من عفويته، ومن الفوضى التي يمكن أن تعم فيه نتيجة العمل العشوائي وانفلات المضاربات، وتخطِّي القوانين في ظل الليبرالية المفرطة. ظهرت هذه النظرية بعد أزمة «الكساد العظيم» في بدايات الثلاثينيات من القرن العشرين، وها هي تعود للعمل اليوم بعد الأزمة المالية والإقتصادية العالمية الخطيرة التي عصفت بالإقتصاد الأميركي والنظام المالي العالمي في العامين الأخيرين، ومجدداً بسبب السياسات النيوليبرالية المفرطة المتبعة منذ عهد ريغان. فتضطر الإدارة الأميركية وحكومات البلدان الأوروبية إلى التدخل بقوة في الإقتصاد اليوم، من أجل إنقاذ الإقتصاد العالمي من أزمة قد تتجاوز بعواقبها الكارثية أزمة «الكساد العظيم».
يستعير دعاة «الكينزية العسكرية» من النظرية الكينزية مسألة تدخل الدولة، ولكن هذه المرة في استخدام الإنفاق العسكري كوسيلة من وسائل حفز النمو الإقتصادي، على حد رأيهم. فعلى عكس الإعتقاد السائد بأن أعباء الإنفاق الهائل على الحربين في العراق وأفغانستان كانت من بين الأسباب التي ساهمت في دخول الإقتصاد الأميركي أزمته الراهنة، يعتقد هؤلاء بأن الإنفاق العسكري ساهم في الحد من تداعيات أزمة الرهن العقاري. فتقول جانيت إيلين، رئيسة دائرة الإحتياط الفيدرالي في سان فرنسيسكو، في كلمة ألقتها في 6 شباط/فبراير من العام 2008، استطاعت النفقات العسكرية «ولو جزئياً التخفيف» من الإنهيار في السوق العقارية. ويشير الإقتصادي الأميركي نوريل روبين أيضاً، في معرض تقويمه أداء الإقتصاد الأميركي في نهاية العام 2006، إلى أن «النفقات الحكومية ارتفعت بنسبة 3.7 % بالدرجة الأولى، بفضل الزيادة السخيَّة في النفقات الدفاعية التي بلغت 11,9 %».
ويعتبر دعاة «الكينزية العسكرية» أن الإنفاق العسكري يمكن أن يؤدي دور مخفِّف الصدمات والأداة التي تمتص تداعيات الأزمات، وبذلك فإنه يشكل «الملاذ الآمن» للمستثمرين خلال الأزمات المالية والإقتصادية. ويقدِّمون مثالاً على ذلك ما حصل خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي أحدثت انكماشاً اقتصادياً على المستوى العالمي، وقادت إلى خسائر كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية (كصناعة السيارات، على سبيل المثال)، متحوِّلة إلى أزمة اقتصادية عالمية بعد انتقالها من الإقتصاد الوهمي إلى الإقتصاد الحقيقي. فقد بقي قطاع صناعة الأسلحة في منأى من تداعيات هذه الأزمة، وظل محافظاً على إنتاجيته وعلى القوى العاملة فيه وعلى قدراتها الشرائية، الأمر الذي خفَّف إلى حد كبير من تداعيات الأزمة.
ولكن في الواقع، لقد حدث ذلك بصورة أساسية، لأن صناعة الأسلحة تعتمد أساساً على ما تنفقه الدولة مقابل عائداتها، وليس على ما ينفقه المستهلكون أو المؤسسات الخاصة. وبالتالي فإن استجابتها للأوضاع الإقتصادية العامة تختلف عن استجابة الصناعات المدنية. يضاف إلى ذلك أن فترات الإنجاز الطويلة الأمد المرتبطة بإجراءات اقتناء الأسلحة، تميل إلى زيادة استقرار عائدات صناعة الأسلحة وإمكان التنبؤ بها، بصرف النظر عن الأزمات التي يمكن أن تضرب اقتصادات بلدان معينة، أو الإقتصاد العالمي عموماً. ففي الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى الأخرى (روسيا، مثلاً، أو بعض الدول الأوروبية)، لم تتراجع عائدات الشركات المصنعة للأسلحة وأرباحها خلال الأزمة لكونها ظلَّت مرتبطة بالإنفاق العسكري الأميركي العالي المستوى، وبالميزانيات العسكرية الأوروبية المستقرة أو المرتفعة، وبالسياسة الدفاعية الجديدة التي تتبعها القيادة الروسية، وكذلك بطلبيات الأسلحة لدول عديدة. فلدى معظم الشركات الكبرى المنتجة للأسلحة احتياط كبير من الطلبيات، التي تدل على أن العائدات ستظل عالية في السنوات المقبلة، في ظل تزايد الإنفاق العسكري على المستوى العالمي. وعلى الرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن بعض الشركات المصنعة الأسلحة أصابته شظايا الأزمة، كون هذه الشركات لديها أنشطة كبيرة أيضاً في مجال الصناعات المدنية، خصوصاً تلك الشركات التي تصنع في الوقت نفسه الطائرات المدنية، مثلاً، أو المركبات والتجهيزات الأخرى للقطاعات المدنية المختلفة.
وهكذا، يعلن أنصار نظرية «الكينزية العسكرية» أن النفقات العسكرية تشكل عاملاً هاماً من عوامل «الإستقرار» في الإقتصاد الأميركي، على الرغم من أن أهمية هذا العامل نادراً ما تؤخذ بعين الإعتبار في التعويض عن سياسة سعر الفائدة التي يعتمدها الإحتياطي الفيدرالي الأميركي. ويؤكدون بأن النفقات العسكرية العالية كانت خلال عقود من الزمن تشكل عامل استقرار في اقتصاد الولايات المتحدة، على الرغم من أن وظيفتها المخففة للصدمات لم تكن تبرز بوضوح إلا في حالات الأزمات الحادة، عندما يجري بواسطتها كبح الإنهيار الكارثي في الإقتصاد. لقد غدت الموازنة العسكرية جزءاً مركزياً من النظام الإقتصادي الأميركي.
كان تشالمرز جونسون، رئيس معهد دراسات السياسة اليابانية، أول من استخدم مفهوم «الكينزية العسكرية»، غير أنه، خلافاً للآخرين، استخدم هذا المصطلح في معرض انتقاده الإنفاق العسكري المفرط، وتبيان آثاره الكارثية على الإقتصاد الأميركي نفسه. فقد كتب يقول: «إن تدفق الثروة الوطنية – من دافعي الضرائب، وبوتيرة متصاعدة من المقرضين الأجانب عبر الحكومة، إلى المجمع الصناعي العسكري – ثم عودتها، وإن بوتيرة متناقصة، إلى دافعي الضرائب، تولد ما يسمى نموذج «الكينزية العسكرية» التي يحتاج بموجبها الإقتصاد الوطني، من أجل تجنب الركود والإنهيار، إلى استخدام المكون العسكري لفترة طويلة من الزمن». ويضيف: «لم تأت نفقاتنا العسكرية المفرطة نتيجة أداء بضع سنوات قصيرة فحسب، أو ببساطة بسبب سياسات إدارة بوش. لقد كانت مستمرة على هذا النحو لوقت طويل جداً في إيديولوجية معقلنة اصطناعياً، والتي أصبحت الآن جداً متخندقة في نظامنا السياسي الديمقراطي حتى أنها بدأت تحدث الإضطراب. تلك هي ما يدعى الكينزية العسكرية، التي هي التصميم على خلق اقتصاد حرب دائم، ومعاملة الناتج العسكري باعتباره ناتجاً اقتصادياً عادياً، حتى ولو أنه لا يقدم أي إسهام لا للإنتاج ولا للإستهلاك»[22].
في أواسط العام 2007، أذيعت في مركز الأبحاث السياسية والإقتصادية في واشنطن دراسة أعدتها شركة الإعلام السياسي «غلوبال إنسايت» حول التأثير الإقتصادي البعيد المدى للإنفاق العسكري المتزايد. وقد كشفت هذه الدراسة التي أشرف عليها دين بيكر Dean Baker، عن أن الإنفاق العسكري يمارس تأثيراً محفزاً ومشجعاً للطلب الأولي في البداية، ولكن بحلول السنة السادسة تقريباً، فإن تأثيره المتزايد يتحول إلى سالب. وقد ترتب على اقتصاد الولايات المتحدة أن يتكيَّف مع الإنفاق العسكري المتزايد لأكثر من ستين عاماً. وقد وجد بيكر أنه بعد عشر سنوات من الإنفاق العسكري الأعلى، فإنه سيكون هناك عدد وظائف أقل بمقدار 464000 وظيفة من سيناريو آخر تضمن إنفاقاً عسكرياً أقل. ويخلص بيكر إلى الإستنتاج الآتي: «يُعتقد غالباً بأن الحروب وزيادة الإنفاق العسكري هي أشياء جيدة للإقتصاد. وفي الحقيقة، فإن معظم النماذج الإقتصادية يكشف عن أن الإنفاق العسكري يحوِّل اتجاه الموارد عن الإستخدامات المنتجة، مثل الإستهلاك والإستثمار، ويفضي في نهاية المطاف إلى خفض سرعة النمو الإقتصادي ويقلل من حجم العمالة»[23]. ويضيف تشالمرز جونسون، ملخصاً أقوال دين بيكر، قائلاً: «ليست هذه سوى بعض الآثار المدمرة للإيديولوجية الكينزية العسكرية»[24].
ما من إنسان عاقل ينفي ضرورة تخصيص جزء من الثروة الوطني في أي بلد من بلدان العالم لأغراض حماية البلاد وصيانة أمنها الوطني واستقرارها، ودفع الأخطار والإعتداءات المحتملة التي يمكن أن تتعرَّض لها. لا بل أن هذه المسألة تعتبر قضية وطنية مصيرية كبرى لا يجوز المساس بها، أو التقليل من أهميتها. ولكن المسألة تكمن في الحدود التي تتوقَّف عندها عملية الإنفاق العسكري، بحيث لا تصبح عبئاً يثقل كاهل الإقتصاد الوطني والمجتمع عموماً. فحتى في بلد كبير كالولايات المتحدة، باقتصادها الذي ما يزال يعتبر الأكبر والأقوى في العالم، فإن المبالغ الفلكية التي تنفق على الأغراض العسكرية، خصوصاً مع خوض الحروب على أكثر من جبهة، تشكل حسب رأي الكثير من المحللين والمتابعين لحالة الإقتصاد الأميركي اليوم، سبباً أساسياً من أسباب الأزمة الكبرى التي يدخل أتونها اليوم، و يجر معه الإقتصاد العالمي إليها.
إن النفقات الفعلية على «الأمن القومي» الأميركي تتجاوز كثيراً حدود الموازنة العسكرية الرسمية، الضخمة أصلاً. فنفقات تطوير الأسلحة النووية تمر عبر وزارة الطاقة، ونفقات بناء المساكن للعسكريين عبر وزارة البناء، وأموال معاشات التقاعد للعسكريين عبر وزارة المالية، ونفقات الخدمات الصحية للعسكريين السابقين عبر هيئة شؤون قدامى المحاربين. وإذا أضيفت مخصصات أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات وغيرها من الهيئات التي لا تخضع للبنتاغون، فيتبيَّن أن مجمل النفقات الرامية إلى ضمان الأمن القومي الأميركي تتجاوز حدود التريليون دولار سنوياً.
يورد تشالمرز جونسون في مقالته المذكورة آنفاً المعطيات الآتية، فيقول بإن الحكومة ظلت لوقت طويل تخفي نفقات رئيسة متصلة بالجيش في وزارات غير وزارة الدفاع. فعلى سبيل المثال، يذهب مبلغ 23,4 مليار دولار من ميزانية وزارة الطاقة إلى تطوير الرؤوس الحربية وصيانتها، ويذهب 25,3 مليار دولار من ميزانية وزارة الخارجية لتنفق على المساعدات العسكرية الخارجية. وثمة حاجة إلى 1,03 مليار دولار من خارج الميزانية الرسمية لوزارة الدفاع من أجل تشجيع التجنيد وتقديم الحوافز لإعادة الإنخراط في الجيش الأميركي المنتشر بشكل واسع، وهو المبلغ الذي ارتفع من 147 مليون دولار العام 2003، عندما بدأت الحرب على العراق. وتحصل وزارة شؤون المتقاعدين حالياً على مبلغ 75,7 مليار دولار على الأقل، 50 % منها تذهب لأجل العناية الطويلة الأمد بالمصابين لإصابات بالغة. وهناك 46,4 مليار دولار تذهب إلى وزارة الأمن القومي[25].
إن «الكينزية العسكرية» في الولايات المتحدة تعمل على وجهين: فهي، أولاً، تؤمن العمل الكلي أو الجزئي لقرابة 2,5 مليون عسكري، وما يتطلبه ذلك من شراء السلع والخدمات «من المورِّد مباشرة» عبر البنتاغون. هذه هي الطريق التقليدية. أما الجزء الآخر من النفقات العسكرية، فيصل إلى المؤسسات الإنتاجية الخاصة (المقاولين) التي تسلم السلع والخدمات لحساب البنتاغون، ولكن بصورة غير مباشرة.
تتطوَّر «الكينزية العسكرية» الأميركية كمنظومة علاقات تعايشية بين الدولة (بشقيها التنفيذي والتشريعي) من جهة، والقطاع الخاص (المنتجين والمقاولين) من جهة أخرى. ويمارس عالم الأعمال الذي يقدم الخدمات للمجال العسكري، تأثيراً مباشراً على العملية السياسية من خلال المبالغ الطائلة التي تدفع في الحملات الإنتخابية. كما أنه يضمن وظائف مغرية للسياسيين بعد تقاعدهم، أو في فترات خروجهم المؤقت من الساحة السياسية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العسكريين وكبار الموظفين المحالين على التقاعد. وبالتالي، فإن ثمة تشابك علاقات معقداً بين عالمي السياسة ورأس المال (أبرز من يجسد هذا التشابك نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، الذي كان في الفترة ما بين العامين 1992 و2000 رئيساً لمجلس إدارة شركة هاليبرتون، إحدى أكبر الشركات المقاولة المتعاملة مع البنتاغون). إن هذا التشابك يساهم في ازدهار رأس المال العامل في الميدان العسكري، وفي ترسيخ مواقعه في البنيتين السياسية والإقتصادية للبلاد، وفي تعزيز الفكرة القائلة بأن ذلك يساهم في «استقرار الإقتصاد» وتجنيبه الأزمات.
لقد حذَّر الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور العام 1961 من خطر هذا التشابك، ومن الدور الذي يضطلع به المجمع الصناعي العسكري، على الولايات المتحدة وعلى اقتصادها. وفي الواقع فإن «الكينزية العسكرية» بالمعنى الذي شرحناه، توجِد اليوم قدراً متناقصاً من القيمة الفعلية ومن فرص العمل، ولا يمكن أن تؤمن استقراراً طويل الأمد في الإقتصاد الأميركي. وواقع الأزمة المتواصلة التي تعصف بهذا الإقتصاد اليوم، من أزمة الرهونات العقارية إلى الأزمة المالية الأخطر منذ حوالى القرن، والتي تهدد بالتحول سريعاً إلى أزمة إقتصادية عالمية شاملة تضرب أسس النظام الرأسمالي نفسه، أوضح دليل على ذلك.
[1]- د. طلال محمود كداوي، الإنفاق العسكري الإسرائيلي 1965 – 1990، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997، ص 38 – 39.
[2]- Sharp and Olson, Public Finance The Economics of Government Revenues and Expenditures, pp. 65-66,
ورد هذا الإقتباس في: د. طلال محمود كداوي، الإنفاق العسكري الإسرائيلي، ص 39.
[3]- التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليين، الكتاب السنوي 2009 (الطبعة العربية)، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي sipri، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص 307-308.
[4]- د. طلال محمود كداوي، الإنفاق العسكري الإسرائيلي، مصدر سابق، ص 48 - 56.
[5]- التسلح ونزع السلاح والسلام الدوليين... مصدر سابق. ص 31.
[6]- المصدر نفسه، ص 265 – 266.
[7]- المصدر نفسه، ص 267.
[8]- DoD Readies, «$80 Billion Supplemental Request» Forecast International (25 november 2008) ورد هذا الإقتباس في الكتاب السنوي لمعهد سيبري المذكور آنفاً، ص 268
[9]- US Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2009 to 2010, Washington, DC, US Congress, 2008, pp.13,1
[10]- التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليين، مصدر سابق، ص 275.
[11]- British House of Commons, Hansard, 8/7/2008, Columns 1457W ,and Agence france-Press,
«Wars to Cost Britain 12 Billion Pounds by 09», Defense News (8 July 2008)
ورد هذا الإقتباس في: التسلح ونزع السلاح الدوليين، مصدر سابق، ص 277.
[12]- التسلح ونزع السلاح الدوليين، مصدر سابق، ص 278.
[13]- المصدر نفسه، ص 279 – 280.
[14]- المعطيات الوارد على موقع وزارة المالية الروسية: /http://www1.minfin.ru/budget//federal_budget (باللغة الروسية).
وكذلك: الكتاب السنوي لمعهد سيبري، التسلح ونزع السلاح الدوليين، مصدر سابق، ص 280 – 283.
[15]- وردت هذه المعلومات في الكتاب السنوي لمعهد سيبري المذكور آنفاً، ص 281، نقلاً عن: صحيفة «النجم الأحمر» الروسية، عدد 8 تموز/يوليو 2008 (باللغة الروسية)، وكذلك صحيفة «كوميرسانت» الروسية، عدد 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 (باللغة الروسية).
[16]- انظر على سبيل المثال: US Department of Defense (DOD), Military Power of the People’s Republic of China 2008, Annual Report to Congress, Washington, DC:DOD, 2008).
[17]- http://www.ng.ru/scenario/2010-01-25/15_china.html
[18]- التسلح ونزع السلاح الدوليين، مصدر سابق، ص 464.
[19]- المصدر نفسه، ص -357 358.
[20]- المصدر نفسه، ص 264.
[21]- Thomas E Woods,”What the Warfare State Really Costs” http://www.lewrockwell.com/woods/wo
[22]- تشالمرز جونسون (Chalmers Johnson) هو مؤلف كتاب «المحاكاة: الأيام الأخيرة للمدنية الأميركية» (2007)، وهو الجزء النهائي من ثلاثية تتضمن كتابيه"الضربة الإرتدادية"(2000) و"أحزان الأمبراطورية"(2004). نشرت دراسته حول"الكينزية العسكرية"في مجلة «لوموند ديبلوماتيك»، بعنوان:”الكارثة الإقتصادية هي الكينزية العسكرية. لماذا تتجه الولايات المتحدة نحو الإفلاس»، شباط 2008. من هذه المقالة أخذنا الإقتباس المذكور آنفاً.
[23]- Center for Economic and Policy Research, 1 May 2007 http://www.cepr.net/content/view/11
[24]- أنظر مقالة تشالمرز جونسون المذكورة آنفاً في لوموند ديبلوماتيك.
[25]- المصدر نفسه.
Dialectics of the relation between military spending
International development is characterized nowadays with a special feature represented in the overgrowing increase in military spending in most countries to the extent that it started to take a heavy toll on the budgets of States, whether big or small, and a deterrent to economic developments in these states. Many economic analysts consider that the burdens of the wars in Afghanistan and Iraq are the main reasons which led to striking the U.S economy starting 2007 and was later transformed into an international financial and economic crisis that reminds us of “the Great Recession” in the early thirties of the last century.
The economic boom witnessed by the international economy in the nineties is the direct result to the end of the Cold War since a primary part of the money spent on the arms race was redirected to developing the social and financial infrastructure. However, that golden phase did not last for long because the end of the Cold War did not bring ultimate peace around the globe. In a short time, differences flared up between different countries, conflicts spread and wars broke out whether between big countries or between developing countries especially in Asia and Africa.
This study aims at discovering the effect of military spending over economic development and therefore we shall divide this research to four parts:
1 – the first part tackles the concept of military spending and the active factors affecting the determination of its level.
2 – the second part includes a review of the increase in military spending around the globe especially in some big countries based on information listed in the annual book issued by the Stockholm Academy for International Peace Researches.
3 – the third part discusses the problematic in the relation between military spending and economic development.
4 – the forth part tackles a new concept launched by the positive thinking heralds, especially in the United States, concerning military spending and its effect as an incentive for economic development.
La dialectique de la relation entre les dépenses militaires et le développement économique
Le développement international est caractérisé aujourd’hui par une section spéciale représentée par l’augmentation des dépenses militaires dans la plupart des pays dans la mesure où il a commencé à se ressentir sur les budgets des Etats et à leur évolution économique. De nombreux analystes économiques estiment que le fardeau des guerres en Afghanistan et en Irak sont les principales raisons qui ont conduit à la suppression de l’économie américaine à partir de 2007 et a ensuite été transformée en une crise financière et économique internationale qui nous rappelle “la Grande Récession” au début des années trente du siècle dernier.
Le boom économique enregistré par l’économie internationale dans les années nonante est le résultat direct de la fin de la guerre froide, à commencer par une part essentielle de l’argent dépensé pour la course aux armements qui a été redirigé vers le développement des infrastructures sociales et financières. Cependant, cette phase d’or n’a pas duré longtemps, car la fin de la guerre froide n’a pas apporté la paix ultime dans le monde entier. En peu de temps, les différences ont éclaté entre les différents pays, la propagation des conflits et des guerres ont éclaté que ce soit entre les grands pays ou entre les pays en développement en particulier en Asie et en Afrique.
Cette étude vise à découvrir l’effet des dépenses militaires sur le développement économique et, par conséquent, nous diviserons cette recherche en quatre parties:
1 - la première partie aborde la notion de dépenses militaires et les facteurs actifs affectant la détermination de son niveau.
2 - la deuxième partie comprend un examen de l’augmentation des dépenses militaires dans le monde entier en particulier dans certains grands pays sur la base des informations figurant dans le recueil annuel publié par l’Académie de recherches de Stockholm pour la paix internationale.
3 - la troisième partie traite la problématique dans la relation entre les dépenses militaires et le développement économique.
4 - la quatrième partie aborde un nouveau concept lancé par les hérauts de la pensée positive, en particulier aux États-Unis, au sujet des dépenses militaires et son effet d’incitation sur le développement économique.