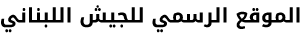- En
- Fr
- عربي
قصة قصيرة
قال ابن الرومي:
عدوُّكَ من صديقِكَ مُستَفادٌ فلا تستكثرَنَّ منَ الصِحابِ
أجل، كم صديق انقلب عدوًّا لدودًا؛ فحلّ الجفاء والبغضاء محلّ الإلفة والوداد!!
لكنّ صديقي الذي مات لم يُسئ التصرّف معي يومًا، ولم ألقَ منه إلا السلوك الحسن والعشرة الطيّبة. أحيانًا كنت أزعل منه. أزعل ولا أغضب. وأكثر ذلك عندما كنت أترك قلمي وأوراقي على الطاولة وأذهب لبعض شأني، ثم أعود بعد قليل لأراه قد عبث بها وأوقعها على الأرض فتناثرت في كلّ اتّجاه. أو عندما يخرج من باب بيتي ثم يعود وقد علق بشَعره الطويل قشّ وشوك، فآخذه بين يديّ، وأجعله في حضني، ثم أبدأ بنزع ما قد علق به مع بعض الشَعر أحيانًا.
ربما الآن عرفتم أن صديقي الذي مات لم يكن من جنس البشر، ولا يشبه البشر في شيء، فلا شكله شكلهم، ولا طباعهم السيّئة طباعه، وخصالهم الرديئة خصاله.إنه هرّ. إنه «سَنْفور».
منذ سنة جئنا به صغيرًا ابنَ ثلاثة أسابيع لا أكثر. رماديّ اللون، ضئيل الجسم كان. رأسه أكثر استدارةً من رؤوس الهررة «البلديّة» البرّية، وشعره أطول. ولولا هذا الشَعر الطويل، لكانَ بحجم الخِرْنِق. ولقد ذكّرني يومذاك بقول جَحْظة، الشاعر:
إن كنتَ تُنكرُ ذِلّتي وتَذَلُّلي
ونحولَ جسمي وامتدادَ عذابي
فانظرْ إلى بدني الذي موّهْتُ
للناظرينَ بكَثرةِ الأثوابِ
هرّنا كان مموّهًا بكثرة الشَعر الطويل. غسلناه مرة؛ فامَّلَسَ شعره، وإذا به بحجم الكمشة.
?عندما جئنا به إلى البيت، أحببناه كلّنا لأنه جميل و... صغير. وكلّ صغير محبوب، ذلك أنّ الناس تحبّ البراءة التي في كلّ مخلوق صغير. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يفقد براءته متى كبر، لأن برعُم الشرّ الذي فيه يكبر معه ويغلب عليه. أما الحيوان فلا يضمر الشرّ لأن محدودية قدرته العقلية لا تسمح له بذلك. إذًا محنة الإنسان هي في عقله. وفي عقله أيضًا نعمته. فسبحان مَن خلق من الشيء الواحد نعمة ونقمة!
?ولأنه كان صغيرًا جدًّا، أطلقنا عليه اسم «سنفور» تحبُّبًا، ولم نكن ندري إن كان هذا الاسم سيبقى لائقًا به متى كبر. لكنه كبر وبقي سنفور في نظرنا صغيرًا، تمامًا كما يبقى الولد في نظر أبيه وأمّه ولو أصبح رجُلًا. وقد اعتاد هرّنا، صديقي، اسمَه؛ فمَن ناداه به منّا، التفت إليه، وقفز إلى حضنه، وراح يغطّ غطيط المُستأنِس المطمئنّ.
* * *
أصدقائي الحقيقيون ما كانوا يومًا كُثُرًا. كانوا يُعَدّون على أصابع اليد الواحدة. وغالبًا ما كان الزمن يطول قبل أن أكلّم أحدًا منهم أو يتّصل بي منهم أحد. ثمّة صديق وحيد كنت أفتقده كلّ يوم. عند طلوع الصباح أفتح عينيّ عليه. وفي المساء أسهر معه صامتًا. أما هو فلا ينفكّ يسامرني ويحدّثني ويخبرني بكلّ ما أرغب في معرفته. إنه الكتاب. وكم مرّة نام في آخِر الليل على وسادتي!
أما وقد جئنا بالهرّ الصغير، فأصبح لي صديق ثان. وإن كان الأوّل لا يتنقّل إلا من منضدتي إلى رفوف مكتبتي، أو من هذه إلى تلك، فإن «سنفور» كان في الصباح الباكر يتسلّل إلى سريري ويموء مواءً خافتًا. إنه يلقي عليّ تحية الصباح. تحية لا تشبه تلك التي يلقيها أكثر البشر، لأنها خالية من كلّ غشّ ومحاباة. فإن رفعتُ الغطاء فوق رأسي، دسّ رأسه تحت الغطاء معي. يريدني أن أنهض. حسنًا يا سنفور. لقد نهضت. تعال. حينئذٍ يرتمي في حضني. يمرّغ رأسه على يديّ؛ فألاعبه، وأمسّد ظهره. أجل يا صغيري، أنا أحبّك مثلما تحبّني.
إذا خرجتُ إلى فِناء البيت وجلست أقرأ أو أحتسي فنجان قهوة، خرج إليّ يحتفّ بقدميّ ويتقلّب على الأرض أمامي. وإذا نزلتُ إلى الحديقة لأتفقّد أشجارها، رافقني وراح يقفز كالأرنب مستعرضًا مهاراته، أو يطارد الفراشات، ويراقب العصافير تطير من غصن إلى آخر. حتى إذا ما رآني عائدًا، سبقني ووصل إلى البيت قبلي.
أكثر من مرّة خرج سنفور إذ رآني خارجًا. ثم ابتعد متجاوزًا الطريق إلى بقعة من الأرض يكسوها الشوك والحشائش. وهناك فاجأه هرّ أسود أقوى منه وأضخم؛ ففرّ سنفور من وجهه، وعاد كالسهم إليّ يلوذ بي. إلى أن كانت مرّة تمكنّ فيها غريمه منه، ففزع إليّ مستجيرًا وبعض الدم يخضّب شعره عند العنُق. ولمّا بقي الأسود واقفًا قبالتنا ينظر إلينا نظرة ظفر، تملّكني غضب شديد؛ فدخلت وتناولت بندقية الصيد وخرجت إليه، وصوّبتُ نحوه طويلًا قبل أن أرفع إصبعي عن الزناد وأُنزل البندقية عن كتفي. هذا الحيوان ما ذنْبه! إنه يسلك سلوكًا غريزيًّا، فكيف أقتله!! هو يدافع عن حماه ضدّ دخيل غريب. أليس يدافع الإنسان عن حماه فنمتدحه، ويذود الجنديّ عن وطنه فنمجّده ونفخر به!!
لم أقتل الهرّ الأسود فهو لم يقتل هرّي. وهذا شأن كلّ حيوان وطير وزاحف مع بني جنسه. عراك من أجل البقاء، بل من أجل الحفاظ على نقاء العِرْق، ولا نهاية بموت إلا في ما ندر. الأسد لا يقتل أسدًا، ولا الصقر صقرًا، ولا الأفعوان أفعوانًا. أما الإنسان فألْفُ آهٍ منه! إنه يقتل أخاه حسدًا، ويغسل يديه من دمه إنكارًا. هكذا فعل قايين بهابيل إذ قبل الله تقدمة أخيه ولم يقبل تقدمته لأن قلبه لم يكن نقيًا.
والإنسان يقتل الحيوان طمعًا بلحمه وفِرائه أو تسليةً وتباهيًا. وما رأيت ضاريًا افترس إنسانًا إلا إذا كان جائعًا أو خائفًا. حتى الوحش إذا أطعمته، تحوّل كلبًا مطيعًا يلحس قدميك. وهذا الوحش متى أكل وشبع، ترك بقايا فريسته لتأكلها الثعالب والنسور. أما الإنسان فيأكل فوق شبعه، ويكدّس أكثر ما يحتاجه في غده وحتى في كلّ حياته، ولا يتورّع عن سحب اللقمة من فم الأرملة واليتيم إذا استطاع.
سنفور صديقي لم يكن فيه من صفات الإنسان شيء. كم مرّة ذهبت إلى عملي ونسيته من دون طعام وماء؛ فصبر على الجوع والعطش إلى أن أعود! حتى إذا ما عدت وسمع وقع خطواتي خارجًا، هبّ يستقبلني قاطعًا عليّ دربي. وإذا ما فتحت له يديّ، قفز وتمدّد فوق ذراعيّ مطمئنًّا، وماءَ مُواءَ فرح لا شكوى وهو الجائع العطشان. أما صديقك الآدميّ فمتى كففتَ يد العطاء عنه، نسيك وأنكرك. هذا إن لم يخنك ويغدر بك.
* * *
ذات صباح خرجتُ إلى حديقتي لأرمّم حائطًا سقط بعض حجارته؛ فخرج صديقي سنفور في إثْري. وما عتّم أن قفز إلى حافة الجدار الفاصل بين أرضي وأرض جاري، وكان يعلو هذا الجدار حاجز من الشريط دقيق الثقوب. وإذ كان في الحاجز ثقب كبير واحد أحدثه تمزُّق الشريط، فقد مرّ سنفور عبره، وراح يستكشف «الأرض الجديدة»؛ فيما رحت أنا أعمل في ترميم الحائط لا يشغلني عنه شاغل. وما مرّ من الزمن زهاء نصف ساعة حتى سمعتُ خلف السياج الفاصل، وعلى قيد بضع خطوات من زاوية الجدار، أنينًا خافتًا؛ فدنوتُ لأرى ما يكون مصدره. ويا لَعظَمة المفاجأة وشدّة الصدمة!! إنه سنفور منطرحًا على جنبه يحتضر. رأسه على التراب، قوائمه ممدودة، عيناه ساهمتان، فمه مفتوح، ولا أثر للدم عليه. لقد كان يتنفّس بمشقّة. إنه يختنق بفعل سمّ سرى في شرايينه. لا بُدّ من أنّ أفعى لعينة لدغته في أنفه، فهو المكان الوحيد الذي تضرب الأفاعي الهررة فيه لأنه خالٍ من الوبر. لهذا السبب يخبئ الهرّ أنفه بقائمته أثناء صراعه الأفعى. أما سنفور فلم يحمِ أنفه لأنه ليس بريًّا ولا يعرف أنْ كان عليه أن يفعل.
لحظة تمكّنتِ الأفعى منه، حاول المسكين العودة من الثقب الواسع، لكنّ قواه الخائرة لم تُسعفه على القفز إلى حافة الجدار؛ فحاول من الجهة الواطئة، لكنّ الثقوب الدقيقة حالت دونه؛ فلبث هناك يئنّ علّني أسمع أنينه فأُنجده. ولكن كيف السبيل إلى ذلك! ناديتُ أهل بيتي أنِ اسرعوا إليّ، فسنفور يموت. ولما خرجوا كلّهم ملهوفين ورأوه يلفظ أنفاسه الأخيرة، بكوا جميعًا. أما أنا فكان قلبي يبكي، ولم يزل.
أسرعتُ إلى الطابق السفليّ، وعدتُ بالكمّاشة أُعملها في السياج الحديديّ قصًّا وتقطيعًا. ولما تمكّنتُ من مدّ يدي إليه ولمسه، أغمض سنفور عينيه لشعوره بالأمان وإحساسه بأني سأنقذه. لكنني خذلته لأن السمّ كان زُعافًا.
سحبتُه من خلف السياج وحملته على يديّ. كان جسمه ما زال دافئًا وفيه رمق من حياة بعد. فتح عينيه نصف فتحة ليودّعني، ثم أغمضهما مستسلمًا. حينئذٍ جلستُ حيث أنا، وضممته إلى صدري: «لا تمُتْ يا سنفور. ما زلتَ بعدُ صغيرًا على الموت يا صديقي». لكنه مات، وبقي جميلًا مثلما كان وهو حيّ. شيئًا فشيئًا برد جسمه؛ فنهضت وحملته إلى الحديقة التي كان يحبّها ويرافقني كلّ صباح إليها. وهناك حفرتُ حفرة وضعتُه فيها وهِلْتُ التراب ببطء فوقه. وها أنا أعترف لكم يا قرّائي الأعزّاء أن قواي في تلك اللحظة خانتني، وسقطت من عينيّ دمعتان بلّلتا التراب الذي احتضن صديقي.
بكيته لأنني ذات يوم ضربتُه؛ فابتعد وربض في الزاوية مستغربًا تصرّفي. ضربته لأنه خمشني بمخلبه إذ كنت أداعبه وهو يلعب. خمشني ولم يعرف أنه أذاني. ولما ناديته بعد قليل نادمًا على تصرّفي، اقترب مني يحتفّ بقدميّ ناسيًا أنني ضربته. فيا ليتني يومذاك لم أفعل.
ويا ليتني يوم مات، دفنته في مكان بعيد لا في حديقتي التي ما نزلتُ إليها مرّة إلا اتّجهت عيناي غصبًا عني إلى الموضع الذي واريته فيه؛ فأذكره وأذكر كلّ ما كان لي معه من سلوى وصحبة جميلة.
إنه لعلى خطأ كبير مَن يعتقد أن الصداقة لا تكون إلا بين إنسان وإنسان؛ فرُبّ حيوان كان لك أخلص وأوفى من كثيرين يدّعون الوفاء والإخلاص، وفي أوّل تجربة يسقطون. ألا رحم الله الأُحَيْمِرَ السَعْدِيَّ الشاعر إذ قال:
عوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عوى وصوّتَ إنسانٌ فكدْتُ أطيرُ.